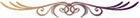

قراءة في كتاب: تجديد الفكر الإسلامي للدكتور محسن عبد الحميد
كتاب (تجديد الفكر الإسلامي) للدكتور محسن عبد الحميد [1]، المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
تكمن أهمية هذا الكتاب ليس فقط في أن مؤلفه من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال، بل أيضاً: في أنه من أكبر شخصيات الحركة الإسلامية في العراق[2]. فالكتاب يمكننا من الاطلاع على آراء ونظريات تتبناها تلك الجماعة، وتنشرها بشتى الوسائل، ولا يَنْقُضُ هذا ما يمكن أن يقال: من أن المؤلف يعبر عن وجهة نظره. ذلك لأنه قد صاغ آرائه في هذا البحث انطلاقاً من مبادئ تلك الجماعة، وانتهى في بحثه إلى تقرير تلك المبادئ، فالعلاقة بين مقاصد بحثه، ومنهج جماعته، هي مثل العلاقة بين الشيء وذاته!
فما هي الخلاصة الموجزة لهذا الكتاب؟
هناك ثلاثة مناهج في تحليل وتفسير علاقة الفرق والمذاهب الإسلامية بالاسلام الصحيح الذي اختاره الله لعباده:
الأول: المنهج الماركسي: وهو لايفصل في نظرته إلى الإسلام بين ما هو وحي إلهيّ من كتابٍ وسنةٍ، وبين ما هو اجتهاد ورأي بشري كأطروحات الفرق الإسلامية، بل يعتبرها كلها شيئاً واحداً، ويفسّرها تفسيراً واحداً، على أساس أنها ظاهرة اجتماعية، خاضعة لحتميات ومتغيرّات التاريخ. فهو تفسير ملحد، يفسِّر الدين على أساس أنه تراث قومي، ونتاج بشري. وقد رفض المؤلف (ص 26 – 31) هذا المنهج رفضاً تاماً، ولا شك أنه أصاب في ذلك.
الثاني: منهج المؤلف – وهو منهج طائفة المفكرين الإسلاميين – وخلاصته: التفريق بين ما هو وحي إلهيّ، وبين ما هو اجتهاد بشري. فيعتبرون جميع الفرق والمذاهب الإسلامية جهوداً بشرية، خاضعة للمؤثرات التاريخية والحضارية، لكنها تستند إجمالاً على مصدر واحد، وهو: قطعيات وكلّيات الوحي الإلهي المحفوظ.
الثالث: منهج أهل السنة والجماعة، من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم من أئمة العلم والسنة، وخلاصته: أن الوحي الإلهي المتمثل في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية محفوظ، ولكنه ليس في حالة مثالية مجرّدة عن واقع المسلمين، بل إن له عقائد واضحة، وأصولاً كلية، وأحكاماً تفصيلية، تُمثِّلُ الفرقة الناجية، والطائفة الظاهرة المنصورة الترجمة الحقيقية لها في واقع الحياة، ومسيرة التاريخ [3]. أما الفرق الأخرى: فبقدر ابتعادها عن مفاهيم وأصول هذه الفرقة الناجية تكون أراؤها بشرية، ليمكن تفسيرها على أساس الجدلية التاريخية.
والآن ما هو الفرق بين المنهجين الأخيرين؟
الواقع أن الفرق بينهما هو مثل الفرق بين الهدى والضلال، وبين الحق والباطل، فإن حقيقة منهج المفكرين عزل الكتاب والسنة عن واقع حياة المسلمين، ثم فتح الباب على مصراعيه لكل من هبَّ ودبَّ من أصحاب الآراء والبدع المغلَّظة المنكرة، ما دامت تستند في مجملها إلى الوحي الإلهي، وكلِّيات هذا الدين، ومذهبيته، التي لخصها المؤلف في فقرات مجملة (ص 146)، تكلم فيها عن (مادية الكون، وعن الله، والنبوة، وختم النبوة، واليوم الآخر). وعلى هذا الأساس فإن كلَّ الفرق الإسلامية التي لا تَنْقضُ هذه الأصول الكلية نقضاً مباشراً تعتبر مقبولة ـ إجمالاً ـ. وتُمدح بأنها خدمتِ الإسلام، في مرحلةٍ تاريخيةٍ معينةٍ ـ على الأقل ـ.
ومن هنا فإن المؤلف لا يندّد إلا بالحركات الهدامة التي تعرّضتْ لنقض هذه الأصول كلها ـ أو بعضها ـ، مثل حركة الزَّنج، والخُرَّمية، والقرمطية، والإسماعيلية الباطنية. وتجاهل المؤلفُ أن هذه الفرق لم تكن إسلامية أصلاً، بل كانت معظمها حركاتِ تمردٍ فارسية وشعوبيَّة وباطنية على الدولة العربية الإسلامية.
ومن هنا أيضاً: نجد المؤلف يبالغ في الثناء على أئمة الضلال الكبار، الذين قادوا أكبر الحركات التحريفية في تاريخ الإسلام، منهم: معبد بن خالد الجهني، الذي أحدث القول بالقدر بالبصرة، وتبرأ منه عبد الله بن عمر رضي الله عنه [4]، لكن المؤلف يصفه (ص 54) بـ (التابعي الجليل، والمحدّث الصدوق تلميذ الصحابي المجاهد أبي ذرٍّ الغفاري رضي الله عنه). ويمجِّدُ (ص 55) الجعد بن درهم، والجهم بن صفوان. ثم يذكر (ص 57) المعتزلة فيرفع من قدرهم. ويزعم (ص 60) أن الأشعرية قد ملأت فراغاً كبيراً.
ثم يأتي المؤلف على ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ص 65)، فيقول: (لا أبالغ إذا ادَّعيتُ أن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان أمة وحده، من بين سائر المفكرين الإسلاميين …).
ولا شك أن هذا سيثير تعجُّب واستغراب القارئ الكريم، فكيف يمتدح هذا الرجل شيخَ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع أنه قد امتدح في السياق نفسه من تقدَّم ذكرهم من أئمة الضلال الذين قضى شيخ الإسلام رحمه الله حياته في نقد ونقض فكرهم، ومحاربة آثاره الخبيثة في العالم الإسلامي؟
لكن لا داعي للتعجب والاستغراب، فالمؤلف يبني كلامه على الأصل الذي تقدم ذكره، وفي ضوءه: فإن جهم بن صفوان وابن تيمية ـ كلاهما ـ مناضلان إسلاميَّان، لا فرق بينهما البتَّة، إذ الكلُّ يعمل في إطار خدمة الحضارة الإسلامية، نعم: يمكن أن يكون أحدهما أقرب إلى الكتاب والسنة، ولكن كلاهما يستندان إليهما، والسبب الأساس في اختلافهما هو الظرف التاريخي، وتحدّيات عصرهما والمشاكل التي تعرّضوا لها! والحقيقة أن هذا المنهج هو صورة طبق الأصل عن النظرية الماركسية في تفسير التاريخ، ولكن الفرق: أن المفكرين الإسلاميين يؤمنون بالوحي الإلهي، والماركسيون لا يؤمنون به أصلاً.
ويطبق المؤلف المنهج نفسه في نظرته إلى ما يسمى بالفكر الإسلامي في العصر الحديث، فيبدأ أولاً بذكر دعوة الإمام المجدّد، شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهَّاب (1206 هـ) رحمه الله تعالى، ويثني عليها ثناءً كبيراً، لكنه يستخف بها بطريقة مبطَّنة، زاعماً (ص 99) (أن ظروف حياة البداوة في الجزيرة العربية[5]، وعدم احتكاك الشيخ محمد بن عبدالوهَّاب بمراكز الثقافة الإسلامية في العراق، والشام، ومصر، وعاصمة الخلافة (استنبول) يومئذٍ، وانحصار ثقافته بالجانب النقلي وحده من الثقافة الإسلامية[6]، وتأخُّر وصول أخبار التغير الذي كان يهز الحياة هزاً عنيفاً في أوروبا إلى العالم الإسلامي، جعلت من حركته ذات بعدٍ واحدٍ هو البعد العقدي، …).
هكذا قال، وتجاهل كثيراً من الحقائق التاريخية، لعل أبرزها الأثر العظيم لدعوته المباركة على العالم الإسلامي كله (وقد اضطر أن يعترف بشيء من هذا، ص 127)، وأيضاً: أن دعوته البدوية ـ كما يزعم ـ قد أثمرت قيام أول دولة إسلامية في العصر الحديث، قائمة على العقيدة الصحيحة والتوحيد، والحكم بشرع الله تعالى. مما كان له الأثر العظيم في الإصلاح والدعوة والتغيير على مستوى الأمة بل العالم كله؛ حتى يوم الناس هذا.
ومهما يكن فإن حركة الشيخ رحمه الله عند المؤلف (ص 100): (من الحركات المرحلية التي كانت تستجيب لتحديات معينة تتصل بمجمل العقيدة فحسب). فالأمر كله من افرازات حركة التاريخ فحسب!
ثم يأتي المؤلف لذكر التجديد الشامل في العصر الحديث، فيزعم أن المدعو: جمال الدين الأفغاني، هو (ص 102): (أبرز من ظهر على مسرح الكفاح والنضال عن الأمة، والجهاد في سبيل تجديد أمر الإسلام والمسلمين كله).
والمؤلف شديد الإعجاب بشخصية الأفغاني، حتى أنه أفردها بكتاب سماه: “جمال الدين الأفغاني، المصلح المفترى عليه”. تجاهل فيه كل انحرافات الأفغاني، بل وانتماءاته المشبوهة، وقدَّمه على أنه الأب الروحي للدعوة الإسلامية في هذا العصر، وفي كتابه هذا يلّخص ما كتبه هناك، زاعماً أن كل دعوة إصلاحية ظهرتْ في العالم الإسلامي من بعدُ، كانت ثمرة من ثمرات مدرسة الأفغاني، أو على الأقل متأثرة به.
ثم يأتي على ذكر حسن البنا (1949م) ودعوته، فيصفه بأنه (ص 114): انطلق من الدراسة الشاملة للمنهج الأصولي الإسلامي، لا سيما في مدرسة جمال الدين، ومحمد عبده، ومحمد رشيد رضا، لكي يرسم للجيل الجديد بدقة ووضوح المذهبية الإسلامية بتفاصيلها الشاملة التي تستوعب نواحي الحياة كلها … إلخ كلامه العاطفي الفضفاض. وهو شهادة مهمة جدًّا إلى جانب كثير من الدلائل والشواهد التي تثبت أن حسن البنا لم يأت بجديد، بل هو على خطا محمد صفدر الإيراني الذي لقب نفسه بجمال الدين الأفغاني، وأسس المنهج الفكري المعاصر في تفسير الإسلام تفسيرًا عقليًّا مدنيًّا نفعيًّا، وكل ما عمله البنا هو أن حول دعوة صفدر من الإطار النخبوي إلى حركة شعبية عامة، فصار شرُّ الإيراني المتأفغن عامًّا في الأمة بعد أن كان خاصًّا بفئة قليلة من المثقفين الذين تأثروا به.
ومهما يكن فقد أطلق المؤلف في كتابه هذا أحكاماً عامة، وذكر أمور مجملة، وادعى أموراً مجرّدة عن الحجة والبرهان، مع مغالطات ظاهرة بينة، خاصة في تناوله لمصطلح (السلفية)، وليس بالإمكان هنا التطرق لتفاصيلها، خاصة وأنني في مجال العرض لا النقد المفصَّل، لكن لا شكَّ أن القارئ سيتساءل هنا: ما هو الهدف والغرض من هذا كله؟
الجواب: أن طائفة المفكرين يريدون تحويل صراع هذا الدين مع الملل والنحل والفرق من صراع عقائدي، يراد منه الوصول إلى مراد الله تعالى من العباد، إلى صراع حضاري مادي، إذ أن الانشغال بقضايا التوحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وغير ذلك من أصول الإسلام، وأحكامه التفصيلية، سيشغل المسلمين عن دورهم في هذا العصر المادي، فالواجب عليهم أن يختزلوا الجانب العقدي في دينهم إلى أضيق حدٍ ممكن، مع الإيمان بقضاياه كلها، ولكن عملياً: لا يبقون إلا على الأصول الضرورية جداً، على شرط أن تكون مجملة أيضاً، وهي (الله، الوحي، النبوة، اليوم الآخر). وهكذا يتفرّغ الجميع، من جهمية وقدرية وجبرية ومعتزلة ورافضة وأشاعرة وماتريدية وصوفية (وسلفية!!)، لإعمار الأرض، ولبناء الحضارة المادية التي بها يمكنهم مواجهة تحدّيات الغرب ومدنيته!؟.
ولعل القارئ الكريم أدرك بذكائه أن نظرية المفكرين هذه، هي نتيجة (عقدة النقص) التي يعانون منها، جرّاء انبهارهم واعجابهم بالغرب وبهرج حضارته الزائفة، نسأل الله تعالى السلامة من الشبهات والشهوات، بمنِّه وكرمه.
(نشر هذا المقال (قراءة في تجديد الفكر الإسلامي) في مجلة (الهدي النبوي) التي كانت تصدر في مانشستر – بريطانيا، السنة الثانية، العدد (14)، صفر 1418هـ / تموز 1997هـ).
[1]ولد في كركوك / العراق سنة 1937م، وحصل على الدكتوراة سنة 1972م من جامعة القاهرة، أستاذ مادة التفسير والعقيدة والفكر الإسلامي الحديث في جامعة بغداد. معروف باتجاهه العقلاني العصراني، وله مؤلفات في هذا المجال. وهو كرديٌّ لكنه استقرَّ في بغداد وتزوج منها.
[2]فهو أحد قيادات الإخوان المسلمين في العراق، وكان له دور بارز في عهد البعثيين ثم في عهد بريمر، من خلال الحزب العراقي الإسلامي.
[3]وهذا لا يعني أن الفرقة الناجية معصومة في ذاتها، وفي اجتهاداتها، بل المقصود: أنها الامتداد الطبيعي للدين الذي علَّمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، عقيدةً وشريعةً وأخلاقاً، أصولاً وفروعاً، وإن كان يطرأ عليهم ما يطرأ على البشر في التفاصيل الصغيرة، والمسائل الجزئية، وما للاجتهاد فيه دخل.. وآلاف النصوص من الكتاب والسنة وآثار السلف، وأقوال الأئمة والعلماء، هي أدلة وبراهين على هذه الخلاصة التي ذكرتها أعلاه.
[4]كما في: صحيح مسلم.
[5]هذه طريقة أصحاب المدرسة العقلانية العصرانية في النبز والطعن في دعاة السلفية، يصفونهم بالبداوة، ويسمّون الفقه المبني على أدلة السنة بالفقه البدوي، ويتجاهلون أن (الحضارة الإسلامية) ـ كما يسمونها هم ـ لم يبنها إلا الصحابة الذين خرجوا من الجزيرة العربية!
[6]الوحي الإلهي لا يحقق ثقافة إسلامية متكاملة ـ عند المفكرين ـ إلا إذا أضيفت إليها إفرازات العقل الإنساني المنحرفة.