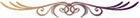
أسلمة الحرية اللبرالية عند راشد الغنوشي
كتب راشد الغنوشي ـ زعيم حزب النهضة النونسي ـ مقالًا بعنوان «الحرية في الإسلام» (نُشر على موقع قناة الجزيرة بتاريخ 11 / 10 / 2007) مداره على تحريف مفهوم الحرية في الإسلام واستيراد المفهوم الليبرالي بدلًا عنه، ومحاولة تطويع النصوص وكلام بعض العلماء لتوافق هذا المفهوم المنحرف الذي يجعل من مبدأ حرية الاختيار الذي جبل الله عليه الناس هدفًا وغايةً يسعى الإسلام لتحقيقها وترسيخها، بل وجعل كل العبادات في الشريعة جاءت لتحقيق هذا الهدف المنشود.
ليس المقصود بالحرية ـ في المفهوم الليبرالي ـ حرية الاختيار من القصد والإرادة، وما يتبع ذلك من علم وعمل، ويترتب عليه الثواب والعقاب، وإنما المقصود الحرية بالمفهوم العام، أي حرية القول والفعل والترك مطلقًا. وهذا الإطلاق يتعارض مع مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجميع تفاصيله وتشعباته بلا شكٍّ، ولأن المجتمع لا بد له من نظام يحكمه، والحرية المطلقة تعارض النظام العام الذي لا بد منه؛ قيَّد اللبراليون مبدأ الحرية التي ينادون بها بما لا يعود على الغير بالضرر والإكراه الحسي المادي البحت، غير ملتفتين لما تحدثه هذه الحرية من هدم القيم والأخلاق، ونشر الكفر والإلحاد، وذلك منهم يتوافق مع مشربهم من جعل الدين إنما يراد من أجل ملء الفراغ الروحي والنفسي وحسب، وأما أن يكون الدين والعبادة هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها، وأن يؤمر جميع الناس بالانطواء تحته، ويكون من رجاله من يمنع تسلل المنحرفين وأفكارهم على أهله باليد واللسان والقلب؛ فهذا عندهم من الاستبداد والاستعباد المرفوض تمامًا.
ولما جاء الإسلامين وهالهم ما يورده عليهم اللبراليون من شبه حول الحرية، وكان اعتقادهم في الغاية من خلق الإنسان وبعثة الرسل منحرفًا ـ حتى جعلوا العبادات وسائل لا غايات ـ، وتشربوا مفهوم الحرية بالمعنى المادي؛ ذهبوا إلى تحريف نصوص الإسلام أو تكذيب بعضها في نسبته للدين، وتطويع كلام من شاؤوا من العلماء لخدمة هذا المفهوم المنحرف، من غير أن يستشعروا خطورة هذا الأمر على الدين والتعبد، وعلى المجتمع المسلم الذي ينادون ـ فيما زعموا ـ بإصلاحه وتحصينه من الغزو الفكري، فكانوا من أكبر معاول هدم الدين وقيمه بالحرية المزعومة، كل ذلك جريًا وراء التقدم المادي الذي يزعمون أن سببه الحرية المفقودة في الإسلام بالمفهوم الصحيح الذي عليه أهل التدين بشريعة الله تعالى وحكمه.
وكان من زعماء هذه الدعوة راشد الغنوشي، وله في ذلك كتب ومقالات كثيرة، ومقاله ـ المشار إليه آنفًا ـ نموذج مهم من فكره ودعوة، لهذا رأينا أن نتعرض له بالعرض والنقد، وبالله تعالى التوفيق:
1- قال الغنوشي ـ بعدما ذكر مفهوم الحرية عند الفقهاء وأهل الكلام، وأنه لا يخرج عن مفهومين: الأول: الحرية المقابلة للرق والعبودية، والثاني: مسألة فعل العبد ومشيئة الرب والخلاف فيها بين المتكلمين ـ: «غير أننا إذا صرفنا النظر عن المماحكات الكلامية ودققنا النظر في طبيعة رسالة الإسلام ومقاصدها العليا سيرتفع هذا التناقض المصطنع». يقصد التناقض الذي اصطنعه اللبراليون بقولهم: إن الإسلام ضد الحرية. ثم قال: «فالإنسان وإن كان مستخلفًا وليس إلهًا، وهذا الاستخلاف يفترض آمرًا هو الله عز وجل ومأمورًا هو الإنسان، فإن هذا الاستخلاف مشروط بتوفر شرطين في المستخلف: العقل والحرية، وهما جوهر الأمانة التي تشرّف بها الإنسان، وتهيّبتها كل المخلوقات الأخرى. {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ..} الآية [الأحزاب: 72] ».
زعم الغنوشي أن الإنسان مستخلف عن الله في الأرض ليس على سبيل الألوهية، وإنما على سبيل ما أعطاه الله من حرية الاختيار والتمييز، فهو خليفة عن الله في تنفيذ أوامره بمحض حريته واختياره وتمييزه. وهو منازع في أصل هذه الدعوى، فإن تفسير الاستخلاف بهذا المعنى ليس تفسيرًا صحيحًا، بل الصحيح ما عليه أكثر المفسرين من أن معناه: «يخلف بعضهم بعضًا»، ولكن لأن مفهوم الاستخلاف عن الله يخدم مفهوم الحرية المنحرف عند كثير من الإسلاميين؛ تراهم يشغفون بهذا التفسير معرضين إعراضًا كاملًا عن التفسير الصحيح للاستخلاف، لأنه لا يخدم منهجهم.
2- قال: «الحرية والعقل مناط المسؤولية والتكليف، كما يقول الأصوليون، وذلك أثر لتكريم الله للإنسان، هذا التكريم يجعل للفعل الإنساني قصدًا قائمًا على الاختيار بين عبادة الله عن وعي وإرادة وبين التمرد».
إن في هذا الاستشهاد بما يقوله الأصوليون من أن شرط التكليف هو العقل والحرية تحريفًا لمرادهم وكذبًا عليهم، ولا شك أن الأصوليين يقررون أن من شرط التكليف: العقل، وأما الحرية فليس بصحيح إطلاق اشتراطها عندهم، وإنما يتكلم الأصوليون في شروط التكليف ويتعرضون لمسألة الإكراه، وفيها عندهم تفصيل، منه ما هو إكراه بحق لا يعارض التكليف، ومنه ما هو بغير حق لا تكليف معه إلى غير ذلك من التفاصيل، وأما الحرية بمعنى ألا يكون المكلف عبدًا مملوكًا فهذا خارج محل البحث.
ومن تناقضه أنه ذكر في بداية مقاله أن مبدأ الحرية بقي إلى قبل قرنين من الزمان محصورًا في مفهومين، الأول هو: الحرية المقابلة للرق والعبودية، والثاني: ما يتعلق بمبحث خلق أفعال العباد وعلاقة فعل العبد بمشيئة الرب؛ فما علاقة ما يذكره بكلام الأصوليين؟ وهم بلا شك من أهل القرون السالفة.
وجعل الغنوشيِّ حرية الاختيار شرطًا في التكليف مطلقًا مفهوم فاسد يقتضي أن من أُكرِه على الصلاة أو الزكاة مثلًا فالمكرَه ـ والحالة هذه ـ غير مكلف بالصلاة والزكاة، لأنه فاقد لحرية الاختيار، وهذا تناقض وفساد كبير لا يقره الأصوليون أنفسهم، كيف والإكراه عندهم منه ما هو إكراه بحق لا يخالف التكليف، ثم إن من أكره على العبادة أو الأوامر الشرعية أو أداء الحقوق لا يعدوا أن يكون هذا الإكراه على الظاهر فقط، ولا يمكن لأحد أن يتسلط على قلبه إلا الله، فهذا الذي أكره على الصلاة وصلاها كارهًا، فإنه لا زال حرًّا في اختياره للصلاة من خلال الإرادة القلبية التي جبل الله عليه الناس، وهو يحاسب على هذا الاختيار، وهذا ما غفل عنه من تشربت قلوبهم الحرية المادية.
3- قال: «قال تعالى مبيِّنًا لعباده طريق الرشد من الغي {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29] الآية. وقال معترضًا على نبيه الحزين على إعراض قومه {أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩} الآية. وهو ما يفقد الأعمال "الإسلامية" كالصلاة والزكاة والجهاد والتحجب ـ بالنسبة للمرأة ـ كل قيمة عند الله إن لم تكن صادرة عن إرادة واعية حرة مسؤولة تبتغي مرضاة الله. {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣)} الآية».
كلام الغنوشي ـ هذا ـ تحريف للآيات وإخراج لها عن سياقها، فالأولى جاءت في معرض التهديد والوعيد، بينما الآية الثانية جاءت في الإكراه القلبي الذي لا يملكه صلى الله عليه وسلم، وإلا للزم التناقض بين هذا وبين إقامة الحدود وتعزير المخالفين وحتى الجهاد في سبيل الله، وكل ما له علاقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما استشعر الإسلامين تناقضه بين مفهوم الحرية بالمعنى اللبرالي المادي، وبين ما جاءت به الشريعة، فبدل نصرة الشرع وبيانه معناه الصحيح تشربت قلوبهم المفهوم المنحرف للحرية، وأخذوا في نصوص الشرع تأويلًا وتحريفًا لتوافق أهوائهم.
أما قوله: «أن الإكراه على العبادات والأوامر الشرعية يفقد الأعمال قيمتها عند الله»؛ فلا شك أنها كذلك إذا فعلها العبد كارهًا لها، لكنه لم يتفطن للجانب الأهم، وهو أنه وإن كانت لا ثواب فيها لذلك الشخص المعيَّن، لكنها مقصودة للشريعة حفظًا للدين والمجتمع من تغلغل عوامل الانحراف وانتشار الفساق والفجار بل والملحدين بين المؤمنين والأتقياء، الأمر الذي راعته الشريعة الحكيمة في مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يعمل على تجفيف منابع الشر ما أمكن، وهو من أهم وسائل تحقيق العبودية في المجتمع المسلم، قال العلامة محمد الخضر حسين (ت: 1377) رحمه الله: «إن إطلاق التصرف للإنسان يعمل ما شاء، وتخلية سبيله يعتقد ما سنح له، وعدم ارتباطه في ذلك بالأوضاع الدينية، لمفسدة كبرى تعم الأفراد في أشخاصها والأمم في اجتماعها. واعتَبِرْ في ذلك بحال العرب في الجاهلية، حين كانوا أوزاعًا في مذاهبهم وأخيافًا في وجهاتهم، كل يعمل على نفاذ داعيته، لا رادع من الدين يرد شكيمتهم، ولا سبيل لسلطة غالبة على كبح جماحهم، يتبين لك أن الحرية المطلقة والهمجية المقلقة أَخَوَان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ثم حوَّل نظرك إلى زمن الرسالة، وعصر الخلفاء الراشدين، فلا تجد سببًا امتد بالإِسلام في أَطراف الأرض، فاستوثق لهم ملك متماسك العرى غير إجرائهم لتلك المبادئ التي أركزها الوحي في عقولهم.» [موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين 12/2/100]، ولذلك كانت مثل هذه الأحكام العامة الجماعية لا ينفذها إلى ولي الأمر الذي له سلطان وشوكة، ولا يجوز لآحاد الناس تطبيق ما يختصُّ به السلطان ونوابه من أحكام السياسة الشرعية، لأنها لن تحقق الغاية منها وستكون المفسدة الناتجة عنها أعظم.
وقال الغنوشي عازيًا للإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: «فكل أفعاله سبحانه حكمة وعدل ورحمة، وكل ما هو من هذا القبيل فهو من الإسلام وإن لم يرد فيه نص مخصوص، وكل ما يناقض ذلك فليس منه في شيء (ابن القيم: الطرق الحكمية) إذ التوافق بين صحيح المنقول وصريح المعقول قاعدة الفكر الإسلامي (ابن تيمية)».
إن هذا الاقتباس ليس في شيءٍ من كتب الإمامين، لكنَّه بحسب ما فهمه مما يصب في سبيل أسلمة الحرية الليبرالية عنده، وهذا منه استغلالٌ لكلامهما رحمهما الله، وإيهامٌ للقارئ أنَّ الحريَّة بالمفهوم الليبرالي الحركي هي من العقل الصريح الموافق للحكمة والعدل والذي لأجله تردَّ وتأوَّل النصوص ليحصل التوافق بين العقل والنقل ـ زعموا! ـ وهذا على عكس ما يدعو إليه الإمامان، في كل كتبهم من تعظيم الأوامر الشرعيَّة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن المنحرفين استغلَّوا كلامهم في كشف زيغ من يدعي تعارض الشريعة مع العقل والحكمة، وبيان موافقتها للعقل والحكمة وأنَّها لا تأمر إلَّا بما فيه خير ومصلحة خالصة أو غالبة، ولا تنهى إلَّا عن مفسدة خالصة أو غالبة، وأنه لا يوجد في العقل الصريح ما يخالف النص الصحيح، فقام الحركيون كأمثال الغنوشي بقلب المسألة وجعل الحكمة والعدل المتوهَّمة بعقولهم معيارًا على الشريعة أخذًا وردًا وتأويلًا. واقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله تجده وكأنه يخاطب الغنوشي وأمثاله فيقول: «وكم من شيء يعتقد كثيرٌ من الناس أنَّه حكمةٌ ومصلحةٌ يجب تحصيلُها، أو أنَّه سفَهٌ ومفسدةٌ يجب دفعُها، وليس كذلك في نظر الشارع، لأنَّ حقائقَ ما يَنفع الناسَ وما يَضُرُّهم في أمر المعاد ـ بل في أمر الدنيا أيضًا ـ لا تُعلَم إلا بالوحي المنزل من عند الله»، [تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل (1/ 116)].
ثم ينتقل الغنوشي إلى ابن رشد الحفيد ليحتفي به قائلًا: «ولم يخطئ الفيلسوف الفقيه ابن رشد الذي علَّم الغرب التراث الإغريقي حين عنون إحدى رسائله بـ "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال" مؤكِّدًا أنَّ العلم بالكون هو السبيل للعلم بخالقه "ازدياد العلم بالصنعة يزيد علمًا بالصانع".
ولا عجب أن يحتفي مثل الغنوشي بابن رشد الحفيد؛ فهو من كبار الفلاسفة الذين يعتقدون بأنَّ الدِّين إنَّما جاء لضبط المصالح الدنيوية، وأنَّ الشريعة تخالف الحقيقة، ولم تأتِ إلَّا لسياسة الجمهور، وأما الاعتقاد الصحيح فليس في الشريعة بيانه ولا دلَّت عليه، لأنَّ عقول العامَّة ـ أي أكثر الناس ـ لا تحتمله، لهذا أراد ابن رشد تقريب كلام الفلاسفة ممن لم يهتد بهدي الأنبياء من الشريعة، ليثبت أنها ما جاءت إلَّا لأجل معاني الإصلاح والقيم العليا التي نادى بها الفلاسفة قديمًا، وأمَّا أمر الآخرة والمعاد فهم وهو عنها بمعزل، وبسبب أصله المنحرف قدَّم أهل الفلسفة والمنطق اليوناني على أهل الشريعة والديِّن، لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ثم يقال له: يا سبحان الله من الذي جعل هذه الطائفة من اليونان وأتباعهم هم العلماء دون سائر الأمم وأتباع الأنبياء الذين لا يختلف من له عقل ودين أنَّهم أعلمُ منهم وأيّ برهان عندهم يتبيَّن به هذه الحقيقة... ومن الذي خصَّ هؤلاء بكونهم أهل البرهان مع أنَّ غاية ما يقولونه في العلم الإلهي لا يصلح أن يكون من الأقيسة الخطابيَّة والجدلية فضلًا عن البرهانيَّة،... والقوم لم يتميَّزوا بالعلم الإلهي ولا نبل أحد باتباعهم فيه بل الأمم متَّفقة على ضلالهم فيه إلَّا من قلَّدهم ولكن يُؤثر عنهم من الكلام في الأمور الطبيعيَّة والرياضية ما شاع ذكرهم بسببه ولولا ذلك لما كان لهم ذكر عند الأمم، كيف يستجيز مسلم أن يقول: إنَّ العلماء الذين أثنى الله عليهم في كتابه هم أهل المنطق مع علمه بأنَّ أئمة الصحابة والتابعين وتابعيهم كانوا مرادِين من هذا الخطاب قطعًا بل هم أفضل من أريد به بعد الأنبياء، وقد ماتوا قبل أن تعرَّب كتب اليونان بالكلية... ثم العلماء الذين أثنى الله عليهم هم الذين شهدوا أنه لا إله إلا هو، ومن المعلوم لكل من عرف أحوال الأمم أن أهل الملل أحقُّ بهذا التوحيد من الصابئة الذين هم أهل دِمَن الفلاسفة ومن المشركين الذين فيهم فلاسفة كثيرون... وإن ادعى مدع تقدُّمه في الفلسفة عليهم فلا يمكنه أن يدَّعي تقدَّمه في معرفة ما أريد به القرآن عليهم، وهم الذين تعلموا من الرسول لفظه ومعناه، وهم الذين أدوا ذلك إلى من بعدهم... فكيف يكون هؤلاء هم أهل العلم بشهادة أن لا إله إلا الله بل إذا قيل: إن هؤلاء وأمثالهم أصل كل شرك، وأنهم سوس الملل، وأعداء الرسل؛ لكان هذا الكلام أقرب إلى الحقّ من شهادته لهم بما ذكره»، [بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: 2/ 60 - 67].
ثم قال الغنوشي: «ومع أهمية "القدر" فإن حصر مبحث الحريَّة في تراث الإسلام في هذين السياقين المذكورين ليس صحيحًا، إذ الحريَّة كالشورى لا تستمدّ من مجرد نصٍّ جزئي، باعتبارها مقصدًا كليًّا من مقاصد الشريعة الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال، وأضاف إليها الأصولي الفقيه الكبير ابن عاشور مقصد الحريَّة والعدل (كتاب مقاصد الشريعة)، بما يوجب أن تكون الأمَّة حرَّة، ليس بشكلٍ جزئي ولكن في كل جوانب حياتها، إذ تسقط كلُّ تكاليف الشرع في غياب العقل والحريَّة والعلم. وفي الحديث: "إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان والإكراه"، أخرجه وصححه ابن حبان».
إن في كلام الغنوشي ـ هذا ـ مغالطات وادعاءات كثيرة، فقد أوهم القارئ أنَّ الشورى من شعائر الدِّين الكلية، مع أنها حكم جزئي، وغلوه هذا نابع من تعظيم أمر الإمامة وجعلها أصل الأصول، وهذا الغلو غالب على أمثاله من الإسلاميين الحركيين، وأصل ذلك كله من الروافض، ولا نريد الخوض في هذا فله موضعه، لكن المراد بيان أنَّ هذا الذي ادعاه في الشورى وأومأ إليه غير مسلَّم فالشورى لا تعدو أن تكون من جزئيات الدِّين وأحكامه التفصيلية لا أكثر.
وأما مسألة الحرية وادعاؤه أنَّها من المقاصد الكليَّة في الدِّين واستشهاده بابن عاشور، فهي كتلك، فأقلّ ما يقال فيها أنَّ لازمها تجهيل الأمَّة في اكتشاف هذا المقصد البيِّن الظاهر في زعمهم، فأحد ثلاثة أمورٍ لازمة، إمَّا ضلال الأمَّة في عدم اكتشاف هذا المقصد الخطير وهو بهذا الظهور والبيان، وإما غلو ابن عاشور وخطئه في عدِّ ما ليس من مقاصد الدين مقصدًا، وإما أنَّه ليس بمقصدٍ أصلًا ولا يصح إدراجه بله تقديمه على كل المقاصد التي اتفق عليها العلماء، وهو لا يعدو أن يكون مطلوبًا في حدود معينة راجعة في أصلها إلى نوعي الإكراه بحق وبغير حق، التي تكلَّم عنها العلماء ولم يهملوها.
ثم يقال: إنَّ الإجمال والتعمية في الكلام من أكبر أساليب الطعن والتحريف في الدين، ولم تكن حقيقة جعل الحرية من مقاصد الدين إلّا إبطال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإسقاط الحدود، وإلا فلا يوجد شيءٌ عملي أقرَّه الشرع وكان مرجعه إلى الحرية المزعومة حتى تجعلها مقصودًا للدين بخلاف كلِّ المقاصد الأخرى التي جاء الشرع بحفظها، وكما نوَّهنا سابقًا فإنَّ حرية الاختيار نابعة أصالة من القلب الذي لا يملك أحدٌ السيطرة عليه ولا إكراهه إلا خالقه.
انتقل الغنوشي بعد ما سبق من التمهيد والتوطيد إلى تقرير المطلوب الأهم الذي يدور حوله وفي فلكه غالب الإسلاميين الحركيين، ألا وهو جعل الإمامة والحاكمية هي المطلوب الأهم والركن الأعظم الذي يجب على جميع العاملين في مجال الدعوة جعله هدفًا لهم وغاية يسعون لأجلها ومن أجل ذلك خلق الله الخلق وأرسل الكتب؛ فقال: «الإسلام دعوة للحريَّة وللتحرير، ولم يخطئ القول أكبر المنظِّرين في الإسلام المعاصر أبو الأعلى المودودي وسيد قطب إذ عرَّفا الإسلام بأنه ثورة تحرريَّة شاملة، تنطلق من أعماق النفس والعقل والإرادة لتمتد إلى كل ركن من أركان الحياة الاجتماعية والاقتصادية».
هذا نص جلي يوضِّح لك نظرة هؤلاء القوم للإسلام والتديّن بشكل عام، فليس عندهم تعريف للإسلام إلَّا أنَّه «ثورة تحررية شاملة!»، فالخضوع والمحبة والتعظيم لله والعبادات وكل شعائر الدِّين إنَّما هي وسائل وتدريبات لإحداث هذه الثورة، وما شُرعت إلَّا لتحقيق «قيمٍ إنسانيَّة عالية» وهو عين ما دعا إليه الملاحدة من الفلاسفة كأمثال ابن سينا والفارابي، لكنَّ الفرْق أنَّ الفلاسفة لم يثبتوا المعاد والجزاء بينما الإسلاميون الحركيون أثبتوها وجعلوا «عمارة الأرض وتحقيق القيم إنسانيَّة» غاية بها يتحقق رضى الله ودخول الجنة، وليست العبادات عندهم غايةً لذاتها تقصد، وإن قصدت لما تحمله من معاني المحبة والخوف والرجاء فليست بمنزلة تحقيق الحريَّة والقيم الإنسانية فهذه هي المقاصد الأصليَّة وما عدها تَبَعٌ لها! ولا عجب، فالمودودي وسيد قطب من أكبر مراجع هذا التفسير المنحرف للدين الذي أظهره المودودي وسيد قطب. ولتكون الصورة أكثر وضوحًا استمع للغنوشي وهو يؤكِّد ما قلناه سابقًا فيقول: «كما أبرزوا ما تتضمَّنه تلك العبادات من قيمٍ إنسانيَّة كالأخوَّة والسماحة والعدل والنظام والحريَّة والتضامن. وكلُّ عبادات الإسلام تدريبات على التحقق بذلك، وهو ما يبرر مشهد أسرة متحلقة حول مائدة حافلة بالمطعومات الشهيَّة ولكنَّها تغالب ضغط الجوع في انتظار الإذن الإلهي بالإفطار، وكذا مشهد المؤمنين وهم ينتفضون من مهاجعهم في الفجر استجابة للنداء الإلهي للصلاة جماعة، ومشهد حجاج بيت الله الحرام وهم يجتمعون في صعيد يلبّون بصوت واحد، وقد تركوا وراءهم الأهل والوطن، وكذا مشهد المزكِّين وقد انتصروا على شهوة الكنز، فدفعوا زكاة أموالهم بسخاء وليس لهم من رقيب غير الله. وهي كلها مشاهد تحرر إنساني بامتياز وتضامن».
هذه هي حقيقة المفهوم المنحرف للدين في فكر الحركيين، فقد غلو في منافع الدين وآثاره الدنيوية المادية على حساب أصوله ومقاصده الدينية والأخروية الأصلية، فانطبق عليهم المثل القائل: «جاء ليبني قصرًا فهدم مصرًا»؛ إذ لا شك أن الإسلام فيه من أحكام الأخوَّة والسماحة والعدل الشيء الكثير، لكنَّ هؤلاء القوم ضاق نظرهم وغطَّت الغشاوة على قلوبهم فلم يشهدوا «مبرِّرًا» للعبادات والتعبد لأركان الإسلام الأصليَّة إلَّا ما رَسَخَ في قلوبهم من الفهم المنحرف للدِّين، وأنه كما قرَّر سابقًا «دعوة تحرّر وحريَّة وثورة شاملة» وأنَّ عمارة الأرض إصلاح المجتمع والقيم الإنسانيَّة غاية في ذاتها خُلق لأجلها الخلق، ولمَّا لم يجدوا ظهور هذه الآثار والفوائد العاجلة في المسلمين مع إقامتهم لشعائر الدين؛ ذهبوا يهولون في فوائد العبادات وثمارها ولم يكتفوا بذلك فجعلوها غايات والعبادات تدريبات لتحقيقها! ولا ندري حقيقةً كيف ينفكّون عن لازم هذا القول، فمن تحققت في حقه هذه القيم الإنسانية وشهد هذا التحرر المزعوم فما حاجته للتعبد والعبادة إذن؟! وبسبب هذا الانحراف الخطير طَرَدَ كثيرٌ من الطوائف المنحرفة هذا الأصل والتزموا لازمه فكان منهم من ادعى رفع التكليف لمن شهد الغاية وتحقق في حقه الهدف العاجل كما هو قول غلاة المتصوفة أو التكذيب بالمعاد والجزاء والحساب كما هو قول ملاحدة المتفلسفة.
ثم ينتقل الغنوشي إلى تناقضٍ عجيب، فبينما لا يرى قيمةً لمن يؤدي العبادات أو ينتهي عن المحرَّمات مكرهًا؛ نجده ينعى على من يحاول جعل شهر رمضان من شهر التنافس على الطاعات إلى التنافس على المحرمات والمباحات، فيقول: «وليس من قبيل المصادفات أن تتهيأ قوى الاحتلال تهيؤًا خاصًّا لمواجهة تصاعد المقاومة في شهر رمضان حيث تتكثَّف عبادات الإسلام: الصوم والصلاة والتلاوة والصدقات. حقًّا لم يخطئ من عرّف الإسلام بأنَّه منهاج تحرري شامل لو فعِّلت كل آليَّاته بمنأى عن كلِّ طرائق العلمنة والتفريغ الجارية على قدمٍ وساق لتحويل الصوم من موسمٍ للتنافس على الطاعات إلى التنافس على المستهلكات والمسلسلات والتفنن في استثارة الشهوات». إن هذا الكلام يلتقي مع ما سقناه سابقًا من نظرته إلى العبادات على أنّها تدريبات ولسيت غايات بذاتها، وهو هنا يجعلها في رمضان خاصة من قوة المقاومة لمواجهة تحديَّات الإغراء والإغواء التي يمارسها أعداء الدِّين في رمضان، وهذا ـ بغض النظر عن عدم صحته في جعله الطلب الأبرز من كثافة التعبد في رمضان ـ فإنه ـ إن صح ـ نتيجة طبيعة للحرية التي يدعو لها الغنوشي وأمثاله، فهؤلاء القوم لم يفهموا من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن وسائل الإنكار باليد واللسان والقوة والسلطان، إلا أنها قاضية على الحريَّة التي هي من أهم مقاصد الدين! ومن ثم يولولون على ما يقوم به أعداء الدِّين في تشويه الدِّين وبث الفجور فيه! ولا يعلمون أنَّهم هم من فتح هذا الباب من خلال أسلمة الحرية اللبرالية، فإن كان شياطين الجنِّ والنفس الأمارة بالسوء لا يقاومها إلا الوازع الديني الداخلي، فإن شياطين الإنس شُرِع لمقاومتهم مع الوازع الدين وازع السلطان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ بشروطه وضوابطه ومراتبه المعروفة في كتب الآداب الشرعية ـ، وهذا لو فقهوه من رحمة الله بعباده، وأن هذا الأصل الأصيل إنما هو رحمة وعطف وإعانة للمسلم على أعداءه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٧)}؛ فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه، وإن كان لا يريد إلا الخير، إذ هو في ذلك جاهل أحمق كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم، وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر، ويتركونه من الخير، رأفةً بهم، فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم» [مجموع الفتاوى: 15/290]. وليست الحرية اللبرالية في حقيقتها إلا إعانة لأعداء الإنسان على نفسه، وإن ألبسوها لباس الإسلام، والله المستعان.