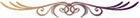
الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: فقد كثر الجدل هذه الأيام حول مسألة الترحم والاستغفار للكافر الميت، والناظر في كتابات من يُجيز هذا الأمر يجد أنهم أصناف متعددة، كلٌّ له دوافعه التي ينطلق منها لتسويغ هذا الفعل:
فصنفٌ كان دافعهم الجهل بحقيقة الحكم الشرعي، وهم أقل الأصناف وأضعفها وأقلها خطرًا، لأن النصوص من الكتاب والسنة وإجماع علماء الملة هي من الكثرة والقوة بحيث لا تدع مجال للجهل بها إلَّا مع الغفلة الشديدة والتقصير الأشد في تدبر كلام الله تعالى ورسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، فأول سورة في القرآن «الفاتحة» يقرأها المسلم في الصلوات المفروضة مرَّات عديدة ويقول في كل ركعة ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧) ﴾، ومعلومٌ أنَّ كلَّ من لم يكن من المؤمنين فهو من المغضوب عليهم والضالين، وأول من يدخل في هذا اليهود والنصارى، فإن كان الترحم والاستغفار لهم جائزًا نافعًا؛ فما فائدة وصفهم بالمغضوب عليهم والضالين إن كان حالهم كحال المسلمين، منهم من يدخل الجنة، ومنهم من يعذب، والجميع في رحمة الله ومشيئته يوم القيامة؟! هذا في أول سورة في القرآن وخذ ما عداها من الآيات والنصوص الكثيرة التي فيها أبينُ بيانٍ أن الكافر لا تشمله الرحمة ولا المغفرة في الآخرة: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٣)﴾ [العنكبوت].
الصنف الثاني: جماعة العلمانيين وأفراخهم من الليبراليين وممن يتزيَّا بزي الإسلام في الظاهر وهو إنما يخدم الفكر الليبرالي لأسلمته وتسويغه وترويجه بين المسلمين، فمسألة الترحم والاستغفار للكفار تدخل في صلب دعوته المميِّعة للأديان والداعية لوحدتها والخلط بينها، ولو على حساب إهدار الأصول والعقائد، فلا فرق عندهم مطلقًا بين مؤمن وكافر، بل لا يبيحون إطلاق الكفر على اليهود والنصارى الذين كفرهم الله بنصِّ كتابه، وهؤلاء لا كلام معهم فأمرهم مكشوف.
الصنف الثالث: وهم الدعاة الحركيون، أتباع الجماعات الإسلامية السياسية ومن تأثر بهم، وهؤلاء أكثرهم ضررًا، لأن مشكلتهم الحقيقة غير ظاهرة لكثير من الناس، فتجدهم يصوِّرن القضية بصورة الخلاف الفقهي والنظر والاستدلال، مع أنهم لا يجهلون النصوص القاطعة في ذلك ولكنهم يلوون أعناقها، ولذلك يتساءل البعض ما هو الدافع لهذه الحملة المستميتة منهم في سبيل تحريف النصوص عن دلالتها في هذه المسألة الخطيرة؟
ولذلك كان لا بد من كشف الدافع والأصل الذي ينطلق منه الحركيون لتسويغ الاستغفار والترحم على الكافر، مع علمهم بدلالة النصوص القاطعة والاجماع المنقول في تحريم هذا ومنعه.
فأقول: إن المشكلة تكمن عند هؤلاء القوم في فهمهم لحقيقة الدين ومقاصده، فالدين له أصول ومقاصد، وله فروع تابعة وخادمة لهذه الأصول، وأيُّ خلل يقع في ترتيب هذه الأصول والفروع، فإنه سيعود بالضرر على توجهات المسلم وتصرفاته ومقاصده من أعماله، وما مسألة الترحم والاستغفار للكافر إلا فرعٌ وثمرةٌ ناتجة عن خلل في تصور وفهم مقاصد الدين والغاية من الخلق.
ينطلق الحركيون في نظرتهم للدين والغاية من الخلق من نظرية التفسير السياسي والنفعي للدين، فالتفسير النفعي يُفسِّر الإسلام من خلال الآثار النَّفعية، والثمار المعنوية والمادية لما جاءت به الشريعة من العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. فهو يرى غاية الدين في المنفعة المترتبة على تطبيقه، ويرى العبادات المحضة الخالصة لله تعالى كالصلاة والصيام وسائل وأدوات لتحقيق تلك الغاية؛ لهذا يتمُّ التركيز على إبراز منافعها النفسية والصحية والاجتماعية، وجعلها محورًا لحكمة التشريع ومقاصده. بينما التفسير السياسي للإسلام يجعل العقائد والعبادات وجميع شرائع الإسلام وسائل وأسبابًا لإقامة النظام السياسي الذي يحقِّقُ العدل المادي والسعادة الدنيوية بين البشر. انظر: «مقدمة في تفسير الإسلام» 72 ـ 73.
لذلك فإن كلا التفسيرين قد أحدث خللًا في ترتيب أصول الدين وفروعه، ومعرفة غاياته من وسائله، فبدل أن يكون التوحيد والتعبد لله هو الغاية العليا والهدف الأسمى مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)﴾ [الذاريات]، أصبحت المنافع النفسية والاجتماعية والسياسية هي الهدف الذي يجب السعي لتحصيله، ومن ثم تصبح مسألة التوحيد والتعبد فرعًا خادمًا لهذا الأصل، ووسيلة من وسائله.
إن من يفهم الدين ويفسره بهذه الطريقة فلا يُستغرب منه بعد ذلك تجويزه للترحم والاستغفار للكفار، ممن قدموا خدمات مفيدة للمسلمين أو لقضاياهم وحقوقهم ـ فيما يظهر ـ، لأن التوحيد والتعبد الخالص لله تعالى الذي خُلق الخلق لأجله، لم يعد هو الأصل الذي يجب أن يقاس عليه عمل أي عاملٍ ـ عند هؤلاء ـ فما دام هذا الكافر عاش وكافح لأجل تحقيق العدل والدفاع عن المظلومين والوقوف بوجه الظالمين ونشر المساواة والأخلاق الحسنة؛ فيبقى ما عدا ذلك من الفروع التي تشملها المغفرة والرحمة.
فهذا إمام الطائفة الدكتور يوسف القرضاوي يكتب على حسابه الرسمي في (تويتر) بتاريخ: 22/10/2018، ما نصه:
«عقيدة التوحيد في حقيقتها ما هي إلا ثورة لتحقيق الحرية والمساواة والأخوة للبشر، حتى لا يتخذ بعض الناس بعضًا أربابًا من دون الله، وتبطل عبودية الإنسان للإنسان».
فإن كانت هذه حقيقة عقيدة التوحيد عنده، فلا يُستغرب بعد ذلك ترحمه على البابا بولس الثاني عام 2005.
ولذلك لا تجد عند هؤلاء حرصًا على دعوة غير المسلمين للإسلام، وما يظهرونه من اهتمام ببعضهم ما هو إلا لعبة حركيَّة لكسب الأصوات وتنفيذ المشروع الفكري بتحقيق الحكومة الإلهية بزعمهم، التي ليس من أصولها نشر التوحيد ومحاربة الشرك والبدع.
وقد بيَّن الأستاذ وحيد الدين خان (ت: 2020) رحمه الله ضرر هذا التفسير على غير المسلمين من حرمانهم من الدعوة وتحذيرهم من الخطر الذي سيقدمون عليه في الآخرة، لأن أصحاب هذا الفهم للدين ليس في برنامجهم ذلك؛ فقال ـ وهو يتكلم عن الجماعة الإسلامية الذي كان عضوًا من أعضائها ثم انفصل عنها ـ:
«وهذا هو حال غير المسلمين، الذين لم يعتنقوا الإسلام بعد، كان ينبغي أن تكون علاقتنا بهم علاقة الشهادة، وأن نحذرهم من خطر يوم القيامة الذي هم عنه غافلون، وأن نكون بمثابة «النذير العريان» من الخطر القادم الذي سيقع يوم القيامة. أما إذا كان الهدف هو: (السلطة) فلا نقلق من أجل إنقاذهم من يوم التلاق... فضاعت الحيثية الأصلية لغير المسلمين من منظور هذا التفسير، فلم يفكروا في إنقاذهم من النار، بل فكروا في استقطابهم لتدعيم أصواتهم مقابل الآخرين... فغير المسلمين بدل أن ننذرهم من يوم التلاق وتلك مسؤوليتنا، أصبحوا وفق هذا التفسير وسيلة لاستقطاب الجماهير، كأن واجبنا نحوهم هو أن نجعلهم متفقين معنا حتى يصلوا إلى صناديق الاقتراع، لأن هذا يكفي لصالح الانقلاب العادل في الحياة الاجتماعية». «خطأ في التفسير» 244.
لذلك إذا سمعتهم يتحدثون عن حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية، وأنهم يقرون على كفرهم ما دام أن أعمالهم منحصرة في أنفسهم فليس مقصدهم من ذلك «أنَّ الإسلام إذا حكم فإنَّه لن يُكره أحدًا على اعتناق الدِّين الإسلاميِّ، وإنما سيكتفي بإخضاعهم لنظامه السياسيِّ والاجتماعي ـ ولا شك أن هذا القدْرُ صحيحٌ ـ، ولكنَّ الحركيين يقصدون به معنًى آخر غير ما يفهمه عامَّةُ المسلمين، إنَّهم يقصدون أنَّ الحكم والسلطة هو الغاية العليا والمقصد الأهم للإسلام، ولازم ذلك أن لا تكون الهداية الفرديَّة للإنسان مقصودة ـ على الأقل بالقصد الأول ـ، فإذا تحقَّق الحكم والسلطان فلا ضير أن يبقى الكافرون على كُفرهم». «مقدمة في تفسير الإسلام» 230.
وهذا التفسير في حقيقته فهم معكوس منكوس إذ هو: «تحريف جذريٌّ لدعوة الرُّسل عليهم الصلاة والسلام ولدين الإسلام ومقاصده وغاياته، فالهدف الأساس والرئيس من الدعوة هو هداية «الفرد» ـ من حيثُ كونُه فردًا ـ حتَّى يكون من النَّاجين يوم القيامة، أما السلطةُ والحكومةُ والمالُ والقوَّةُ والقتالُ فمجرَّد وسائل للوصول إلى ذلك الهدف الأسمى، ولهذا لمَّا أرسلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه إلى قتال يهود خيبر، نبَّهه إلى أنَّ الغاية من القتال ليس الغلبة والقهر، وإنما الهدايةُ الفرديةُ، فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «انْفُذْ على رِسْلِكَ حتَّى تنزِلَ بساحَتِهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حقِّ الله فيه، فوالله لَأَنْ يهديَ الله بك رجلًا واحدًا خيرٌ لك من أَنْ يكونَ لك حُمرُ النَّعم». أخرجه البخاريُّ (3009) و(4210)، ومسلم (2406) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.
وهذه الحقيقة جليَّةٌ واضحةٌ في كتاب الله عزَّ وجلَّ، في دعوة الله تعالى لعباده، وفيما أخبر عن دعوة رسله عليهم الصلاة والسلام وأخبارهم مع أقوامهم، وفيما أمر به نبيَّنا الكريم صلَّى الله عليه وسلَّم، كلُّ ذلك يدلُّ دلالةً قاطعةً أنَّ الغاية من الدعوة والرسالة: هدايةُ «الفرد» إلى الدِّين الحقِّ في الدنيا بما يكون سببًا لنجاته في الآخرة، وهذه هي الحكمة في قبول «أهل الذمَّة» في الدولة المسلمة، ففي دخولهم في المجتمع الإسلامي، واختلاطهم بالمسلمين مظنَّة هدايتهم، من غير إكراهٍ. قال الله عزَّ وجلَّ: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (2)} [الجمعة]. وقال عزَّ من قائلٍ: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (19)} [المائدة]». «مقدمة في تفسير الإسلام» 230 – 231.
من هنا نعلم أن الحماسة التي أظهرها بعض الحركيين في إنكار الدعوة إلى «الإبراهيمية» هي حماسة كاذبة مغشوشة، حملهم عليها عداؤهم السياسي لدولة معيَّنة، ولو جُعِلوا طرفًا في مشروع «الإبراهيمية» لكانوا أسبق الناس إليها، وأسرعهم في تسويغها شرعًا، وإصدار الفتاوى في التشجيع عليها، كيف لا وهم يمارسونها عمليًّا من خلال إصدار الفتاوى والمقالات في تسويغ الترحم على نصرانية قُتلتْ ظلمًا. ولو كان لتلك المرأة النصرانية موقف سياسيٌّ مخالفٌ لهم؛ للَعَنُوها أبدَ الدهر، وأظهروا كلَّ النصوص التي تحرِّم الترحم والاستغفار لموتى الكفَّار.
فلا عجب إذن من صنيع د. علي القره داغي ـ الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء تنظيم الإخوان المسلمين ـ الذي أصدر فتوى بجواز إطلاق لقب (الشهيد) على بعض موتى الكفار، وجواز الترحم عليهم، وهو الذي اشتهر بقُبُلاته الحارة ـ لمصالح سياسية ـ على رأس العلماني الماركسي اللاديني جلال طالباني.
ولا عجب ـ أيضًا ـ من صنيع الشيخ الإخواني الآخر: عصام تليمة الذي حلف بالله العظيم على أن ضلاله اعتقادي وليس من باب المجاملة، فقال: «والله العظيم أعلم أنها مسيحية، وكتبتُ ما أعتقد جوازه شرعًا، غفر الله لها ورحمها».
ثم إن هذين الرجلين وأمثالهما تجرؤوا على كبيرة أخرى؛ فزعموا أن هذه المسألة «قضية خلافية»، {سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19)} [الزخرف].
وأخيرًا: فإنَّ ما نشاهده من دفاع مستميت ولو بالكذب والتدليس في سبيل تسويغ الترحم والاستغفار للكفار، ما هو إلا نتيجة منسجمة مع أصول ودوافع أصحاب هذا التفسير النفعي والسياسي للدين، وكما قيل: «إذا عُرف السبب بَطَلَ العجب».
والحمد لله رب العالمين.