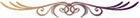
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
وبعد: إلى جانب الخلاف الذي نشأ حول تصوُّر الأمة والدولة والوطن، هجمت على المسلمين ألوان من الفكر السياسي وتطبيقاته في نظم الحكم والإدارة فُتن بها كثيرٌ من الناس، حتى لقد بدأ الإسلاميون يبحثون عن مُشَابهٍ ويفتِّشون عن نماذج ووقائع تلتقي فيها هذه النظم مع الإسلام، بل لقد نسبها بعضهم للإسلام أو نسب الإسلام لها، حين وصفوه تارة بأنه ديمقراطي، وتارة أخرى بأنه اشتراكي، وتارة ثالثة بأنه أول من دعا إلى الحرية الفردية وتحرير المرأة. وليس الإسلام من ذلك كلِّه في شيء. وظن كثير من السذج أن في هذا النسب الذي اختلقوه ما يُحبِّب الإسلام إلى هذا الجيل المفتون بتلك النظم الوافدة، والتي تَحُفُّها دعايات نشطة واسعة، تصور للناس أنها هي الحلُّ لما يشكُون منه، وأن حياتهم ستطيب في ظلِّها فيتخلصون من الظلم والفاقة والمرض والحرمان، ويعيشون حياة طيبة سعيدة، تخلو من المنغِّصات.
والظلمُ والفاقةُ والمرضُ والحرمان ـ كلُّها ـ آفاتٌ يتعرض لها الناس أحيانًا في ظل أي نظام، لأنها من نواميس الله في خلقه، يبلوهم بها ويمحِّصُهم ويزكيهم، ولكن المؤمنين يعيشونها ويتعرضون لها ويقاومونها، وهم راضون بقضاء الله العليم الحكيم، مُقرُّون بقصور معرفتهم وتقديرهم في جانب علمه وحكمته. فيعانون منها دون أن تضطرب نفوسهم لها، ودون أن يتعرضوا للصراع النفسي الذي يعاني منه الواقعون تحت تأثر الدعايات التي تدعوهم للثورة عليها، وتلوِّحُ لهم بجنَّةٍ سعيدةٍ من السَّراب تخلو منها؛ في ظل هذا النظام أو ذاك.
والمخدوعون بهذه الدعايات كثرتهم من الشباب البريء القلب، الخصب الخيال، الطموح إلى المثالية، أو الجانح إلى ما يدعوه إليه داعي الشباب من الشهوات، لذلك تخلبه الصور المثالية التي تقدمها هذه الدعايات، لأن خياله أقوى من عقله، ولأن آماله التي لا تحدُّها حدود أوسع من تجربته ومن خبرته النابعة من ممارسته، أو لأن فورة الشباب وطغيان الشهوة أغلب على سلوكه من الأناة وتدبر العواقب. وقد لا يُبالي في طموحه، وخصب خياله، وسعة آماله، ونهم شهواته أن تكون هذه النظم التي فتن بها مطابقة للإسلام أو معارضة له، فهي عنده صحيحة ومحببة على أي حال.
وقد يحاول التخلص مما يعانيه من الأزمة الناشئة عن التمزق الداخلي بنسبة هذه النظم إلى الإسلام، أو بأن يزعم لنفسه أن الإسلام لا يستهدف إلا خير الناس وصالحهم، فهو إذن لا يتعارض مع أي نظام يسعى لإسعادهم.
ومردُّ هذا الخلط والخبط راجع إلى أن الناس ـ وشبابهم على وجه الخصوص ـ يجهلون بل ينسون أو يتناسون، أن معرفتهم محدودة، ولذلك فإدراكهم للخير والشر محدود، لأن معرفة الخير والشر، والنافع والضارِّ مبنيةٌ على الإدراك الكامل لحقائق الأشياء التي لا تحدها حدود الزمان والمكان، ولعلَّتها الأولى وغايتها الأخيرة.
والمعرفة الإنسانية محدودة بحدود الزمان والمكان، بل هي في داخل قيود الزمان والمكان محدودة بحدود المتاح للإنسان مما هو غير محجوب عنه، من الغيب الذي لا تدركه حواسُّه ولا يتطاول إلى فكره. وهو مع ذلك محجوب عن معرفة العلة الأولى والغاية الأخيرة؛ إلَّا رجمًا بالظنِّ الذي لا يُغني عن الحقِّ شيئًا.
ومن كان هذ مبلغ عجزه، ومنتهى إدراكه؛ كيف يسوغ له أن يعارض مشيئةَ الله فيما أوحى إلى رُسُلِه عليهم الصلاة والسلام، وفيما رسم لهم من الحدود التي تميِّز بين الخير والشر، والنافع والضارِّ، والحلال والحرام، بدعوى أنه لا يعرف حقيقتها، ولا يدرك وجه المصلحة والضرر فيها؟
ومن أروع الأمثلة في هذا الصدد ما ورد في سورة الكهف من قصة سيدنا موسى مع العبد الصالح([1]):
خرَقَ العبدُ الصالح السفينة فأنكر عليه موسى عليه السلام عمله، لأنَّ عمله في ظاهر أمره، وفي حدود المعرفة المتاحة لأي إنسانٍ شرٌّ خالصٌ لا خير فيه، ولكنه ليس كذلك عند مَنْ كشف الله له عن معرفة ماضي أصحاب السفينة وحقيقة حالهم، وهي أنهم مساكين يعملون في البحر، ويعتمدون عليها في معاشهم، ولا يستطيعون شراء غيرها.
ومَنْ كشف له عن علم ما سيكون من أنهم سيصادفون مَلِكًا ظالمًا جبارًا يأخذ كلَّ سفينةٍ غصبًا، وأن خَرْقها سيعيبها فيتركها الملك لأصحابها؛ عند ذلك تنقلب الموازين، ويظهر الخير فيما كان في ظاهره شرًّا خالصًا.
ويقتل العبدُ الصالح غلامًا دون أن يبدو منه ما يدعو لذلك، ويستنكر موسى عليه السلام عمله، لأنه لا يعلم ما علمه العبد الصالح من أن أبويه مؤمنان، ولا يعلم ما سيكون من مستقبل أمر الغلام وأبويه، وأنه سيرهقهما طغيانًا وكفرًا. وأن الله سيبدلهما خيرًا منه زكاةً وأقرب رحمًا.
ويجوع موسى والعبدُ الصالح في بلدٍ رفض أهله أن يضيفوه، فيبني فيه العبد الصالح جدارًا يوشك أن يتهدَّم، ويبدو العمل في حدود المعرفة المتاحة لأيِّ إنسان يراه وضعًا للإحسان في غير موضعه، وأن أهل هذه القرية الظالمة لا يستحقونه، وكان الأولى أن يتخذ عليه العبد الصالح أجرًا، ثم يبدو الإحسان في موضعه الصحيح حين يطلعه على ما علمه الله مما غاب من حقيقة الحال، فالجدار لغلامين يتيمين في المدينة، وتحته كنز لهما ينكشف وينهب إذ سقط، وما غاب مما كان من أن أبويهما كانا عبدين صالحين، وما غاب مما سيكون من أن الغلامين سيستخرجان كنزهما بعد أن يبلغا أشدهما.
وقد تبدو بعض الظواهر شرًّا خالصًا ليس فيها للخير مكان، والله يعلم أن فيها من الخير ما يخفى على الخلق، وأن عمران الكون مبنيٌّ عليها، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ [البقرة: 216]. وعلَّة جهل الخير والشر في ذيل الآية: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، يعلم الله ولا يعلم الناس أن عمران الكون في التنافس الناشئ من دفع الناس بعضهم ببعض: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: 251].
وليس من المحتَّم أن يكون الخير الخفي عن الناس عاجلًا يظهر أثره في هذه الحياة الدنيا.
وليس الخير محصورًا في غذاء يملأ البطون أو كساء يختال على الأبدان، أو لذة تغرق فيها الحواسُّ، فقد لا يكون الخير عاجلًا، وقد لا يكون متصلًا بأجسادنا الفانية.
ذلك أن الإسلام يعمل للوجود كلِّه:
وأقلُّه وأتفَهُه الوجودُ الدنيويُّ الأرضيُّ، وما يتَّصل به من حاجات الأجساد.
وأبقاه وأدومُه ما صحب صاحبه في وجوده الممتدِّ الذي لا يحصيه علمنا ولا يبلغه خيالنا.
فإذا كانت غايات السياسة والاقتصاد إرضاء الشهوات: ﴿مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾ [آل عمران: 14]، فغاية الإسلام رضا الله.
وإذا كانت مطامع الناس محصورةً في إشباع شهوات النفس؛ فهدف الإسلام تزكية النفس وتطهيرها، بحملها على ما تكره من الجهاد في السلم والحرب، وإخراجها عما تؤثر من الدَّعَة والكسل، لتخرج من سجنها الضيق المحصور في ذاتها إلى عالم رباني أوسع وأرحب.
على أن كلَّ ما تسعى له السياسات الأرضية يقصر عن بلوغ هدفه القريب من إسعاد الناس في دنياهم؛ لأن السعادة حالة داخلية تسكن عندها النفس وتحس الراحة والطمأنينة والسكينة، فلا يُعذِّبها شعورٌ بالحرمان ممَّا لا تجدُ.
والدين أدنى إلى أن يبلغ بها هذا الهدف من كل سياسات الساسة والفلاسفة، ولكن الله ركب الحرص والشح في خلقه لتعمر الدنيا وتنتظم، وليدفع بعضهم ببعض، ويبلو بعضهم ببعض، ثم لا يتخلص من ذلك إلا النخبة القليل، بعد الجهاد الشاق الطويل.
المصدر: كتاب «أزمة العصر»، للدكتور محمد محمد حسين رحمه الله، دار عكاظ، الرياض، 1399/1979، ص: 63-66.
([1]) هو الخَضِرُ عليه السلام، وقد اختلف العلماء في أمره: هل كان نبيًّا أم عبدًا صالحًا؟ والصحيح المعتمد الذي قال به جمهور العلماء أنه كان نبيًّا يوحى إليه، ويؤيد هذا قوله تعالى في وصفه: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (٦٥)﴾ [الكهف: 65]. ونقل ابن حجر العسقلاني (ت: 852) في «الزهر النضر في حال الخضر» 66 عن الثعلبيِّ قال: «هو نبي في جميع الأقوال»، ثم قال ابن حجر رحمه الله: «وكان بعضُ أكابر العلماء يقول: أولُ عقدةٍ تحل من الزندقة: اعتقادُ كون الخضر نبيًّا، لأن الزنادقة يتذرَّعون بكونه غير نبيٍّ إلى أنَّ الوليَّ أفضل من النبيِّ». (تعليق المركز).