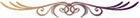
مقدمة الشيخ محمد سعيد الطنطاوي على رسالة
«أصول حضارة الإسلام عقد اجتماعي جديد» لمحمد أسد
مقدمة مركز دراسات تفسير الإسلام:
هذه مقدمة للشيخ محمد سعيد الطنطاوي على بحث: «أصول حضارة الإسلام عقد اجتماعي جديد» لمحمد أسد؛ رأينا من المفيد أن نستخرجها من «رسائل مسجد الجامعة»، ونفردها بالنشر، لأنها تخدم جهودنا في تتبع جذور التفسير السياسي والنفعي للإسلام في الفكر الإسلامي المعاصر.
ينبغي أن نذكر هنا نُبذةً عن تلك الرسائل وعن الكاتب والمقدم له:
أما «رسائل مسجد الجامعة»: فهي مجموعة من الرسائل التي كانت طبعتها وأصدرتها لجنة مسجد جامعة دمشق (أو: الجامعة السورية)، وقد بدأت بالصدور في سنة: (1371/1951)، وظهر لنا تاريخ آخر رسائلها أنها استمرت بالصدور حتى سنة: (1971/1391)، وقد أعاد الشيخ محمد زهير الشاويش (ت: 1434/2013) نشر هذه الرسائل في مجموعٍ من ثلاثة مجلدات (المكتب الإسلامي، بيروت: 1405/1985). تظهر أهمية هذه الرسائل في أنها تعبِّر عن واقع الفكر والدعوة في تلك العقود، خاصة أن كُتَّابها كانوا من مشاهير ذلك العصر، وهم من اتجاهات مذهبية وفكرية وحركية مختلفة، فتجد بينهم: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (1420/1999)، ويقابله: الشيخ وهبي سليمان غاوجي (1434/2103)، والمودودي (ت: 1399/1979)، ويقابله: وحيد الدين خان. ربَّما كان القدر المشترك بين أولئك الكتاب جميعًا: هو الاهتمام بواقع المسلمين ودراسة مشكلاته والسعي في الإصلاح والتجديد.
أما الكاتب فهو الصحفي والمفكر والمترجم الرحَّالة الأستاذ الشهير ليوبولد فايس، ولد في الإمبراطورية النمساوية الهنجارية عام (1900م)، وكان يهوديًّا، وأسلم سنة: (1926م)، وعُرف منذ ذلك الوقت باسم: (محمد أسد). أقام في آخر عمره في الأندلس (إسبانيا)، ومات هناك في 20 شباط 1992م، عن عمر يناهز (91) عامًا. أفضل كتبه: «الطريق إلى مكة» ذكر فيه قصة إسلامه، وسيرته الذاتية حتى الثانية والثلاثين من عمره. وكتابه: «الإسلام على مفترق الطرق»، وهو كتاب ممتاز في نقد الحضارة الغربية، ودعوة المسلمين إلى الاعتزاز بدينهم وشريعتهم، وقد نشره أول مرة في سنة: (1353/1934)، ثم عاد فنشره بمقدمة جديدة في سنة (1402/1982)؛ مؤكِّدًا على ثباته على ما جاء في الكتاب، فقد كتبه في شبابه وأول إسلامه، وأعاد نشره بعد خمسين سنة، وقد جاوز الثمانين، فهذا جانب مهم يستحقُّ الاهتمام. وأسوأ كتبه: ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزية، حيث تعرض فيه لبعض المسائل القطعية من أخبار القرآن وأحكامه بالتحريف، لهذا امتنعت رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة عن دعم طباعة هذه الترجمة ونشرها، بعد أن قامت لجنة علمية بدراسة الترجمة، وإطلاع سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت: 1389/1969) ـ مفتي المملكة العربية السعودية العام حينئذٍ ـ، على أخطاء الترجمة، ونوقش ذلك في مجالس المجلس التأسيسي للرابطة، فأفتى رحمه الله تعالى بـ: «وجوب إتلاف التفسير وعدم توزيعه» [انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة: 1399، 13/122].
أما المقدِّم: فهو الداعية الشيخ المعمَّر محمد سعيد الطنطاويُّ، ولد في دمشق سنة: (1343/1923)، وتوفي في جدَّةَ سنة: (1441/2019)، عن عمر يناهز (96) عامًا. وهو أخو الأديب الشهير علي الطنطاوي رحمهما الله تعالى.
وموضع الشاهد في هذه المقدِّمة: أن الشيخ الطنطاويَّ انتبه إلى النزعة المادية والنفعية في كلام محمد أسد، فانبرى إلى نقدها. وهذا يفيدنا أمرين مهمين:
الأول: ضرورة دراسة كتب ورسائل ومقالات الأستاذ محمد أسد لاستخراج شواهد هذه النزعة في كتاباته، وربطها بالجذور والأصول ثم بالنتائج والآثار في فكره وفهمه للإسلام ومقاصد دعوته.
الثاني: انتباه الشيخ الطنطاوي إلى هذا الانحراف، مما يدل على وجود هذه النزعة في ذلك الزمان، وقد أشار إلى بعض ذلك بقوله: «ومن هنا تبدو السطحية التي يقع فيها أحيانًا بعض الشباب وغير الشباب ممن يريد الخير ويعمل للدعوة، حين يحتال أحدهم على رفيقه ليدخل المسجد بإطماعه ببعض مكاسب الدنيا». لكن هذا الانتباه كان جزئيًّا عارضًا، وذلك لعدم وضوح هذه الدعوة وقوتها في ذلك الزمان، وكذلك لعدم تمايز الدعوات الحديثة بالوضوح الذي نراه اليوم، والحمد لله رب العالمين.
والآن نسوق مقدمة الشيخ محمد سعيد الطنطاوي رحمه الله تعالى:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي أنزل القرآن أساسًا لا يعدل به، وأرسل سيدنا محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم قائدًا لا يُعدل عنه.
وبعد:
فقد سُرِرت حينما اطلعت على النسخة الأولى التي أعدتها المطبعة من هذه الرسالة، سُرِرت لأنَّ النضج الفكري، والوعي الصحيح، والنظرة السليمة إلى الأمور، عنصرٌ أساسيٌّ في كيان الداعية المسلم، وأمثال هذا البحث مما يساعد على تنمية الفكر، وتسديد النظرة، وتقويم الموازين. وسُرِرت لأنَّ كاتب هذه الرسالة، هو المفكر المعروف «محمد أسد» مؤلف كتاب «الإسلام على مفترق الطرق»، والذي نشأ نمسويًّا وشبَّ على دين النمسويين، ثم هداه الله إلى الإسلام، قبل أربعين عامًا، فهجر ما كان يسميه وطنه، استبدله بالوطن الذي لا يعرف هذه الحدود، وترك ما كان يدعوه دينه، لمَّا ترفَّع عن دنيَّات الأرض وتعلَّق بنقاء السماء، وأكَّد هذا الفصم بتركه الاسم الذي وُلد فيه جسمه: «ليوبولد فايس»، إلى الاسم الذي ولدت فيه نفسه: «محمد أسد»، وساح في بلاد الإسلام، وجال في نجد والحجاز، وألَّف كتابه «الطريق إلى مكة»، ولبث طويلًا في الهند وباكستان، وشغل بعض المناصب هناك، وأصدر مجلته «عرفات»، بالإنكليزيَّة يعرِّف مَن لا يعرف العربية بالإسلام.
سرَّني من اللجنة الكريمة هذا الاختيار. وبدأت بقراءة البحث لأنَّنا كمسلمين لا نقدِّس الأشخاص، ولا نتبع رجلًا ما في كلِّ ما يقول لإعجابنا ببعض ما قال، ولا نردُّ على آخر كل ما قال لزَلَـلِــه في بعض ما يقول، نُجِلُّ العالم ونحبه، ولكنَّا لا نقدِّسه ولا نعبده، نستفيد من علمه، ونتَّعظ بتذكيره، ونشكر له ما أفادنا به، إلَّا أنَّنا لا نتعامى عن نقائصه، ولا نجعل مآخذه فضائلًا، ولا نتابعه على أخطائه، وإن كنَّا نعذره فيها، إن كان وكانت مما يعذر فيه. كما أنَّ مقتنا للباطل، وكرهنا للانحراف، لا يجعلنا نعدل عن الانصاف فنغمط المخطئ حقَّه، وننكر للمبطل فضله، فإذا كان قد أساء فيما اتبع فيه الباطل، فقد أحسن فيما قام فيه من الخير، وإذا كنا لم نحبّ الرجل الفاضل لشخصه بل لتقواه، نجفوه إذا جفا الحقَّ والخير، فكذلك لا يكون بغضنا شخصًا لذاته، بل لما يحمل من خلالٍ ذميمةٍ ويعمل من سوء، ينقلب كرهنا له حبًا، إذا انقلب إلى الصفات الحميدة والعمل الصالح.
ففاقِد الفكر، يرى المادة فقط، فيوالي ويعادي الناس لذات الناس. أمَّا أولو الفكر فيُعمِلون الفكر ويقدِّسون الحق، ويترفَّعون عن جعل الأجساد أساس مواقفهم من العباد.
إنَّ الحق أعلى من الناس وأقدم، يُعرفون به ولا يُعرف بهم، ويغرفون منه فيعرف حينئذ منهم، ورضي الله عن علي الذي يقول: «إنَّك لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله». ومالك رحمه الله ـ إمام دار الهجرة ـ لم يمنعه إجلاله علماء عصره، وإكباره شيوخه وأساتذته من أن يقول: «ما من أحدٍ إلَّا يؤخذ منه ويردّ عليه، إلَّا صاحب هذا القبر».
بدأت أقرأ هذه الرسالة، مع معرفتي بأنَّ «محمد أسد»، مفكِّرٌ كبير، وكاتبٌ قدير، وإنَّه يُستفاد من كثير من آرائه ومؤلفاته، ومعرفتي بأنَّني لا أبلغ مقامًا ذا بالٍ بين رجال هذا البلد، ولا أكاد أُعرف فيما جاوزه.. ولكنِّي أعرف أيضًا أنَّ من هو دوني قد ينتبه إلى خطأ لدى من هو أكبر منه، ويبقى مع ذلك هذا هذا، وهذا هذا، لم يصبح الصغير كبيرًا، لأنه لم يلحظ ما لاحظه بقدرة منه، بل بالحقِّ القديم، ولم يتضع الكبير ويسقط، لأنَّ كلَّ إنسانٍ معرَّضٌ للخطأ والسهو والنسيان، وكذلك:
فان يكن الفعل الذي ساء واحدًا فأفعاله اللائي سررن ألوف
ووصلت في القراءة إلى جوابه عن سؤال يردده البعض (ص ۱۷) عن قيمة الإسلام ونجاحه في إسعاد البلاد والعباد، وإلى رده على ذلك بقوله:
«وليس من الخير في شيء أن نجيب عن هذا التساؤل بقولنا: إن الإسلام شرعة الله»، وتوقفت عن القراءة، وتساءلت بدوري عن قيمة ما أجاب به، فوجدت أنَّ كثيرًا منَّا لا يرون في الترفّق بإقناع الآخرين بأنَّ الإسلام هو دين الله كبير جدوى، فيعدلون عن ذلك إلى ألوانٍ من الفلسفة. مع أنَّ جوهر إسلامنا هو هذا الاعتقاد بأنَّ الإسلام شرعة الله. صحيح أنَّ الإسلام جليلٌ وسامٍ وعظيم، وكلّه نفع وفائدة وخير، ولكن الذي يختار الإسلام لِما أنِسَ فيه من نفعٍ وما وجده من فوائد، ولما رآه من خير، لا يكون مسلمًا كما ينبغي، ولو دعا إليه، وعمل له، وبذل في سبيل ذلك دمه وماله. أجل، لا يكون مسلمًا حتى يختار الإسلام لأنه شرعة الله، أي لأنَّ الله عزَّ وجلَّ رضيه له وأمره به ولا يقبل منه غيره، وأكاد أن أقول أنَّ المسلم الحق هو الذي يقبل الإسلام ويتبنَّاه ويصمم على السير في سبيله قبل أن يطَّلِع على أوامر الإسلام ونواهيه وأنظمته وأجزاء حضارته.
إنَّ الإسلام استسلام، ينبثق عن العبودية والألوهية، أي عن إدراكه أنَّه عبد مخلوق بكلِّ ذرَّات جسمه وأجزاء كيانه وجميع ما يستعمله في هذه الحياة، وإدراكه عظمة من خلقه وحكمته وجبروته. إذا عرف المخلوق وأدرك أنه مخلوق، فقد عرف أنَّ له خالق، وإذا عرف الخالق نتج التوحيد وحصل الاستسلام فاستقام على الإسلام.
إنَّك حين تحتاج إلى شراء سلعة من شخصٍ غريب عنك تقلِّب السلعة وتختبرها وتُمعِن النظر فيها، خشية الغش فإنَّك تكره أن تحصل بمالك على سلعة فاسدة، أمَّا إذا كان البائع ممَّن تثق به وتعرف منه الصدق والأمانة فإنَّك لا تحتاج حينئذٍ إلى شيء من ذلك، وإنَّما تكتفي بقول البائع فيها وتزكيته لها. وإذا كان والدك من ذوي العلم والصلاح، وكان يجمع إلى هذا وذاك خبرةً بالغةً في هذا النوع من السِّلَع، وأتاك بهذه السلعة، التي قال لك أنه يرضى لك أن تفوز بها، أتُراكَ حين ذاك، لا تقبل ولا توافق إلَّا إذا فحصتها بنفسك ـ وأنت من أجهل الناس بهذا النوع ـ ثم ألقيت اليه بجوابك؟ أتُراك حينئذٍ تكون مهذَّبًا كريم الخُلُقِ طيَّعًا لأبيك راضيًا عنك ولو كان جوابك بالإيجاب؟، إنَّك حين تُظهر عدم ثقتك في أبيك وقلَّة اطمئنانك إلى علمه وخبرته. وتُحكِّم رأيك ـ «مع جهلك» ـ في علمه ـ «وهو المختص» ـ وخبرته، تكون ـ «في نظر الجميع» ـ قد جئت أمرًا إدًّا.
إنَّه لا يستقيم لك أمرٌ إلَّا إذا فهمت أنَّ العبد وما ملكت يداه لسيده، وأنَّك عبد الله الذي خلقك من عدمٍ وقوَّاك بعد عجز، ورزقك بعد عدم. وأنَّ المقصد الوحيد لك في حياتك هو نيل رضاه. ولا تنال رضاه إلَّا باتباع الإسلام لا يقبل ممن يبتغي سواه.
أمَّا أنَّ هذا القول لا يُرضي أحدًا ممن لا يؤمنون بالقرآن ورسول القرآن، وأنَّ هذه الحجَّة ليس لها من وزن أو خَطَرٌ عند من يجحدون ويرتابون..
فقد يكون هذا صحيحًا، ولكن ما وزن ذلك وما خطره؟، وإذا كانوا قد عموا عن هذا الأساس العظيم الواضح أنَّهم مخلوقات غارقة في العجز. وأنَّهم ليسوا آلهة، وأنَّ عليهم الخضوع والطاعة لمن خلقهم، إذا كانوا قد عموا عن هذا أو تعاموا عنه أتُراك تظنُّ أنَّهم سينقادون لأدلَّتك العقلية السديدة؟
إنَّنا لا ندعو الناس إلى أن يتكرموا بالموافقة على الإسلام ولا أن يمنُّوا علينا بتأدية أعمال الإسلام. وإنَّما ندعوهم إلى التوحيد، فإن قبلوا فقد قبلوا الإسلام لأن الإسلام هو الاستسلام لله، والسير في السبيل الذي يرضاه، لا لشيء الَّا لوجه الله. وإن أبوا التوحيد، فلا يجدي قبولهم بأيِّ أمر من أمور الإسلام أو قيامهم بعمل من أعماله.
ومن هنا تبدو السطحية التي يقع فيها أحيانًا بعض الشباب وغير الشباب ممن يريد الخير ويعمل للدعوة، حين يحتال أحدهم على رفيقه ليدخل المسجد بإطماعه ببعض مكاسب الدنيا، أو تهديده بفوات شيء منها. لا يا أخي الكريم إنَّ كلَّ عملٍ لا ينبعث عن الإيمان بالله ويقوم على قاعدة من التوحيد لا قيمة له ولا نفع ولا أثر. {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (23)} [الفرقان]، إنَّ الذي لم يؤمن بالله يكون كافرًا، وأعمال الكافر مهما قام به من أعمال الخير وتحمل وبذل سراب! {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ} [النور: 39].
هذه السطحية هي التي يقع فيها كثيرٌ ممن يناقشون المنحرفين أو الملحدين ببعض أمور الإسلام، فيمضون الساعات ولا يحصدون سوى العناء!
إذا أردت يا أخي أن تدعو حقًّا فالتزم هذه القاعدة التي سنَّها لك قائدك الحبيب صلَّى الله عليه وسلَّم. الدعوة إلى التوحيد دعوة واضحة جليَّة، لا تعقيد ولا غموض. فاذا أبى تركته ووفَّرت جهودك لغيره، وإن قبل فقد انتهى كل شيء.
إنَّ أجزاء الإسلام لا تنتهي، فاذا أصبح شغلك أن تجرَّ الناس إليها واحدة بواحدة، لم يكف أضعاف عمرك لجرِّ واحد من الناس لبعضها، وكلَّما جررته إلى أمر تفلَّتَ من أمور وعدتَ إلى العناء من جديد. وأمضيت حياتك في مكابدةٍ وشقاء. أما إذا ترفَّقت بدعوته إلى الأساس، فجلَّيته له وأقنعته به فرضيه وآمن به ـ ولن يتسنَّى لك هذا إلَّا إذا كنت أنت قبل ذلك مؤمنًا به فاهمًا له مستقيمًا بصدق وقوَّةٍ على سبيله ـ إذا قبل هذا فلن يُحيجَك إلى دعوته لأي أمر، لأنَّه سيندفع حينئذ بنفسه إلى البحث عن هذه الأجزاء وتعلمها والاستقامة عليها والدعوة اليها..
وفي (ص ۲۷) يقول:
«.. ولم يكن بين صحابة رسول صلَّى الله عليه وسلَّم فئةٌ أو طبقة تفرَّدت بامتيازٍ أو سلطانٍ على من عداها من الطبقات أو الفئات، وما كان لأيِّ لونٍ من ألوان التمايز والتباين بين الصحابة أن يوجد..».
ولا أريد أن أقول أنَّ هذا خطأ، وإنما أحب أن أُذكِّر بضرورة فهمه كما ينبغي، على وجهه الصحيح.
فإنَّك حين تقرأ في السيرة والتاريخ الإسلامي، أنَّ أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه كانوا القرَّاء، وأنَّهم لم يكونوا يُؤمِّرون على الجيوش الإسلامية، الكبيرة أو الصغيرة، إلَّا البدريين وأمثالهم وأنَّ عمر كان يستشير في الأمور رؤوس الناس وكبار المهاجرين والأنصار، وأنَّ أحد كبار الصحابة ـ لمَّا انتقد عليه أحد الناس أنَّ الكبار في المدينة قد بحثوا لوحدهم أمر الخلافة وقرَّروا فيه هم، دون بقيَّة الناس. قال له شيئًا معناه: «إنَّ الأمر إلى هؤلاء إذا رضوا شيئًا تقرَّر، وإذا كرهوه ترك، وإنما أنتم تَبَعٌ!» إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تبيِّن أنَّه كان يوجد فيهم امتياز. والرواتب التي جعلها عمر للمسلمين وتباينها الكبير بين اثني عشر ألف وثلاث مئة، لها دلالتها في هذا المجال. ولكن هذا التمايز مهما كان لونه، ومهما بلغت حدوده، فإنَّما يعود فقط إلى الإسلام ويقوم على الإسلام فحسب. أمَّا النسب والغنى والسلطان وما إلى ذلك.. فلا يُؤبَه لها ولا يلتفت إليها، فبقدر ما لدى الرجل من الإسلام يكون له، وبحسب سابقته في الإسلام تكون منزلته، وما رفعوا من رفعوا إلَّا برفعه الإسلام وإقباله عليه وتحمله وجهاده في سبيله، ولا اتضع من اتضع إلا بإعراضه وتقصيره..
وأعود فأعيد: أنَّني لم أرد بكلامي هذا أن أردَّ على الكاتب، فالرجل أكبر من أن يكون أراد هذا، غير أنَّ الكلام يحتمل، وقد يوجد من يحمله على غير المحمل، وبعض الناس قد يقع في الالتباس، لذا كان لا بأس من التوضيح، وبعض التنويه قد يقي من التشويه!
نعوذ بالله من الانحراف والتقصير، ونستعين بالله على الاستقامة والتشمير، والهديَ نقصد، ورضاءَ الله نطلب، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العلي العظيم.
انتهى كلام الشيخ محمد سعيد الطنطاوي رحمه الله تعالى.
المصدر: «رسائل مسجد الجامعة»، جمعها وأعاد نشرها: الشيخ محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1405/1985، 3/211-218.