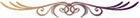
خُلق الإنسان ليعرف مبدعه الحكيم، ويعمل في حياته على صراط مستقيم، والعمل القيّم ما كان موافقًا لما رسمه الشارع، وصحبته نية طيبة، فإن كان العمل غير موافق لما ورد عن الشارع، فهو عمل باطل، وإن قصد به صاحبه التقرب إلى الله، وذلك هو البدعة التي سماها النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ضلالة، وإن كان العمل على نحو ما رسمه الشارع، ولكن صاحبه لم يقصد به امتثال أمر الله، فهو مردود على صاحبه؛ لأنه فقد الروح الذي يعطيه حياة وبهجة، وهو الإخلاص.
ومدار الإخلاص على أن يكون الباعث على العمل أولاً: امتثال أمر الله، ولا حرج على من يطمح بعد هذا إلى شيء آخر، بنعيم الآخرة، أو النجاة من أليم عذابها، بل لا يذهب بالإخلاص ـ بعد ابتغاء وجه الله ـ أن يخطر في باله أن للعمل الصالح آثارًا في هذه الحياة؛ كطمأنينة النفس، وأمنها من المخاوف، وصيانتها من مواقف الهون، إلى غير هذا من الخيرات التي تعقب العمل الصالح، ويزداد به إقبال النفوس على الطاعات قوة على قوة.
ومن المعروف عند أهل العلم: أن قصد المصلحة الدنيوية من عمل الخير ـ بعد تحقق قصد الامتثال لأمر الله ـ لا ينزل عن درجة القبول؛ كأن يقصد من رحلته التجارة مع قصد أداء فريضة الحج، أو يقصد التبرُّدَ بعد قصد التطهُّرِ بالماء لأداء فريضة الصلاة، أو يقصد التلذذ بالعلم بعد أن يقصد الوجه الذي اقتضى أمر الشارع بدراسته، فمن يطلب علوم الدين؛ ليصلح نفسه، ويرشد غيره، أو يدرس فنون الحرب؛ ليدافع عن شريعته، ويحمي ذمار أمته، فلا جناح عليه بعد هذا أن يذكر ما في العلم من لذة، فيزداد ارتياحه، ويقوي نشاطه.
حضر الشريف التلمساني وهو صبي درس الأستاذ أبي زيد بن الإمام، فذكر أبو زيد نعيم الجنة، فقال له الشريف: هل يقرأ في الجنة العلم؟ فقال أبو زيد: نعم، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فقال الشريف: لو قلت: لا، لقلت: لا لذّة فيها. فعجب منه الشيخ، ودعا له.
والإخلاص يرفع شأن الأعمال حتى تكون مراقي للفلاح، وهو الذي يحمل الإنسان على مواصلة عمل الخير، فمن يصلي رياء، أو حياء من الناس، لا بد أن تمر عليه أوقات لا ينهض فيها إلى صلاة، ومن يحكم بالعدل ابتغاء السمعة، أو خوف العزل من المنصب، قد تعرض له منفعة يراها ألذ من السمعة، أو يصادفه عهد حكومة يأمن فيه من العزل، فلا يبالي أن يدع العدل جانبًا، ومن يدعو إلى الإصلاح ابتغاء الجاه، قد ينزل بين قوم لا يحظى بينهم إلا من ينحط في أهوائهم، فينقلب داعيًا إلى الأهواء.
وقد أرتنا الأيام أشخاصًا كانوا يظهرون في اعتدال وغيرة على الحق، ثم اتصلوا بنفر من أهل الدنيا يناوئون هداية الله، فلم يكن منهم إلا أن طرحوا ثوب الاعتدال، وصاروا ينطقون بلهجة أولئك النفر في شيء من التورية.
ومن يفعل المعروف؛ لتردد ذكره الألسنة في المجالس أو الصحف، قد يرى بعينه سبيلاً من سبل الخير في حاجة إلى مؤازرة، ولكنه لا يرى بجانبه لسانًا أو قلمًا شأنه إطراء المؤازرين، فيصرف عنه وجهه، وهو يستطيع أن يمد إليه يده، ويسد حاجته.
والإخلاص هو الذي يجعل في عزم الرجل متانة، ويربط على قلبه، فيمضي في عمله إلى أن يبلغ الغاية، وكثير من العقبات التي تقوم دون بعض المشروعات لا يساعدك على العمل لتذليلها إلا الإخلاص، ولولا الإخلاص يضعه الله في نفوس زاكيات؛ لحرم الناس من خيرات كثيرة تقف دونها عقبات.
قد يخلص الرجل في بعض الأعمال، ويتغلب عليه الهوى في بعض؛ فيأتي بالعمل صورة خالية من الإخلاص، والذي يرفع الشخص إلى أقصى درجات الفضل والمجد، إنما هو الإخلاص الذي يجعله الإنسان حليف سيرته، فلا يقدم على عمل إلا وهو مستمسك بعروته الوثقى. ولا أكون مبالغًا إذا قلت: إن النفس التي تتحرر من رق الأهواء، ولا تسير إلا على ما يمليه عليها الإخلاص، هي النفس المطمئنة بالإيمان، المؤدبة بحكمة الدين ومواعظه الحسنة.
فالإخلاص الذي يقوم على الإيمان الصادق، والتهذيب الديني، هو الذي يسمو سلطانه على كل سلطان، ويبلغ أن يكون مبدأً راسخًا تصدر عنه الأعمال الصالحة بانتظام، وهو الذي يجد له صاحبه حلاوة، فيسهل عليه أن يكون أحد السبعة المشار إليهم بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «سَبعة يظلهم الله في ظِلّه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ» إلى أن قال: «ورجل تصدَّقَ بصدقةٍ، فأخْفاها حتى لا تعلم شِماله ما تنفق يمينُه».
وحكى أشعب بن جبير: أنه كان في بعض سكك المدينة، فلقيه رجل وقال له: كم عيالك؟ قال: فأخبرته، فقال لي: قد أُمرت أن أجري عليك وعلى عيالك ما كنتَ حيًا، فقلت: من أمرك؟ قال: لا أخبرك، قلت: إن هذا معروف يشكر، قال: الذي أمرني لم يُرِدْ شكرَك. قال: فكنت آخذ ذلك إلى أن توفي خالد بن عبد الله بن عمر بن عثمان، فحفل، له الناس، فشهدته، فلقيني ذلك الرجل فقال: يا أشعب! هذا والله! صاحبك الذي كان يجري عليك ما كنت أعطيك!.
هذا فاعل للخير من وراء حجاب، وأين هو من أشخاص لا يتورعون أن يلبسوا الحق بشيء من الباطل، ويزيدون على هذا أن يزعموا أن هذا اللبس إصلاح، ويعلنون بأجهر صوت أنهم مخلصون فيما يقولون أو يفعلون؟!.
ولعلك لا تجد أحدًا يتصدّى لعمل إلا وهو يدّعي الإخلاص فيما يعمل، ذلك لأن الإخلاص موطنه القلب، والقلوب محجوبة عن الأبصار، واذا وصفت أحدًا بالإخلاص، أو عدم الإخلاص، فإنما ترجع في وصفك إلى أمارات تبدو لك من أحواله الظاهرة.
ومن هذه الأحوال ما يدلك على سريرة الرجل دلالة قاطعة، ومنها ما لا يتجاوز بك حد الظن، وهذا موضع التثبت والاحتراس، ففي وصف المخادع بالإخلاص، ووصف المخلص بالخدل، ضرر اجتماعي كبير، فإن وثقت بمجرد الظن، لم تأمن أن تقضي على فاسد الضمير بالإخلاص، فيتخذه الناس موضع قدوة، فيستدرجهم إلى فساد صغير، حتى إذا ألفوه، نقلهم إلى فساد كبير، وربما قضيت على طاهر القلب بعدم الإخلاص، فكنت كمن يسعى لإطفاء سراج، والناس في حاجة إلى سُرج تنير لهم السبيل.
والإخلاص الذي يخالط النفوس حتى يكون القابض على عنانها هو في نفسه فضيلة؛ وهو لا ينزل إلا حيث تنزل فضائل كثيرة، فالإخلاص يمد جأش صاحبه بقوة، فلا يتباطأ أن ينهض للدفاع عن الحق، ولا يبالي ما يلاقي في دفاعه عنه من أذى.
والإخلاص يشرح صدر صاحبه للإنفاق في بعض وجوه البر، فتراه يؤثرها بجانب من ماله، وإن كان به خصاصة. الإخلاص يعلّم صاحبه الزهد في عَرَض الدنيا، فلا يخشى منه أن يناوئ الحق، أو يلبسه بشيء من الباطل، ولو أمطر عليه أشياع الباطل فضة أو ذهبًا.
والإخلاص يحمل القاضي على تحقيق النظر في القضايا، فلا يفصل في قضية إلا بعد أن يتبين له الحق.
والإخلاص يوحي إلى الأستاذ أن يبذل جهده في إيضاح المسائل، وأن لا يبخل على الطلاب بما تسعه أفهامهم من المباحث المفيدة، وأن يسلك في التدريس الأساليب التي تجدد نشاطهم للتلقي عنه.
والإخلاص يصون التاجر عن أن يخون الذي يأتمنه في صنف البضاعة أو قيمتها؛ ويحمل الصانع على إتقان عمله حسب الطاقة.
والإخلاص يردع قلم الكاتب عن أن يقلب بعض الحقائق، أو يكسوها لونًا غير لونها؛ إرضاء لشخص أو طائفة.
وإذا كان للإخلاص هذه المآثر العظيمة، فحقيق علينا أن نربّي الناشئين على أن يكونوا مخلصين في كل ما يقولون أو يفعلون، ونلقِّنَهم ماذا يناله المخلص من حمدٍ وكرامةٍ وحسن عاقبة؛ لكي تُخرِّجَ لنا معاهدُ الدين والعلم رجالًا يقوم كل منهم بالعمل الذي يتولاه بحزم وإتقان.
محمد الخضر حسين
«موسوعة الأعمال الكاملة» 5/76-80. دار النوادر.