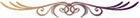
بقلم: الشيخ محمد خليل هراس
لستُ في حاجة إلى التنويه بما للأخلاق الكريمة من منزلةٍ رفيعةٍ في الإسلام، حتَّى إنَّه ليعدُّها الثمرة المرجوَّة لكلِّ ما جاء به من عقائد وأحكام. والرسول صلَّى الله عليه وسلَّم يخبر أنَّ إتمام مكارم الأخلاق والدعوة إليها بالقول والقدوة، كان هو القصد الأوَّل من بعثه فيقول: «إنما بعثت لأتمِّم مكارم الأخلاق»، وجعلها شقيقة التقوى فيقول: «إنَّ أثقل ما يُوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق»، وفي وصيَّته الجامعة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن يقول له: «اتَّق الله حيثما كنت، وأتبع السيَّئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن».
وإنَّما غرضي بهذه الكلمة أن أُبيِّن ما امتاز به الإسلام في الناحية الأخلاقيَّة على كلِّ ما عُرف من مذاهب وفلسفاتٍ في القديم والحديث، سواءً في تحديده للغاية التي يجب أن يتَّجه إليها السلوك الإنسانيّ وتكون مصدر لجميعِ أعمالِ المرء وسعيه في هذه الحياة ـ أم من ناحية تربيته للقوَّة التي تقوم بالرقابة على تلك الأعمال ودوافعها من القصود والأرادات، وهذه القوَّة هي التي يسمِّيها فلاسفة الأخلاق بالضمير ـ وكذلك من ناحية التمييز بين خصال الشرِّ، ووضع الموازين الدقيقة لكلٍّ منهما وتقدير الظروف والملابسات التي تكتنف الأعمال وتؤثِّر في نعتها بالخيريَّة أو الشرِّيَّة، إلى غير ذلك مما يشهد للإسلام بأنَّه الدِّين الذي وَضَعَ للأخلاق نظامًا عمليًّا كاملًا يمتاز بالإيجابيَّة، وبناء على أقوى الدعامات. وفتح به للإنسان باب الصعود في معارج الكمال إلى ما قُدِّر لهذا النوع أن يبلغه تبعًا لاستعدادات أفراده واختلاف أنصبائهم من الأخذ بأسباب هذا الكمال المنشود.
فمن الناحية الأولى نجد أنَّ الإسلام لا يعترف بتلك الغايات الأخلاقيَّة الوضيعة التي يهرِف بها فلاسفة الأخلاق والتي لا تليق بالإنسان من حيث أنَّه ذلك الكائن الذي قُدِّر له أن يُبعث في حياة أخرى لِيَلْقَى فيها جزاء ما قدَّمت يداه في ذلك العمر المحدود الذي عاشه في حياته الأولى.
ليست الغاية التي يجب أن يتَّجه إليها سلوك المرء وعمله في نظر الإسلام، هي تلك اللذَّات العاجلة القصيرة التي لا بقاء لها والتي لا تليق إلَّا بالعجماوات من حيث أنَّها تعيش بغرائزها وحدها دون أن يكون لها عقل يحجزها عما لا يليق، فمذاهب اللذَّة في الأخلاق مُزرية بكرامة الإنسان، حيث لا تعترف له بفضيلة ولا تُقرُّ بفرق بينه وبين غيره من الحيوان، فهدف الإنسان وغايته في نظرها يجب أن يكون هدف كلِّ كائنٍ حيٍّ، جلب اللذَّة والفرار من الألم ولا شيء غير هذا. نعم إنَّ الإسلام لا يمنع التمتّع بالطيِّبات التي أحلَّها الله لعباده بل لعلَّه يحثُّ على ذلك ويرغِّب فيه كما يدلُّ عليه قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الأعراف: 32]، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)} [المائدة].
ولكنَّه مع ذلك يُنكر أشدَّ الإنكار على من يجعل ذلك غاية له ويقصر سعيه عليه كما يشير إليه قوله تعالى: {وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا} [الأحقاف: 20]، وقوله جلَّ شأنه: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16)} [هود]، إلى غير ذلك من الآيات التي تذم أشدَّ الذم من يجعل متاع الحياة الدنيا غاية يقف عندها ولا ينظر إلى ما وراءها من غايات.
وليست الغاية كذلك في نظر الإسلام هي ما يقوله النفعيُّون من أنها تحقيق أكبر قدرٍ من المنفعة لأكبر عددٍ من الناس، ولو أنَّ هذه الغاية أشرف من سابقتها لأنَّها تتوَّخَّى مصلحة المجموع ولكنَّها على كلِّ حال ليست الغاية التي يجب أن تقتصر عليها الجهود، بل يمكن عدَّها جزءًا مما ينبغي أن يتَّجه إليه سعي الفرد، فهي داخلة في نطاق قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2] وقوله عليه الصلاة والسلام: «خير الناس أنفعهم للناس».
وليست الغاية للسّلوك ـ أيضًا ـ ما ذهب إليه الواجبيون من أنَّها عمل الواجب لذاته أي لأنَّه الواجب ولو ترتَّب عليه فوت منفعة أو حصول ألم، لأنَّ الإنسان بما فُطر عليه من حبٍّ للذَّات والمنافع وكراهة للآلام والمضارِّ، لا يمكن أن يندفع إلى عمل إلَّا إذا كان يرجو من ورائه جلبَ منفعةٍ أو دفعَ مضرَّةٍ، أمَّا عمل الواجب للواجب فهو أمرٌ تقديريٌّ محض تأباه واقعيَّة الإسلام واعتباره للفطرة الإنسانيَّة، أكثر القرآن من الوعد والوعيد ليكون الأوَّل مُنشِّطًا النفوس معزِّيًا لها عمَّا فَقَدَتْه في هذه الحياة من لذاتٍ واحتملته من آلامٍ، وليكون الثاني زاجرًا لها عن الوقوعِ فيما يُفضي بها إلى العذاب المبين في الآخرة.
وإذا كانت هذه الغايات وغيرها ممَّا جهدت فلسفة الأخلاق في تقريره، وأتعب الأخلاقيُّون عقولهم في استخراجه وتحريره، لا تصلح أن تكون غايةً لعمل الإنسان وسعيه في هذه الحياة. فإنَّ القرآن الكريم يُقدِّم لنا الغاية التي يجب أن تتنافس فيها الهمم وتستحثَّ إليها مطايا العزائم، وهي: الظفر بمغفرة الله ورضوانه والحظوة بالزلفى لديه، ودخول دار رحمته مستقرِّ الصالحين من عباده. قال تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133)} [آل عمران]، وقال سبحانه: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (26)} [المطففين].
وقال تعالى في سورة الصافات بعد وصفه لنعيم الجنة: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (60) لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (61)} [الصافات].
وهكذا نرى أنَّ هذه الغاية التي وصفها القرآن الكريم لتكون هدفًا لأتباعه يتَّجهون إليها في كلِّ ما يصدر عنهم من عقائد وأقوال وأرادات وأعمال، هي الغاية الجديرة بأن يطلبها كلُّ إنسان يعلم أنَّ مصيره في حياته الأخرى رهن بما يقدم في هذه الحياة، مرتبط به ارتباط النتيجة بالمقدمات، كما قال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)} [الزلزلة].
الشيخ محمد خليل هراس (ت: 1395) رحمه الله
المدرس بكلية أصول الدين
«مجلة الهدي النبوي» الصادرة عن جماعة أنصار السنة المحمدية، المجلد الخامس والعشرون، الصفحة 49-51، العدد الثالث، غرة ربيع الأول سنة 1380، الموافق لشهر أغسطس سنة 1960م، الناشر: مكتبة منار التوحيد للنشر، المدينة النبوية، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 22/49-51.