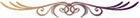
[هذا المقال نشره العلامة الشيخ محمد حامد الفقي (ت: 1378) رحمه الله تعالى في «مجلة الهدي النبوي» بعنوان: (الصيام)، وهذا نصُّه بتمامه:]
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} [البقرة: 183 - 185].
وما أوحى الله تعالى بالشرائع إلى من يصطفيهم من أنبيائه في مختلف العصور، وما أنزل من أحكامٍ وعباداتٍ في تلك الشرائع الإلهيَّة، إلَّا لإصلاح الإنسان وتزكية نفسهِ وتطهيرها، ممَّا يحاول الشيطان أن يكدِّرها به من وساوس ومفاتن، وما يزيِّنه لها من فسوقٍ وعصيان، كلَّما ازدادت منه واستحبَّته كلَّما ارتكست في مهاوي السِّفال الحيواني وتلطَّخت في حمأة الشيطانيَّة النجسة الرجسة.
وكلَّما تطهَّرت منها، وتأصَّلت فيها كراهيَّتها، وامتزج بذرَّاتها محبَّة الله ومحبَّة طاعته، وقامت له سبحانه على قَدَم العبوديَّة وأخلصت له ذُلَّ الخضوع، وصدقت في رهبة الشرع، كما ارتفعت في معارج الكمال، وارتقت إلى درجات الحياة الهنيئة والعيش الرغيد في الحياة الدنيا، ولتحظى يوم القيامة مقام الأبرار.
وما كمالُ الإنسان إلَّا بغلبة روحانيَّته العاقلة على حيوانيَّته الجاهلة، وقهر معنويَّته الحكيمة لماديَّته السفيهة الطائشة؛ وسيطرة قلبه الصالح، ونفسه المطمئنَّة على شهواته الجامحة ونفسه الأمَّارة.
تلك هي الكمالات الإنسانيَّة، وما تكون هذه الكمالات ولا شيءٌ منها إلَّا من غراس النبوَّة، وما نماؤها وامتداد ظلِّها، وكثرة ثمارها إلَّا بسقيها من ماء العلم الإلهي الذي نزل من السماء صافيًا على أرض القلوب فتهتزُّ وتربو، وتخرج من كلِّ الثمرات الطيِّبات المباركات، ما به سعادة الإنسانيَّة وفلاحها في دنياها وآخرتها: في الفرد والأسرة والجماعة والأمَّة، وفي القرون والأجيال يبقى نورها مشعًّا للنَّاس يقتبسون منه ويستمر شَذاها عبَقًا يفوح عبيره لكلِّ مستمتعٍ، وصوتها غردًا في أُذن كلِّ محبٍّ صَدَقَ في حُبِّه إذ عَرَفَ أنَّ مكانة القلب الرفيعة لا يليق أن يتبوَّأها إلَّا محبَّة الله ومحبَّة ما يُحبُّه الله من قولٍ وعملٍ وهديٍ وسمت، وخُلُقٍ وصفة، وظاهرٍ وباطن، {أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [البقرة: 5].
جعل الله الرحمن الرحيم من تلك العبادات حِبالًا يَصِل بها قلب عباده المهتدين إلى حضرة قدسه، ويجذبهم بها إلى رياض قربه، ليتمتَّعوا بما مدَّ لهم من موائد فضله العظيم ولينعموا على بساط رحمته بما وهب لهم من أُعطياته الواسعة التي لا تساوي الدنيا وأمثالها معها بجانبها عندهم قلامة ظفرٍ ولا دونها، {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة: 17]، «أعددت لعبادي المتقين ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت، ولا خَطَرَ على قلب بشر».
وإنَّ قومًا فهموا في تلك العبادات التي هي مِنَحٌ إلهيَّة، وصِلاتٌ رحمانيَّة، ونفحات قدسيَّة: أنَّها تكاليف وأعمال قهريَّة ومشقَّاتٍ تأديبيَّة لمحرومون كلَّ الحرمان من ذوق شرابها العذب وورود منهلها النمير، وبعيدون كلَّ البعد عن اكتناه روحها السامية وعلى بصائرهم غشاوة أن تشهد إشراق هذه النفحات على الأرواح فتسمو بها إلى عليِّين.
ليست العبادات تكليف بل هي تشريف، ليست العبادات مشقَّات بل هي نعيمٌ ومسرَّات، ولكنَّ أكثر الناس لا يعقلون.
لماذا كانت منحة الصلاة للحبيب صلَّى الله عليه وسلَّم ليلة عُرج به إلى فوق السماوات كان قاب قوسين أو أدنى؟ ذلك لأنَّه أسعده في هذه الليلة بلذَّة القرب، ووصله في ساعة القرب بحديث الحبيب إلى حبيبه، فذاق قلب الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم من ذلك اللذَّة الروحيَّة العليا؛ وأشرقت نفسه الكريمة في ذلك الوقت بنور صفوة الصفوة، وخيِرة الخيَرة وسمو {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ} [الإسراء: 1]
فكان من الصعب على الحبيب صلَّى الله عليه وسلَّم البعد بعد نعيم القرب، وكان الله به أرحم من أن يمنعه تلك النعمة بعد أن عرفها وتمتَّع بروحها، فمنحه الصلاة لتكون الصلة بين الحبيب وحبيبه كلَّما اشتاق إلى لذَّة القرب. ومن ثمَّ قال: «وجعلت قرَّة عيني في الصلاة» وكان يقول: «يا بلال أرحنا بالصلاة» ويقول عن الله سبحانه وتعالى: «قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله ربِّ العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى عليَّ عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدِّين. يقول الله: مجدَّني عبدي. يقول العبد: إيَّاك نعبد وإيَّاك نستعين. يقول الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالِّين. يقول الله: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل»
العبد يقبل على ربِّه، والله يتكرَّم بالإقبال على عبده، العبد يستفتح باب ربِّه، والله يتفضَّل بفتح باب الوصول لعبده، العبد يكلِّم ربَّه بأصدق الحديث وأحبِّ الذكر إلى ربِّه، والله يسمع لعبده ويجيب عبده كلمة بكلمة، ودعوة بإجابة.
وافهم قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنَّ العبد إذا قام يصلِّي فإنَّه إنَّما يناجي ربَّه فلينظر أحدكم من يناجي» والمناجاة: هي الكلام الذي لا يدركه إلَّا المتحدثان مع بعضهما.
الله أكبر. هذا كلّه يُسمَّى تكليفًا!، ويقال عليه: أنَّه مشاق تأديبيَّة، سبحان الله ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله.
وهذا. وربِّكَ شأن العبادات كلّها من صيام وغيره.
فاستمع إلى مبدأ خطاب الله في الصيام: ودعوته أحبابه إلى هذا الباب من الجود والرحمة، يناديهم بأحبِّ الألقاب وأطيب الأسماء، وأعذبها على قلوبهم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} وهو مع عذوبته وجماله: خطاب تكرمة وتشريف، كشأنه في خطاب حبيبه صلَّى الله عليه وسلَّم {يَا أَيُّهَا الرَّسُول}، {يَا أَيُّهَا النَّبي}، ثم يقول: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، وأجمع إلى هذا قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: «الصوم جُنّة»، فالجنّة: هي الوقاية التي يقي المؤمن بها إيمانه من كلِّ ما يخافه فإنَّه ليس عند المؤمن أعزّ وأغلى من إيمانه. فهو يخاف عليه أشدَّ من خوفه على بصره وسمعه وعافيته في كلِّ جسمه، فبماذا يقي إيمانه مما يكره؟ وبمَ يجنّ إيمانه ويحفظه ممَّا يخاف؟ لا يجد لإيمانه وقاية وصيانة إلَّا من طريق العلم النافع، وليس له علمٌ نافعٌ إلَّا من القرآن الذي هو الروح، وهو النور، وهو الهدى، وهو الفرقان، وهو الذكر الحكيم، فيلبس من درع القرآن، وهداية القرآن وأدب القرآن ومواعظ القرآن وشرائع القرآن ما يجنّ إيمانه ويقيه كلَّ ما يكدِّره أو ينقصه أو يذهب به، من بذاء اللسان وسفه الأحلام، والجهل والفسوق والعصيان، وما إلى ذلك من كلِّ ما يوسوس به أو يزيِّنه شياطين الإنس والجن، في السرِّ والعلن والظاهر والباطن، والقلوب والأعمال.
الصوم جنّة: لأنَّه يدخل في حضرة القرب والمراقبة لله والمعيَّة الخاصَّة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ساعات من النهار طويلة يجاهد فيها كلَّ عوامل الشرِّ: من نفسٍ وقرينٍ وشيطان، وفتنٍ محيطةٍ، وكلَّما دعاه من تلك داعٍ، صاح به: إنِّي مع ربِّي، إنِّي مع سيدي، إنِّي مع مليكي، إنِّي في رياض القرب، إنِّي على موائد الفضل. فاذهب عنِّي، لا تحرمني من ربي ولا تقطعني عن ربِّي، ولا تحل بيني وبين ربِّي أرحم الراحمين: الذي يغذي روحي وقلبي من غذاء رحمته، ويفيض على نفسي من سحائب فضله وبرِّه. وهذا سرُّ قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنِّي أبيت عند ربِّي يُطعمني ويسقين».
فاذا ما حظيتَ أيُّها الصائم بلذَّة هذا القرب الإلهي، وإذا ما سعدت بنفحة من نفحات «عند ربِّي» زكت نفسك، واتَّسع مدى نور قلبك، وغلبت عليك الحكمة في قولك وعملك، وبرئت من مرض السَّفَه والطيش، والجهل وسوء الأخلاق.
فاذا ما غربت الشمس تبلَّغت بعض ما يقيم صلبك إبقاءً على وعاء تلك الروح وحفظًا لسياج القلب، ولم تَرْتَع في الأطعمة والأشربة كالحيوان حتى ينتفخ ولا يجد النَّفس محلًّا.
فإذا ما جاء الليل ونامت أعين الغافلين، قمتَ تناجي ربَّك، وتتحدَّث إليه بكلامه المجيد، ووجدَّت من صيامك النهار أكبر عونٍ لقلبك الصافي ونفسك الزكيَّة، على لذَّة هذه المناجاة وتلاوة آي الذكر الحكيم، ولقيت من ذلك لذَّة، دونها واللهِ كل ملاذِّ الحياة الدنيا، وشهدت عندئذٍ سرِّ جعلِ الله الصيام في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للنَّاس وبيِّناتٍ من الهدى والفرقان، ورأيت من أبواب الفقه والفهم في آيات القرآن، وقطفت من ثماره الدَّانية بصفاء نفسك وطهارة قلبك، وإشعاع روحك، ما ترى منه العجب العجاب، وهذا ـ والله أعلم ـ سرٌّ من أسرار «كان جبريل يدارسني القرآن في رمضان».
وإنَّ ثمرات القرآن وخيراته الحسان ـ واللهِ ـ لا ينالها إلَّا من غلب صفاء قلوبهم وطهارة نفوسهم، على ظلمات حيوانيَّتهم، وشهوات بطونهم وفروجهم. والحيوان الشهواني المظلم ماله وللقرآن وهداه ونوره وفرقانه ورحماته؟ أولئك عنها مبعدون، قلوبهم في أكنِّة ممَّا يدعو إليه، وفي آذانهم وقرٌ، وهو عليهم عمى. نعوذ بالله من ذلك ونسأله العافية.
وهل لك أيُّها الصائم أن تلحظ سرَّ يتيمة العقد في آي الصيام: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} [البقرة: 186]؟
تأمَّلها جيِّدًا ثم ارجع إلى قراءة الآيات من أوَّلها، وقِفْ عند هذه الآية وتمعَّن فيها كثيرًا، فإنَّه سينفتح لك منها سرُّ الصيام، وتشهد منها حكمة الصيام، وأنَّه القرب الحقيقيُّ من الله الذي يقول لك: لا تستصعب الأمر فهو عليك هيِّن ويسر إذا رشدت وهديت، ولا تعبأ بما يُلقى في طريقك من عقبات، فاقتحمها وأسرع إلى ربّك ـ تلقَ ربّك منك قريبًا.
أقدم إلى ربِّك على متن {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} وعلى نور {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}.
واطرح تحت قدمك تلك الخزعبلات والسفاسف الحيوانيَّة التي طالما حشى بها المحجوبون رأسك، وسوَّدوا بها صحفهم، من أنَّ حكمة الصيام أن تتعذَّب النَّفس بألم الجوع والظمأ لتحسّ بحاجة الفقير والمسكين. أُفٍّ لهذا القول، فوالله ما تحسّ نفسٌ تعرف هذا الصيام إلّا إحساس الحيوان الذي يربط في الوتد ويُمنع عن الكلأ والمرعى، فما يكاد يفلت من رباطه حتّى يرتع ويرتع ويرتع إلى أن تمتلئ بطنه فيستلقي في غيبوبة من الوخم والبطنة فلا يعي ولا يعقل، ولا يحسّ بنفسه ولا بفقير ولا مسكين، وما يزداد بالصيام إلَّا حيوانيَّة شرسة، وظلمة فوق ظلمة، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله.
مساكين والله هؤلاء مساكين، ما فقهوا من الدِّين ولا من الطاعة شيئًا، حتى زعموا أنَّ الصلاة وقيام رمضان ما هو إلَّا حركات رياضيَّة لهضم ما ملأوا به بطونهم من الطعام الشراب، فكان ذلك عندهم نقرٌ واسراعٌ وعبث بالصلاة، ولعبٌ بدِين الله، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون. اللَّهم اهدِ قومي فإنَّهم لا يعلمون.
وحين استولت على نفوسهم هذه السخافات والجهالات فأكسبتها ظلماتٍ فوق ظلمات، قالوا في الدِّين بغير علمٍ ولا هدًى، اذ زعموا أنَّ الصيام مع ترك الصلاة ينفع، وصوَّر لهم عبثهم وجهلهم: أنَّ هذا فرض وهذا فرض، وهذا تكليف وهذا تكليف. وهذا حظُّهم من الدِّين إذ أخذوه من غير أصله، واستقوه من حثالة الآراء، وغسالة الأفكار.
أمَّا أنَّهم لو استقوا الدِّين من منبعه الصافي: القرآن والسنة الصحيحة الطيِّبة المباركة لوجدوا أنَّ كلَّ تلك العبادات عقدٌ واحدٌ انتظمت قلب العبد لتوصله إلى ربِّه، وكلّها مرتبطة بالآخر أوثق ارتباط، ومتَّصل به أتمَّ اتِّصال، ومرجعها إلى الصلاة التي يقول فيها الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم: «الصلاة رأس الإسلام» «وعمود الإسلام» «وعلى قدر حظِّ العبد من الصلاة على قدر حظِّه من الإسلام. فمن لاحظَّ له في الصلاة فلا حظَّ له في الإسلام»
وإنَّها هي أوثق الصلات وأقوى عراها بالله سبحانه. فإذا ما انفرط العقد من عندها فمحالٌ أن ينتظم من أيّ ناحية سواها أيّ محال، ومهما حاول وموَّه الذين لا يفهمون إلا ظواهر القول وقشور الكلام.
فيا أيُّها الذين آمنوا وثِّقوا رباط قلوبكم بالله حق التوثيق و{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
وافتحوا أبواب القرب من الله على مصاريعها في شهركم هذا بالصوم، وأجدّوا فيه قلوبكم وإيمانكم بتلاوة القرآن، والتخلق بخلق القرآن، والتأدب بأدب الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم وما كان أدبه إلَّا القرآن، ولا تضيِّعوا على أنفسكم هذه الفرص السعيدة، فالمحروم في الدنيا والآخرة من ضيَّعها. ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق.
الشيخ محمد حامد الفقي (ت: 1378) رحمه الله
«مجلة الهدي النبوي» الصادرة عن جماعة أنصار السنة المحمدية، السنة الأولى، العدد السادس، الصفحة 24-30، الصادرة بتاريخ: رمضان سنة 1356، الموافق لشهر نوفمبر سنة 1937م، الناشر: مكتبة منار التوحيد للنشر، المدينة النبوية، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1/24-30.