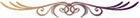
الأركان (أو الدعائم أو القواعد أو الأعمدة) الخمس
المقصودة للشَّارع والموضوعة لإقامة الدِّينِ
(الشهادتان ـ الصلاة ـ الزكاة ـ الصيام ـ الحج)
عن ابن عُمَرَ: أنَّ رجلًا قال لهُ: أَلَا تَغْزُو؟ قال: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: «بُنِيَ الإِسلامُ على خَمْسٍ: شَهادةِ أنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ، وإقَامِ الصَّلاةِ، وإِيتاءِ الزَّكاةِ، والحجِّ، وصيَامِ رمضانَ». أخرجه الخمسة إلا أبا داود.
قوله عليه السلام: «بُنِيَ الإِسلامُ على خَمْسٍ» هكذا بتذكيرِ العددِ لتأْنيثِ المعدودِ، أي: خمسُ دعائمَ أو قواعدَ وفي روايةٍ: «على خمسةٍ» أي: خمسةِ أركانٍ أو أعمدةٍ مثلاً. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام خمسٌ أو مؤلَّف مِنْ خَمْسٍ، لأَنَّ معنى «الإسلام» ها هُنا هو الانقيادُ الظَّاهر لجميعِ أوامرِ اللهِ أصولًا وفروعًا، وهذا لا ينحصرُ في الخمسِ المذكورةِ، بل هو كما في «الصَّحيحِ» بضعٌ وسبعونَ شُعْبةً أعلاها قولُ: «لا إله إلا الله» وأدناها إماطةُ الأذى عن الطَّريقِ. فَلِذا قال: «بُنيَ على خَمْسٍ» أي: إنَّ هذه الخمس هي منه بمنزلة الأساس من البُنيان، وباقي شُعبِه بمنزلةِ البنيانِ القائمِ على هذا الأساس. فكأنَّه مَثَّلَ الإسلامَ بذلك الفُسطاط الذي يقيمُه البدويُّ على خمسةِ أعمدةٍ منها أربعةٌ قصيرةٌ في الأطرافِ وواحدٌ أعلى في الوسط هو قُطْبُ رَحَاها، بحيثُ لو سقَط هذا العمودُ الأوسطُ سقَط الفُسْطاطُ وزالَ عنه اسمُ البيتِ وصورتُه بالكلِّيةِ، وإذا سقط شيءٌ من الدعائم الجانبيةِ لم يذهبْ عنه الاسمُ ولم تبطل منه المنفعةُ وإنما تنقصُ بمقدار ما يسقط من تلك الدَّعائم وإذا بقيت الأَعمدةُ كلُّها قائمةً، ولكن لم يُبْسَطْ عليها ذلك النسيجُ من الشَّعْرِ أو غيرُه كانت كالهيكلِ العظميِّ المجرَّدِ من اللحمِ والدَّمِ والعَصَبِ أو كالطَّللِ الباقي من الدِّيار. فكذلك الإسلام: دعامتُه الوُسطى هي «الشهادتان». وأوتادُه هي: الأركان الأربعةُ: «الصَّلاةُ» و«الزكاةُ» و«الصِّيامُ» و«الحجُّ». وما وراءَ ذلك من واجباتٍ وآدابٍ بها تُحْفَظُ صورةُ الإسلامِ ورونقُهُ كالأَغطيةِ والأستارِ التي تُشَدُّ على تلك الأعمدةِ.
وإنما خُصَّتِ الفروعُ الأربعةُ المذكورةُ في الحديثِ فَجُعِلَتْ مُلْحَقَةً بالأُصولِ والأُسس التي يُبنى عليها الدينُ وجُعلَ ما عداها من شُعب الإسلامِ فروعًا له ومكملاتٍ لأنها هي أعظمُ المظاهرِ وأوضحُ العناوينِ على الإيمان بهذا الدِّين من حيثُ هو دينٌ سماويٌّ، لما فيها منَ الاستسلامِ والانقيادِ الظَّاهر لأمر الله لِمُجَرَّدِ أمْرِهِ لا قصدًا إلى مصلحةٍ عاجلةٍ من المصالح العامة أو الخاصة. وما عداها من الأعمال ليست لها هذه المنزلة من الدلالة على انتماءِ صاحبها لهذا الدين.
ذلك أن الفروع الدِّينيةَ منها ما هو بَاطِنيٌّ لا اطِّلاعَ لنا عليه، كالإخلاص والتَّوكُّل والرِّضا ومحبَّة الخير للغير، وسائر ما يبحث عنه علم الأخلاق، وهذا القسم لا يصلح شعارًا وعلامةً ظاهرةً للمسلمين، فضلاً عن أن يكون أساسًا لتلك الشعائر والعلامات.
والقسم الظَّاهريُّ في الشَّريعة أنواعٌ:
فمنها: ما يرجع إلى المصالح التي تقتضيها الفطرة؛ كوسائل المحافظة على الشخص أو النوع من النَّظافة والستر، وطلب الرزق وابتغاءَ النَّسْل من طريقٍ شريفٍ، والجهاد دفاعًا عن النَّفْسِ أو العِرْضِ أو الحقِّ كيف كان، ونحو ذاك.
ومنها: ما يرجع إلى المصالح التي تدركها العقول، وتهدي إليها التجارب، كقوانين المعاملات وآداب الاجتماع، من الصدق والوفاءِ بالعهد، والإقساط في المعاملة، وبذل المعونة للمحتاجين، والدَّعوة إلى الخير وَكَفِّ يد المفسدين ـ وهذان النوعان ـ لا يُعَدُّ الاستمساك بهما دليلاً على إسلام صاحبهما، إذ كثيرًا ما نرى من المتمسكين بهما من هو على دينٍ باطلٍ أو لا دينَ له أصلًا. ذلك لأنَّ في باعث الفطرة السليمة أو العقل السليم ما هو داعٍ إليهما كدعاءِ باعث الدين.
بقي قسم العبادات، وأعني بها الأُمور التَّعَبُّدِيَّةَ التي لها رسومٌ وأوضاعٌ دينيةٌ خاصةٌ لا تهدي إليها الغرائز ولا العقول، كالصلاة المحدودة بأوقاتها وأعدادها وهيئاتها، وكالزكاة المحْدُودَةِ بأنواعها ونصابها ومقاديرها ومواقيتها، وكالصِّيام المحدود بزمانه وكيفيَّته، وكالحجِّ كذلك، وكالأضاحي والكفَّارات ونظام التَّوارث والعُقُوبَاتِ المحددة المسماة بالحدود، ونحو ذلك من الأُمور التي لا حَظَّ للاجتهاد في وضعها، ولا في تبديلها وتغييرها مهما تَغَيَّرَتِ الأحوال والعصور، فهذه الأُمور جديرةٌ بأن تُسمَّى رموزًا دينيَّةً وشعائر إسلاميةً، لأنَّها لا يتعاون فيها مع باعث الدين باعثٌ آخر من غَرَائِزِ النُّفوس ولا هداية العقول. ولذلك لا يشارك المسلمين فيها أَهل دينٍ آخر بصورتها الوضعية في الإسلام. لكن منها ما ليس بواجبٍ قَطْعِيٍّ عينًا، كالضحايا.
ومنها: ما لم يُقْصدْ وضعُه ابتداءً بل عُلِّق على وقوع شيءٍ من المخالفة لتعاليم الدين، كالحُدُودِ والكفَّارات، على أن الحدود ونظام الميراث وإن كانا تَعَبُّدِيَّيْنِ إلا أنهما من الأُمور الموضوعة لإقامة مصالح الدنيا بالقصد الأول، فقد يأخذ بهما من ليس على هذا الدين لما فيهما من المناسبة للعقول.
فلم يبق من فروع الدِّين ما يصلح أن يكون أساسًا لشعائر الدِّين سوى الأركان الأربعة المذكورة في الحديث لأنها شعائرُ ظاهرةٌ، خاصةٌ بهذا الدين، واجبةٌ وجوبًا عينيًا، مقصودةٌ للشَّارع قصدًا أوليًا، موضوعةٌ لإقامة مصالح الدِّينِ أولًا وبالذات، ومصالح الدنيا ثانيًا وبالعرض. فلذلك كانت لها الصدارة على سائر الفروع حتى نُظِمَتْ مع الأصل الذي هو مبدأُ الإسلام، في سلكٍ واحدٍ وصارت القواعد خمسًا.
ومن بديع الحكمة الإلهية في التَّشريع أن جَعَلتْ هذه القواعد الخمس ضروبًا:
منها: ما هو ماليٌّ بحتٌ كالزكاة.
ومنها: ما هو بدنيٌّ بحتٌ، إما قوليٌّ كالشهادتين، أو فعليٌّ كالصِّيام، أو قوليٌّ وفعليٌّ معًا كالصَّلاة.
ومنها: ما هو جامع للماليِّ والبدنيِّ والقوليِّ والفعليِّ كالحجِّ. فكانت متناولةً لضروب الابتلاءِ في الأبدان والأموال والأقوال والأفعال والتروك لتكون نموذجًا لسائر التَّكاليف، ويكون العمل بها علامةً على امتثال كافَّةِ المأمورات واجتناب كافَّةِ المنهيَّات.
أما ترتيب هذه القواعد فقد ورد في هذه الرواية بتقديم الحج على الصوم.
وورد في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه قال: «وصِيَامِ رَمَضَانَ وحَجِّ البَيْتِ» فقال له رجل: «والحَجِّ وصَوْمِ رَمَضَانَ»، فقال ابن عمر: «لا. صِيَامِ رَمَضَانَ والحَجِّ». هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالذي ينبغي التَّعويل عليه هو الرِّواية التي شهد ابن عمر بسماع لفظها، نعم (الواو) لا تفيد ترتيبًا، وروايةُ الحديث بالمعنى جائزةٌ عند المحققين، ولكن الرِّواية التي صرَّح ابن عمر بسماعها قد روعي فيها أمرٌ معنويٌّ يُعْنَى به المؤَرخُ للتَّشريع الإسلاميِّ. وذلك أن ترتيب القواعد الخمس في الوضع اللفظيِّ جاء على وفق ترتيبها الزمانيِّ في التشريع. فإن الدعوة إلى الشهادتين كانت أول الجميع منذ مَبْدَإِ البعث في (مَكَّة)، ثم تبعها فَرْضُ الصلوات الخمس قبل الهجرة. ثم فَرْضُ الزكاة وصيام رمضان كلاهما في السنة الثانية من الهجرة. ثم فَرْضُ الحج في السنة السادسة أو التاسعة من الهجرة على الخلاف.
ومعنى آخر يلاحظه عالم الشريعة في هذا الترتيب المحْفُوظِ وهو: أنه قد جيءَ بالأركان الخمسة مرتبةً على حسب منزلتها من عناية الشارع، وعلى حسب ما يستحق تاركها من العقوبة المقرَّرة في الشريعة.
فإنَّ مُنكِرَ الشهادتين إذا قوتل يُقْتَلُ كفرًا.
وتارك الصلاة يُقْتَلُ أيضًا لكنه يُقتلُ حدًا على قول الجمهور، أو كفرًا على قول بعض الأئمة.
ومانع الزكاة لا يُقْتَلُ قَصْدًا بل يُقاتَلُ عليها حتى يُؤدِّيَها.
وتارك الصَّومِ لا يُقْتَلُ ولا يُقَاتَلُ بل يُؤدَّبُ ويُعزَّرُ بالسجن والضرب ونحوهما مما يراه الحاكم.
وتارك الحج يُفَوَّضُ أمره إلى الله تعالى لأنه منوطٌ باستطاعةٍ خاصةٍ، وقد يخفى أمر هذه الاستطاعة على الناس، فَرُبَّ رجلٍ ظاهره الملَاءُ والقدرة وهو فقيرٌ عاجزٌ.
ذلك كلُّه لمن ترك شيئًا من الأركان الأربعةِ كسلًا وإهمالًا وهو معترفٌ بوجوبها. وأما من ترك شيئًا منها جحدًا لوجوبه، أو إنكارًا لمشروعيَّته فإنه يُقْتَلُ كُفرًا، كَكُلِّ من جحد أمرًا معلومًا بالضرورة من الدين.
الشيخ محمد عبد الله دَراز (ت: 1958م) رحمه الله، «المختار من كنوز السُّنّة النبوية» ٢٠٩-٢١٥. تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري.