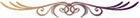
بقلم العلامة محمد الخضر حسين (ت: 1377) رحمه الله
لو سُئل الذين أوتوا الحكمة وفصل الخطاب، أن يشرِّعوا للناس طرائق تكون لهم أجمل مكان يستشرفون منه على حقيقة العدالة والأخلاق الكاملة، وحدودًا تلم لهم بحفظ الحقوق الإنسانية، تتناولهم إصلاحاتها ما تداولت الأيام، وتضم عليهم أزرارها أينما سكنوا، لضلت عليهم أنباؤها، وعثرت عقولهم في ذيل الحصر، وإن اجتمعوا على صعيد واحد وكان بعضهم لبعض ظهيرًا.
إن البشر مهما اتسعت مداركهم، وسمت أفكارهم، لا يمكنهم الإحاطة بمطالب الحياة الاجتماعية والتوصل إلى كل ما يحتاجه الإنسان في وجوده المدني، لأن العقل الذي امتازوا به عن سائر الحيوان، وصاروا به معدن العلم ومركز الحكمة، غايته معرفة كليات الأشياء دون الاطلاع على جميع جزئياتها، فلا يكاد يدرك كل مصلحة مصلحة، ويتصور كل مفسدة مفسدة، نحو أن يعلم حسن اعتقاد الحق وحسن استعمال العدالة وملازمة العفة، لكنه قد يخفى عليه أن اعتقاد كذا حق، وفعل كذا من العدالة، وترك كذا من العفة، كمثل الفقيه، يعلم أحكام الحوادث الكونية، وليس له قوة فائقة في إعطاء الوقائع حكمها الواجب لها، أو مثل الطبيب يعلم الأدوية وخواصها، وليست له مهارة في علاج كل مرض بما يلائمه، وهو المسمى بالتطبيق، ومن أجل ذلك لم يكتف به الإله جلّ وعز في إقامة الحجة على الناس، بل عذر أهل الفترات في عدم اهتدائهم، فقال تعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 165]، وقال: {وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى} [طه: 134]، وقال: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [لإسراء: 15].
فلا جرم أن السياسة العادلة لا تأخذ منتهى غايتها إلا باستناد أحكامها إلى من أحاط بكل شيء علمًا، ولو اطلعت على التواريخ العتيقة والحديثة، ودرستها درسًا مدققًا، لملئت يقينًا وازدت إيمانًا مع إيمانك بذلك الحق الذي هو أوضح من محيَّا النهار، ولا يرتاب فيه إلا ذو بصيرة غشيها غبار الغباوة، فلم تنعكس أشعة الحقائق في مرآتها.
فكَّر «سولون» متشرع أثينا ليسنَّ في قومه قانونًا يقشع عنهم ظلمات ما هم فيه من البغي، ويحول بينهم وبين كل جناية، فخطر على باله أن يقرع أسماعهم بروعة القانون، فشدد عليهم إصر العقوبة بتقريره القتل جزاء لكل جريمة صغيرة كانت أو كبيرة.
خفي على هذا الفيلسوف، أنَّ جعل القتل عقوبة ولو على الكذبة الواحدة، فضلاً عما فيه من الإفراط في الحكومة والنقص من الأنفس، هو من الانحرافات المفضية إلى قتل الهمم وغمس القلوب في صبغة الجبن والخوف، ولن تفلح أمة كُسيت بكسوة الفزع والذلة أبدًا.
وأخذت «أفلاطون» وريث «سقراط» الرأفة بقومه من أن تتسرب إليهم العدوى بالأخلاق الفاسدة من الأجانب، فقرر أن تغلق أبواب بلاده أمامهم، ولم يُحسن السياسة في ذلك لجملة أسباب، منها أن الأمة إنما تحفظ استقلالها الذاتي بالتيقظ لنوايا الأمم الأخرى، والتخرص على حركاتها الخفية، ومثل ذلك لا يحصل إلا بمداخلتهم وتبادل المعلومات معهم.
ومن جملة غلطات هذا الفيلسوف، أنه عمد إلى القطب الذي تدور عليه ترقيات الشعب وهي «التجارة» فرمقها بعين الاحتقار، لما دار في حسبانه أنها من المهن الخسيسة، فقرر في قانونه أن يعاقب كل يوناني تطمح نفسه إلى استدارة دولابها.
وظنَّ «أرسطو» أبو الفلسفة أن جميع الحرف والصنائع من الدنايا السافلة، فقرر في شريعته أن يعامل كل من يتعاطاها بحرمانه من الحقوق الوطنية، فمثل هاته القوانين لو تمسكت بها أمة ولو بضعة أيام لسقطت في دركات الشقاوة السفلى.
ذلك التشريع الذي يحمل على المناهج السوية، ويتكفل بتحديد الحقوق الإفرادية والاجتماعية، لا يتوغل في مناحيه العميقة، ويوضح ما دق من مشاكله الغامضة، إلا الدين الذي هو وضعٌ إلهيٌّ يسوق الناس باختيارهم إلى الانتظام في أعمالهم الدنيوية والتأهل للزلفى من الله في الحياة الأبدية، وإن له عند الرجل العظيم لصولة موهوبة وسلطنة مقدسة، يخر لها صعقًا، ولا تبغي نفسه الكريمة عن السكون تحتها حولاً، لكنه عند هزيل العقل عريض الوسادة عسير الاتباع.
نريد للرجل العظيم من كمل اطلاعه على أحكامه الفرعية، وأبعد فيها نظره إلى أن رآها كيف انتزعت من مداركها الأصولية، فتوفرت في نفسه الثقة بأن الدين حكم عدل، لا يحسن في الخليقة غير آثار تدبيره.
وما هو عريض الوسادة؟
عريض الوسادة كل من يتميز إلى الفئة التي انتقضت في مستنقع الجهالة أمدًا مديدًا، ثم قاموا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ليتجردوا من أثواب الديانة المحكمة، ويستعوضوه بلباس الحرية المطلقة {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} [البقرة: 16]. إن إطلاق التصرف للإنسان يعمل ما شاء، وتخلية سبيله يعتقد ما سنح له، وعدم ارتباطه في ذلك بالأوضاع الدينية، لمفسدة كبرى تعم الأفراد في أشخاصها والأمم في اجتماعها.
واعتبر في ذلك بحال العرب في الجاهلية، حين كانوا أوزاعًا في مذاهبهم وأخيافًا في وجهاتهم، كل يعمل على نفاذ داعيته، لا رادع من الدين يرد شكيمتهم، ولا سبيل لسلطة غالبة على كبح جماحهم، يتبين لك أن الحرية المطلقة والهمجية المقلقة أخوان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ثم حوَّل نظرك إلى زمن الرسالة، وعصر الخلفاء الراشدين، فلا تجد سببًا امتد بالإِسلام في أَطراف الأرض، فاستوثق لهم ملك متماسك العرى غير إجرائهم لتلك المبادئ التي أركزها الوحي في عقولهم.
قال قائل من الذين يريدون أن ينفذوا من أقطار الشريعة المباركة: «ما لبعض شعائرها لا يعقل له معنى».
قلنا «عَدْس»([1]) لم يجعل الله لأحداث السفاهة على ذوق أسرار شريعته سبيلاً، إن تكاليف الشرع على نوعين: عبادات وعادات، أما قسم العادات: وهو ما تقوم به قوانين العمران في هذه الحياة الدنيا، فقد توسع الشارع في بيان علله وحكمه الخاصة صراحة أو رمزًا كقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة: 179]، وقوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ} [المائدة: 91] الآية. وفي الحديث: «لا يقضي القاضي وهو غضبان». وقال: «القائل لا يرث» إلى غير ذلك.
وأما ما كان من قبيل العبادات، كالصلاة والصوم والحج، فالأصل فيه بالنسبة إلى المكلف التعبد، وحكمته العامة الانقياد لأوامر الله تعالى، وإفراده بالخضوع والتعظيم، وقد يبين له الشارع علة خاصة، لكن التقرب إلى الله تعالى بما لم يطلعنا على حكمته، أدل على كمال العبودية له والإخلاص في التوجه إليه، لأن الإتيان بالقربات التي أدركنا حكمتها المناسبة، لا يخلو عن شائبة القصد إلى المصالح المترتبة عليها، وهو وإن لم يكن محبطًا بعملها يهضم شيئًا قليلاً من خلوصها؛ فإن قال غير متشرع: لماذا كانت صلاة الظهر أربع ركعات وصلاة المغرب ثلاثًا؟
فألقم فاه بحجر هذه النكتة الحكمية، وإن قاله متشرع، قلنا له: الله ورسوله أعلم.
المصدر: مجلة (السعادة العظمى) التي أصدرها الشيخ محمد الخضر حسين في تونس، العدد السابع عشر ـ الصادر في غرة رمضان المعظم 1322، كما في (موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين)، جمعها وضبطها: المحامي علي الرضا الحسيني، دار النوادر، دمشق، الطبعة الأولى، 1431/2010، مجلد (السعادة العظمى)، 12/2/97 – 101.