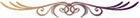
{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا} [سورة الإسراء، الآية:18].
كل الناس في هذه الحياة حارث وهمام: عامل ومريد، فسفيه ورشيد، وشقي وسعيد.
منهم من يريد بأعماله هذه الدار العاجلة والحياة الدنيا، عليها قصر همه، وعلى حظوظها عقد ضميره. وجعلها وجهة قصده، ونصبها غاية سعيه، لا يرجو وراءها ثوابًا، ولا يخاف عقابًا، فهو مقبلٌ عليها بقلبه وقالبه، معرض عن غيرها بكليته، فلا يجيب داعي الله بترغيب ولا ترهيب، ولا يتقيد في سلوكه بشرائع العدل والإحسان.
فمن كانت هذه إرادته، وهذا عمله، عجل الله له في الدنيا ما مضى في مشيئته تعالى أن يعجله له، إن كان ممن أراد التعجيل لهم، بحكم إبدال الجار والمجرور في قوله: {لِمَنْ نُرِيدُ}، من الجار والمجرور في قوله: {عَجَّلْنَا لَهُ}.
فالتعجيل منه تعالى لمن يريد، لا لكل مريد، والشيء المعجل ـ في قدره وجنسه ومدته ـ على ما يشاء الرب المعطي، لا على ما يشاء العبد المريد. فكم من مريدي الدنيا من يقصد الشيء فلا ينال إلا بعضه، فيضيع عليه شطر عمله، فلا في هذه الدار ولا في تلك الدار. وكم منهم من سعى واجتهد وانتهى بالخيبة والحرمان، فعاد ـ بعد النصب ـ ولا ثمرة حصلها عاجلًا، ولا ثوابًا ادخره آجلًا، وذلك هو الخسران المبين. ثم إذا قدم على الله في الآخرة جعل له وحضر له جهنم دار العذاب، واضطره إلى دخولها فيصليها. مذمومًا: مذكورًا بقبح فعله وسوء صنيعه في قلة شكره لربه، وعدم استعماله لما كان أنعم عليه به في طاعته، وعدم نظره لعاقبة أمره. مدحورًا: مبعدًا في أقصى النار مطرودًا من الرحمة. حرم نفسه من استثمار رحمة الله في الدنيا بالشكر عليها، فكان عدلًا أن يحرم منها في الاخرة. ونظير هذه الآية آية (الشورى): {وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ} [الشورى: الآية 20].
عمل للدنيا فنال نصيبه منها، ولم يعمل للآخرة فلم يكن له نصيب فيها.
والتقييد بـ(مِنْ) في قوله تعالى: {مِنْهَا} على أن ما يناله ـ سواء كان كل ما أراد أو بعضه ـ ما هو إلا بعضه من الدنيا. وإذا كانت الدنيا كلها شيئًا زهيدًا بقلتها وفنائها ونغصها بالنسبة لأقل شيء من نعيم الآخرة ـ فما بالك بما هو بعض منها؟
فلقد خاب وخسر من استبدل بنعيم الآخرة هذا القليل الخسيس المنغص الزهيد.
ونظيرها أيضًا آية (هود): {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16)} [هود: الآية 15- 16].
وتوفيتهم أعمالهم إنالتهم ثمراتها مكملة في الدنيا.
وهم فيها لا يبخسون: لا ينقصون من جزائهم عليها بتحصيل المسببات التي توسلوا إليها بأسبابها.
ثم في الآخرة تحبط تلك الأعمال فلا يكون عليها من جزاء ولا لها من ثمرة، لأنها كانت أعمالًا باطلةً لا ثبات لها، عمل للدنيا دار الزوال فزالت بزوالها، وبقي على عمالها إثم عدم شكرهم لربهم فدخلوا به النار. وتلك عاقبة الظالمين.
غير أن هاتين الآيتين مطلقتان في الشيء المعطى والشخص المعطى له، وآية «الإسراء» مقيدة بمشيئة الله تعالى وإرادته فيهما. والمطلق محمول على المقيد في البيان والأحكام.
وقد أفادت هذه الآيات كلها، أن الأسباب الكونية التي وضعها الله تعالى في هذه الحياة وسائل لمسبباتها، ـ موصلة ـ بإذن الله تعالى ـ مَن تمسك بها إلى ما جعلت وسيلة إليه، بمقتضى أمر الله وتقديره، وسننه في نظام هذه الحياة والكون. ولو كان ذلك المتمسك بها لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يصدق المرسلين.
ومن مقتضى هذا أن من أهمل تلك الأسباب الكونية التقديرية الإلهية، ولم يأخذ بها لم ينل مسبباتها ولو كان من المؤمنين، وهذا معلوم ومشاهد من تاريخ البشر في ماضيهم وحاضرهم.
نعم، لا يضيع على المؤمن أجر إيمانه، ولكن جزاءه عليه في غير هاته الدار، كما أن الآخر لم يضع عليه أخذه بالأسباب، فنال جزاءه في دار الأسباب، وليس له في الآخرة إلا النار.
أقسام العباد:
فالعباد ـ إذًا ـ على أربعة أقسام:
1- مؤمن آخذ بالأسباب الدنيوية، فهذا سعيد في الدنيا والآخرة.
2- ودهري تارك لها، فهذا شقي فيهما.
3- ومؤمن تارك للأسباب، فهذا شقي في الدنيا وينجو ـ بعد المؤاخذة على الترك ـ في الآخرة.
4- ودهري آخذ بالأسباب الدنيوية، فهذا سعيد في الدنيا، ويكون في الآخرة من الهالكين.
فلا يفتنن المسلمون بعد علم هذا ما يرونه من حالهم وحال من لا يدين دينهم. فإنه لم يكن تأخرهم لإيمانهم، بل بترك الأخذ بالأسباب الذي هو من ضعف إيمانهم. ولم يتقدم غيرهم بعدم إيمانهم، بل بأخذهم بأسباب التقدم في الحياة. وقد علموا أنهم مضت عليهم أحقاب وهم من أهل القسم الأول بإيمانهم وأعمالهم. وما صاروا من أهل القسم الثالث إلا لما ضعف إيمانهم وساءت أعمالهم وكثر إهمالهم ... فلا لوم إذًا إلا عليهم في كل ما يصيبهم، وربك يقضي بالحق وهو الفتاح العليم.
{وَمَنْ أرادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِن فأولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً} [الإسراء: الآية 19].
وهذا قسم آخر من الخلق، قصد بعمله الآخرة وإياها طلب، وثوابها انتظر، يرجو أن يزحزح فيها عن النار ويفوز بالجنة، ويحل عليه الرضوان، فهذا كان سعيه مشكورًا بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يقصد بعمله ثواب الآخرة قصدًا مخلصًا. كما يفيده فعل الإرادة في {وَمَنْ أرادَ الآخِرَةَ} ولام الأجل في {وَسَعَى لَهَا}.
الشرط الثاني: أن يعمل لها المعروف في الشرع اللائق بها، الذي لا عمل يفضي إلى نيل ثوابها سواه، وهو طاعة الله تعالى وتقواه بامتثال أوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده.
الشرط الثالث: أن يكون مؤمنًا موقنًا بثواب الله تعالى وعظيم جزائه.
فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة لهم {كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا} متقبلًا مثابًا عليه بحسن الثناء وجميل الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة {وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: الآية 261].
وإذا اختل واحد منها فليس العمل بمتقبل ولا بمثاب عليه بضرورة انعدام المشروط بانعدام شرطه.
وفي هذه الشروط مباحث:
المبحث الأول:
أن قصد الثواب والجزاء على العمل لا ينافي الاخلاص فيه لله: لأن الإخلاص هو أن تجعل عبادتك لله وحده. ورجاؤك الثواب وطمعك فيه، وحذرك العقاب وخوفك منه: هما مقامان عظيمان لك في جملة عبادتك. يجب عليك أن تكون فيهما أيضًا مخلصًا، لا ترجو إلا ثوابه، ولا تخاف إلا عقابه. وإذا أخلصت في رجائك وخوفك هانت عليك نفسك، فقمت في طاعته مجاهدًا، لا يردك معارضٌ، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وصغرت في نظرك العوالم فنطقت بقولك «الله أكبر» نطق عالم واجد مشاهد.
والمقصود: أن رجاء الثواب، وخوف العقاب، روحهما الإخلاص، فكيف ينافيانه؟
فالعامل الراجي للثواب، الخائف من العقاب، المخلص في الجميع آت بأربع عبادات: عمله، ورجائه، وخوفه، وإخلاصه، وهو روح الجميع. وقد جاء في القرآن ثناء شيخ الأنبياء إبراهيم الخليل عليه وعليهم الصلاة السلام هكذا: {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ} [الشُّعراء: الآية 82].
وذكر تعالى دعاء عباد الرحمن الصالحين هكذا: {رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا} [الفرقان: الآية 65].
وفي دعاء القنوت: «نرجو رحمتك، ونخاف عذابك الجد»([1]).
إلى غير هذا من أدلة كثيرة تؤيد ما ذكرناه.
المبحث الثاني:
أفاد هذا الشرط أن من لم يرد الآخرة لم يكن سعيه مشكورًا.
وفي هذا تفصيل لأن العامل إما أن يكون في عبادته لم يرد بها الآخرة أصلًا، بل أراد بها شيئًا دنيويًا من محمدة الخلق أو استفادة شيء أو تحصيل منفعة العمل. أو أراد الآخرة، وشيئًا مما ذكر شركة متساوية أو متفاوتة. وإما أن يكون في عمل عادة لم يرد بها الآخرة أصلًا بل أراد الغرض الدنيوي، أو أرادهما معًا، والدنيوي وسيلة للأخروي.
فهنالك ـ إذًا ـ أقسام:
القسم الأول:
العامل في أمر تعبدي كالصلاة والصدقة والحج والعلم، فهذا إذا لم يرد الآخرة أصلًا فهو موزور غير مشكور.
وفيه جاء حديث أبي هريرة في «الصحيح» قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدتُ. قال: كذبتَ، ولكنك قاتلتَ لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
ورجل تعلم العلم وعلَّمه، وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فماذا عملت فيها؟ قال: تعلَّمتُ العلم وعلَّمته، وقرأتُ فيك القرآن. قال: كذبتَ، ولكنك تعلَّمت العلم ليقال عالم، وقرأتَ القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
ورجل وسَّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملتَ فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبتَ، ولكنك فعلتَ ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار»([2]).
وهذا الذي كان من هؤلاء هو الرياء وهو: أن يفعل العبادة ليقال إنه مطيع.
وما دخل الرياء في عبادة إلا أحبطها، ولو كان قليلًا؛ لحديث أبي هريرة في «الصحيح»، قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشِّرْك، من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركتُه وشِركَه»([3]).
وإشراك غيره معه صادق بالقليل والكثير، فلا فرق بينهما في الإحباط. والعامل المرائي موزور غير مشكور.
القسم الثاني:
العامل في العبادة الذي يقصد بها ثواب الآخرة وشيئًا آخر من أعراض الدنيا «كالرجل يبتغي الجهاد وهو يريد من عرض الدنيا». وقد سئل النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن هذا فقال: «لا أجر له». رواه أبو داود وابن حبان.
وعلى وزانه نقول: من قصد الهجرة والتزوج بامرأة معًا أو قصد الوضوء والتبرد، أو قصد الصوم والحمية ـ وإن صحت عبادته لأن الصحة تتوقف على نية القصد، والثواب يتوقف على نية الإخلاص ـ لا أجر له. هذا إذا سوى ما بينهما في القصد كما هو ظاهر لفظ الحديث.
وأما إذا كان الغالب هو قصد العبادة، فالظاهر أنه له من الأجر بقدر ما غلب من قصده.
القسم الثالث:
العامل في العبادة الذي يكون قصده إلى ثواب الآخرة، وما عداه من منافع تلك العبادة ملحوظ له على سبيل التبع لها، من حيث إنه مصلحة شرعية معتبرة في التشريع.
والأحكام الشرعية المعللة بفوائدها في الآيات والأحاديث لا تحصى كثرة، ومنها في الحج: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: الآية 28]. ومن منافع الحج الحركة الاقتصادية لخير تلك البقاع ومصلحة أهلها وغزارة عمرانها، ولذا قال تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: الآية 198].
والفضل هو الاتجار في مواسم الحج([4]).
فكل منفعة تجلبها عبادة أو مضرة تدفعها، فملاحظتها عند قصد العبادة لا تنافي الإخلاص ولا تنقص من أجر العامل، وهي مثل الثواب المرتب على العمل. هي في الدنيا وهو في الآخرة، وكلاهما من رحمة الله التي نرجوها بأعمالنا، ويشملها لفظ دعاء القنوت: «نرجو رحمتك» إذ هو تبارك وتعالى رحمان الدنيا والآخرة ورحيمها.
القسم الرابع:
العامل لعمل عادي دنيوي من أكل وشرب ونوم وجماع ونحوها، فهذا إذا قصد بعملها النفع الدنيوي، ولا قصد له في الثواب، فهو غير مأجور ولا مأزور.
وهذه هي حالة أهل الغفلة والجهل.
القسم الخامس:
عامل الأعمال العادية الذي يتناولها بنية كونها مباحًا تناولها شرعًا، ويقصد بها التوسل إلى ما يتوقف عليها من أعمال واجبة ومندوبة، وإلى الانكفاف بها عن المحرمات والمكروهات، كمباضعة زوجته للقيام بواجب حقها، وكف نفسه وكفها، وكالنوم ليقوى على العبادة، والرياضة ليصح للطاعة، فهذا مثاب وسعيه مشكور، وله ما نوى.
وبهذه السبيل يستطيع العبد الموفق أن تكون حركته وسكناته كلها لله، وفي طاعته. دائم الذكر له يعبده كأنه يراه، لأن من كان يعبد كأنه يرى مولاه، لا يمكن أن يغفل عنه قلبه ويشتغل بسواه، حتى إذا اشتغل بشيء كان بإذنه ورضاه، فلم يخرج في أيٍّ عن حضرة قدس الله.
ومن أدلة هذا قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم: «وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر».
المبحث الثالث:
من الناس من يخترع أعمالًا وأوضاعًا من عند نفسه ويتقرب بها إلى الله، مثل ما اخترع المشركون عبادة الأوثان بدعائها، والذبح عليها، والخضوع لديها، وانتظار قضاء الحوائج منها، وهم يعلمون أنها مخلوقة لله مملوكة له، وإنما يعبدونها ـ كما قالوا ـ لتقربهم إلى الله زلفى.
وكما اخترع طوائف من الهنود أنواع التعذيب بقتل أنفسهم وإحراقها طاعة ـ زعموا ـ وتقربًا!.
وكما اخترع طوائف من المسلمين الرقص والزمر، والطواف حول القبور والنذر لها، والذبح عندها ونداء أصحابها، وتقبيل أحجارها، ونصب التوابيت عليها، وحرق البخور عندها، وصب العطور عليها.
فكل هذه الاختراعات فاسدة في نفسها، لأنها ليست من سعي الآخرة الذي كان يسعاه محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وأصحابه من بعده، فساعيها موزور غير مشكور.
المبحث الرابع:
شكر الرب لعبده هو جزاء شكر عبده له، وإنما يكون العبد شاكراً لربه إذا كان عاملاً بطاعته مؤمنًا به؛ فإذا انعدم الايمان لم يتصور شكران، وهذا مستفاد من قوله تعالى: {وَهُوَ مُؤْمِنٌ}.
وأفادت الجملة الإسمية ثبوت الإيمان ورسوخه حال العمل، وعلى قدر ثبوت الايمان ورسوخه يكون الثبات والدوام على الأعمال. فالمؤمن بالله يعمل موقناً برضاه، موقنًا بلقائه وعظيم جزائه، فهو يعمل ولا يفشل، وسواء عليه أوصل إلى الغاية التي يسعى إليها أم لم يصل إليها، حال بينه وبينها موانع الدنيا أو مانع الموت، كانت مما تجنى ثماره في جيله أو لا تجنى ثماره إلا بعد أجيال.
فأفادت الجملة المذكورة شرط القبول للعمل. وسر الدوام عليه، والمضي بغبطة وسرور فيه.
إمكان العمل بالآية لجميع المسلمين:
خاتمة:
إن المسلمين كلَّهم ـ والحمد لله ـ أهل إيمان، فليستشعروه عند جميع الأعمال، ولا يخلون من عمل لمعاشهم أو لمعادهم، فليقصدوا بذلك كله وجه الله، وامتثال أمره وحسن جزائه، وليقتصروا في عبادتهم على ما ثبت عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ليكونوا على يقين من موافقة رضى الله وسلوك طريق النجاة.
فإذا فعلوا هذا وصمدوا إليه وجاهدوا أنفسهم في حملها عليه، كانوا شاكرين مشكورين على تفاوتهم في منازل العاملين عند رب العالمين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل([5]).
[1]) جزء من دعاء القنوت الثابت عن عمر رضي الله عنه، رواه البيهقي (2/210و211) من طريق عبد الرحمن بن أبي أبزى.
[2]) رواه مسلم (1905)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
[3]) رواه مسلم (2985)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
[4]) كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري (1770)، وراجع تفسير ابن كثير.
[5]) الشهاب (ج1، م6) رمضان 1348ه- فيفري 1930م.