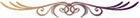
في الرابع والعشرين من شهر صفر سنة (1397)، الموافق لـ: 15/1/1977، أقيم في طيبة الطيبة المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة، وقد افتتح المؤتمر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، ثم انتخب رئيسًا للمؤتمر، وانتخب العلامة الشيخ عبد المحسن العبَّاد حفظه الله نائبًا للرئيس، واشترك فيه علماء ودعاة من نحو سبعين قطر من أقطار العالم، وقد خصَّصت مجلة الجامعة عددها السادس والثلاثين عن المؤتمر، فذكرت الكلمات التي ألقيت في الافتتاح، وتوصيات المؤتمر، مع بعض المحاضرات، ومنها محاضرة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله، فقد كان أحد المشاركين، وكيف لا وهو أحد أعضاء المجلس التأسيسي للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
كان أبو الحسن يدرك أهمية ذلك الاجتماع الذي ضمَّ علماء وطلبة علم ودعاة من شتَّى أنحاء العالم، ولا بدَّ أن أكثرهم كان متأثرًا بالتيارات الفكرية المعاصرة، فكان لا بدَّ أن يضع يده على موضع الداء، ويحدِّد الدواء، وينقض بهدوء وذكاء أصول الدعوات الجديدة، فاختار لمحاضرته عنوان: (بعض سمات الدعوة في هذا العصر)، وجعله في محورين، الأول: سمات الدعوة، والثاني سمات الدعاة.
المحور الأول: سمات الدعوة:
قال رحمه الله: (أما الدعوة الإسلامية فيجب أن تكون هذه الدعوة جامعة بين تحريك الإيمان في نفوس المخاطبين والمجتمع الإسلامي وإثارة الشعور الديني، وبين إكمال الوعي وتنميته وتربيته، فإن المتتبع لأحوال العالم الإسلامي اليوم وواقع الأقطار الإسلامية وحكوماتها وشعوبها يعرف أن تمسك هذه الشعوب والجماهير بالإسلام وحبها له هو الحاجز السميك والسد المنيع لكثير من القيادات التي خضع للحضارة الغربية وقيمها ومفاهيمها، وفلسفاتها ونظمها، وآمنت بها إيمانا كإيمان المتدينين بالديانات المؤمنين بالشرائع السماوية، وفقدت الثقة بصلاحية الإسلام لمسايرة العصر الحديث وتطوراته وأحداثه، وكرسالة خالدة عالمية، فإسلام هذه الشعوب والمجتمعات وكونها لا تفهم إلا لغة الإيمان والقرآن ولا تندفع إلا لما يجيء عن طريقهما، ولما يمس قلبها ويخاطب ضميرها، يعوق كثيرًا من هذه القيادات عن نبذ الإسلام نبذًا كليًّا وإعلان الحرب عليه، وقد لجأ بعض هذه القيادات في ساعات عصبية إلى إثارة هذا الإيمان والحماس الديني، واستخدامهما لكسب المعركة أو الانتصار على العدو حين رأت أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وإلى إيمان هذه الشعوب السليمة المؤمنة، فرفعت هتافات التكبير، الجهاد، والشهادة في سبيل الله، ومحاربة العدو الكافر المهاجم كما فعلت الجزائر في حربها مع الفرنسيين وباكستان في حرب 1965م، وجربت فائدة هذا الإيمان وقوة هذه العاطفة. فأصبح إيمان هذه الشعوب وتمسكها بالإسلام وتحمسها له، هو السور القوي العالي الذي يعتمد عليه في بقاء هذه البلاد، وكثير من القيادات والحكومات الإسلامية في حظيرة الإسلام، فإذا تهدم هذا السور ـ لا سمح الله بذلك ـ أو تسوره دعاة الكفر واللادينية، أو تيار الردة الفكرية والحضارية فالخطر كل الخطر على الإسلام في هذه البلاد، ولا يمنع هؤلاء القادة المحاربين للإسلام، والمضمرين له العداء والحقد شيء من أن يخلعوا العذار ويطرحوا الحشمة والتكلف، ويجردوا هذه الأقطار والشعوب العريقة في الإسلام من كل ما يمد إلى الإسلام بصلة، فإن الشيء الوحيد الذي يخافون معرته، ويحسبون له حسابًا هو ثورة هذه الشعوب على هذه القيادات بدافع الإيمان والحماس الإسلامي، فيفقدهم ذلك ما يتمتعون به من كراسي الحكم ومركز القيادة، فإذا زال الحاجز لم يقف في وجههم شيء. إذن فيجب على دعاة الإسلام والعاملين في مجال الدعوة الإسلامية الاحتفاظ بهذه البقية الباقية من الإيمان في نفوس الشعوب والجماهير، والمحافظة على الجمرة الإيمانية من أن تنطفي).
قال التركماني عفا الله عنه: هذا تأصيل صحيح، طالما أكَّد عليه العلماء الربانيون، والدعاة السلفيون، وبيَّنوا أن لا سبيل إلى إصلاح واقع المجتمعات المسلمة ـ خاصة تلك التي ابتليت بحكام ضالين مضلين ـ إلا بالتركيز على إصلاح الأفراد والمجتمعات، بالدعوة إلى الدين الصحيح، وتعظيمه، والاعتزاز به، وتربية النفس والأسرة والنشء عليه. وهذا ما يسميه العلامة الألباني رحمه الله بالتربية، فلا بدَّ من تربية الأمة على التدين القوي، وفي ذلك أعظم مدافعة لأعدائها في الداخل والخارج.
وقال رحمه الله: (ولا يصح الاقتصار على تحريك الإيمان، وإثارة العاطفة الدينية في نفوس الشعوب والجماهير، بل يجب أن تضم إليه تنمية الوعي الصحيح وتربيته والفهم للحقائق والقضايا، والتمييز بين الصديق والعدو وعدم الانخداع بالشعارات والمظاهر، فقد رأينا أن الشعوب التي يضعف فيها هذا الوعي أو تُحرمه يتسلط عليها ـ رغم تمسكها بالإسلام وحبها له ـ قائد منافق، أو زعيم ماكر أو عدو جبار، فيصفق له الشعب بكل حرارة ويسير في ركابه، فيسوقها بالعصا سوق الراعي لقطعان من الغنم، لا تعقل ولا تملك من أمرها شيئًا، ولا يمنعها تمسكها بالإسلام وحبها له من أن تكون فريسة سهلة أو لقمة سائغة للقيادات اللادينية أو المؤامرات ضد الإسلام).
قال التركماني: هذا الواجب الثاني، وهو العلم النافع والعقيدة الصحيحة والفقه في الدين، أو ما يسميه العلامة الألباني رحمه الله بالتصفية، حتى يكون المسلم قادرًا على التمييز بين الحق والباطل، والتوحيد والشرك، والسنة والبدعة، وإغفال هذا الواجب وجه من وجوه انحراف الحركات الإسلامية، فتجدهم في كل موطن لا يفقهون؛ مرة يتحالفون مع الاشتراكيين أو الشيوعيين أو العلمانيين، ومرة أخرى يضعون ثقتهم في الرافضة ـ أعداء الملة ـ، وهاهم الآن يقودون دعوات الحرية والتغيير. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من الجمع بين العلم النافع والإيمان الصادق والعمل الصالح، لهذا نوَّه الندوي رحمه الله إلى تميُّز السلف الصالح باجتماع الخيرين فيهم، فقال:
(وقد كان ما يمتاز به المجتمع الإسلامي الأول المثالي ـ الصحابة رضي الله عنهم ـ، بفضل التربية النبوية الدقيقة الشاملة: الجمع بين الدين المتين الذي لا مغمز فيه، والإيمان القوي الذي لا يعتريه وهن، وبين الوعي الناضج الكامل فكانوا لا يخدعون ولا ينخدعون، ولا يسيغون شيئًا ينافي الإسلام وينافي العقل، والذي يضرهم ويجني عليهم أو يوقعهم في خطر أو تهلكة، قد بلغوا من الرشد واستكملوا الحصافة والنضج، فلا يؤخذون على غرة، ولا يقعون في شرك ينصبه العدو الماكر، يخطؤون ولا يصرون، ولا تتكرر منهم غلطات وتورطات، وقد جاء في حديث صحيح: (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)، بخلاف الشعوب الفاقدة الوعي فهي تلدغ مرة بعد مرة، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذهم بتربية وتعاليم أَمِنوا بها عن الوقوع في الشباك، وامتنعوا بها عن قبول ما لا يتفق مع تعاليم الإسلام, وآدابه والفطر السليمة والعقول المستقيمة، فكان مجتمعًا نمودجيًّا مثاليًّا في كل شيء..) ثم ذكر بعض الأمثلة من السيرة.
وبعد هذا التقرير لقاعدتي التربية والتصفية، شرع الندوي رحمه الله في التنبيه على ضرورة المحافظة على المقاصد الدينية والحقائق الشرعية وخطورة تحريفها وتشويهها، فقال رحمه الله:
(وواجب ثالث مقدَّس من واجبات العاملين في مجال الدعوة الإسلامية هو صيانة الحقائق الدينية والمفاهيم الإسلامية من التحريف، وإخضاعها للتصورات العصرية الغربية، أو المصطلحات السياسية والاقتصادية التي نشأت في أجواء خاصة، وبيئات مختلفة ولها خلفيات وعوامل وتاريخ، وهي خاضعة دائمًا للتطور والتغيير، فيجب أن نغار على هذه الحقائق الدينية والمصطلحات الإسلامية غيرتنا على المقدسات وعلى الأعراض والكرامات بل أكثر منها وأشد، لأنها حصون الإسلام المنيعة وحِمَاه وشعائره، وإخضاعها للتصورات الحديثة وتفسيرها بالمصطلحات الأجنبية إساءة إليها لا إحسان، وإضعاف لها لا تقوية، وتعريض للخطر لا حصانة، ونزول بها إلى المستوى الواطئ المنخفض، لا رفعٌ لشأنها كما يتصور كثير من الناس)…
ثم شرع في ضرب بعض الأمثلة، وهي من واقع الدعوات المعاصرة التي اتجهت اتجاهًا سياسيًّا في تفسير الدين وحقائقه، فقال: (فإذا قلنا الحج: (مؤتمر إسلامي عالمي)، لم ننصف الحجَّ، ولم ننصف لمن نخاطبه، ونريد أن نفهمه حقيقة الحج وروحه ولما شرع له، ولم ننصح لكليهما، وإن روح الحج وسر تشريعه غير ما يعقد له المؤتمرات صباح مساء، ولو كان الحج مؤتمرًا إسلاميًّا عالميًّا لكان له شأن ونظام غير هذا النظام، وجوٌّ غير هذا الجو، ولكان النداء له مقصور على طبقات مثقفة واعية فقط، وعلى قادة الرأي وزعماء المسلمين. كذلك حقيقة العبادة، وحقيقة الصلاة، وحقيقة الزكاة والصوم، فلا يجوز العبث بهذه المصطلحات والتجني عليها، وإخضاعها للفلسفات الجديدة، وتفسيرها بالشيء الذي لا ثقة به ولا قرار له…)
قال التركماني: يشير الندوي بهذا إلى تحريف حقائق الدين ومقاصده عند الإسلاميين المعاصرين، وعلى رأسهم المودودي وسيد قطب، وقد نبَّه على أنه مسلك خطير لا يشبه إلا مسالك الباطنية، فقال:
(وقد استخدمت هذه (الإستراتيجيةَ الدعائيةَ) الباطنيةُ في القرن الخامس الهجري فما بعده، ففسَّروا المصطلحات الدينية بما شاؤوا وشاءت أهوائهم ومصالحهم وتفننوا فيه، وأتوا بالعجب العجاب، وحققوا به غرضهم من إزالة الثقة بهذه الكلمات المتواترة التي هي أسوار الشريعة الإسلامية وحصونها، وشعائرها، ونشر الفوضى في المجتمع الإسلامي، والجماهير المسلمة، وإذا فقدت هذه الكلمات التي توارثت فهمها الأجيال المسلمة وتواتر في المسلمين وأصبح فيها مساغ لكل داع إلى نحلة جديدة، ورأي شاذ، وقول طريف، فقد أصبحت قلعة الإسلام مفتوحة لكل مهاجم ولكل منافق، وزالت الثقة بالقرآن والحديث واللغة العربية، وجاز لكل قائل أن يقول ما شاء ويدعو إلى ما شاء، وهذه فتنة لا تساويها فتنة، وخطر لا يكفئه خطر)…
ثم شرع في شرح ذلك بكلام قيم نفيس، ليخلص إلى التحذير البليغ من مسالك الحركيين في جعل حقيقة الدين وغاياته: إعمار الأرض وإقامة الدولة، وادعاء أن العبادات المحضة التي خلقنا من أجلها وسائل وأدوات لذلك، فقال رحمه الله:
(وكذلك أحذِّركم ـ أيها الإخوان! ـ مما لوحظ من بعض الكُتَّاب من الضغط على أن هذه الأركان الدينية وفرائض الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائل لا غايات، إنما شرعت لإقامة الحكم الإسلامي وتنظيم المجتمع المسلم وتقويته. وأحذركم من كل ما يحط من شأن روح العبادة والصلة بين العبد وربه وامتثال الأمر، ومن التوسع في بيان فوائدها الخلقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية أحيانًا توسعًا يخيل للمخاطب أو القارئ أنها أساليب تربوية أو عسكرية أو تنظيمية، قيمتها ما يعود منها على المجتمع من قوة ونظام أو صحة بدنية وفوائد طبية، فإن أول أضرار هذا الأسلوب من التفكير أو التفسير أنه يفقد هذه العبادات قيمتها وقوتها، وهو امتثال أمر الله وطلب رضاه بذلك، والإيمان والاحتساب والقرب عند الله تعالى، وهي خسارة عظيمة لا تعوض بأي فائدة، وفراغ لا يملأ بأي شيء في الدنيا).
ثم نبَّه بذكاء وفطنة إلى ضرر آخر، وهو ما يعتقده ويصرح به كثير من الإسلاميين اليوم، حتى أن بعضهم يرى جواز مخالفة النصوص الصريحة في كل ما فيه مصلحة للبشرية، فقال رحمه الله:
(والضرر الثاني أنه لو توصل أحد المشرعين أو الحكماء المربين إلى أساليب أخرى قد تكون أنفع لتحقيق هذه الأغراض الاجتماعية أو التنظيمية أو الطبية لاستغنى كثير من الذين آمنوا بهذه الفوائد عن الأركان والعبادات الشرعية، وتمسكوا بهذه الأساليب أو التجارب الجديدة، وبذلك يكون الدين دائما معرضًا للخطر ولعبة للعابثين والمحرفين.
وهذا لا ينافي الغوص في أعماق هذه الأركان والأحكام والحقائق الدينية، والكشف عن أسرارها وفوائدها الاجتماعية، وقد أفاض علماء الإسلام قديمًا وحديثًا في بيان مقاصد الشريعة الإسلامية وأسرار العبادات والفرائض والأحكام الشرعية، وألفوا كتبًا مستقلة وكتبوا بحوثًا جليلة، كالغزالي والخطابي وعز الدين بن عبد السلام وابن قيم الجوزية، وأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي؛ ولكن كل ذلك من غير تحريف لحقيقة هذه العبادات والأحكام والغاية الأولى التي شرعت لها، وهي امتثال الأمر الإلهي، والتقرب إليه بذلك والإيمان والاحتساب فيها ومن غير إخضاع لها للفلسفات العجمية أو الأجنبية في عصرهم ومن غير خضوع بسحرها وبريقها).
قال عبد الحق التركماني: إذا أدرك القارئ هذه المقدمات المكوِّنة لفكر الحركيين ودينهم الجديد؛ أدرك سبب عدم اهتمامهم بتحقيق التوحيد لله عز وجل ونفي الشرك ومحاربة صوره ووسائله وأسبابه، فكل هذا ليس بذي بال عندهم، إِذْ ما ينفعُ المشروعَ المادي النفعي المبالغةُ في تحقيق التوحيد والعبودية لله الواحد الأحد، أو بذل الجهد في محاربة الشرك والوثنية، بل قد يعيق الانشغال بهذين الأمرين عن تحقيق الغايات العليا في النهضة والتنمية والبناء! ومن هنا قال أبو الحسن الندوي رحمه الله:
(وأحذِّركم ثانيةً ـ أيها الشباب! ـ من كل ما يقلِّل من شناعة الوثنية العقائدية، والشرك الجليِّ: من عبادة غير الله، والسجود له، وتقديم النذور والقرابين، وإشراكه في صفات الله من قدرة علم وتصرف وإماتة وإحياء، وإسعاد وإشقاء).
قلتُ: تأمل كلامه هذا، وقارنه باتهام بعضهم له بأنه: (قبوريٌّ)!
وقال: (وأحذِّركم من الاكتفاء بالتركيز على شناعة الخضوع للحكومات والنظم الإنسانية والتشريعات البشرية، وتحويل حق التشريع للإنسان، وأن ذلك وحده هو عبادة الطاغوت والشرك، وأن الوثنية الأولى وعبادة غير الله قد فقدت أهميتها، وإنما كانت لها الأهمية في العصر القديم العصر البدائي، وأنه لا يقبل عليها الآن الرجلُ الجاهل الذي لا ثقافة له، ففضلاً عن أن هذه الوثنية والشرك الجلي لا يزال له شيوع وانتشار، ودولة وصولة يجربه كل إنسان في كل زمان ومكان، فإنها الغاية الأولى التي بعث لها الأنبياء وأنزلت لها الكتب السماوية، وقامت لها سوق الجنة والنار، وكانت دعوة جميع الأنبياء تنطلق من هذه النقطة، وكانت جهودهم مركزة على محاربة هذه الجاهلية والقرآن مملوء بذلك بحيث لا يقبل تأويلاً. اقرأ على سبيل المثال سورة الأعراف وسورة هود وسورة الشعراء والحديث عن كل نبي ودعوته).
ثم قال منبهًا على خطورة منهج الحركيين وأثره السيئ في صرف الناس عن دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقال:
(وإن كل ما يقال عن أهمية محاربة الشرك الجلي وعبادة غير الله سواء أكانوا أشخاصًا أو أرواحًا، أو ضرائح ومشاهد، والعناية بمحاربة النظم والتشريعات والحكومات فحسب؛ إحباط لجهود الأنبياء، واتجاه بهذا الدين عن منهجه القديم السماوي إلى المنهج الجديد السياسي، وهو تحريف لا محالة، هذا من غير أن أقلل من قيمة التركيز على أن التشريع لله وحده، وله الحكم والأمر وحده، وأن من يدعو إلى طاعة نفسه الطاعة المطلقة العمياء منافس للرب وطاغوت، وأنه يجب أن يدعى إلى التشريع الإلهي وإلى إقامة الحكم الإسلامي القائم على منهاج الكتاب والسنة ومنهاج الخلافة الراشدة، وأن لا يدخر سعي في ذلك، لكن لا على حساب الدعوة إلى التوحيد، والدين الخالص، ومحاربة الوثنية والشرك، فإنها لا تزال في الدرجة الأولى وهي أكثر انتشارًا، وأعظم خطرًا في الدنيا والآخرة، فقد قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً}، وقد قال: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ}.).
المحور الثاني: سمات الداعين إلى الله تعالى:
ذكر الندوي كلامًا نفيسًا فيما يجب أن يتصف به الدعاة من الزهد في الدنيا، والعمل للآخرة، والصدق مع الله، والترفع عن دنيا الناس وعدم منافستهم عليها، ثم قال:
(ومن أبرز سمات الدعوة التي يقوم بها الأنبياء وخلفاءهم: أنها تقوم على الإيمان بالآخرة والتحذير من عقابها والترغيب في نعمائها وثوابها ويكون مناط العمل فيها الإيمان والاحتساب والآخرة والثواب، لا على الإغراء بالفوائد الدنيوية والجاه والمنصب والمال والملك، فإنه أساس ضعيف منهار، ولا يتفق مع طبيعة دعوات الأنبياء، والمساومة فيه سهلة، وقد يملك أعدائهم وخصومهم والقادة السياسيون مثله أو أكثر منه، ومن رضع بلبان هذه المطامع لم يمكن فطامه عنها، ولا يصح الاعتماد عليه، وإنما يبنون دعوتهم على رضا الله وثوابه وما أعده لعباده المؤمنين وما وعدهم به على لسان أنبياءه، من نعيم لا يزول ولا يحول، والصحف السماوية ـ غير صحف العهد القديم التوراة ـ مملوءة بالحديث عن الآخرة والاهتمام بها والبناء عليها وقد جعل الإسلام والإيمان بها عقيدة أساسية شرطًا لصحة الإيمان والنجاة وقد جاء في القرآن صريحًا: {تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}. وهنا أستعير لنفسي من نفسي ما قلته في إحدى المحاضرات التي ألقيتها في هذه الجامعة العزيزة سنة (1382هـ) تحت عنوان: (النبوة والأنبياء في ضوء القرآن) وأختم به هذا الحديث مؤملاً في أن تكون هذه السمات التي تحدثت عنها شعار الدعوة التي يقوم بها الدعاة المتخرجون من هذه الجامعة، أو القائمون بأعبائها في كل ناحية من نواحي العالم الإسلامي، قلتُ ـ وأنا أتحدث عن الفرق بين منهج الدعوات النبوية وبين الدعوات الإصلاحية ـ: ولم تكن دعوة الأنبياء إلى الإيمان بالآخرة أو الإشادة بها كضرورة خلقية، أو كحاجة إصلاحية لا يقوم بغيرها مجتمع فاضل ومدنية صالحة فضلاً عن المجتمع الإسلامي. وهذا وإن كان يستحق التقدير والإعجاب ولكنه يختلف عن منهج الأنبياء وسيرتهم ومنهج خلفائهم اختلافًا واضحًا. والفرق بينهما أن الأول منهج الأنبياء إيمان ووجدان، وشعور وعاطفة وعقيدة تملك على الإنسان مشاعره، وتفكيره وتصرفاته، والثاني اعتراف وتقدير وقانون مرسوم وأن الأولين يتكلمون عن الآخرة باندفاع والتذاذ ويدعون إليها بحماسة وقوة وآخرون يتكلمون عنها بقدر الضرورة الخلقية والحاجة الاجتماعية وبدافع من الإصلاح والتنظيم الخلقي، وشتان ما بين الوجدان والعاطفة وبين الخضوع للمنطق والمصالح الاجتماعية).
قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: هذه خلاصة تلك المحاضرة القيمة ـ وقد دلَّني عليها أحد الفضلاء من أهل العلم ـ، تضمَّنت التنبيهَ على الأصول التي يركِّز عليها العلماء الربانيون من الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح، والانشغال بإصلاح المجتمع الإسلامي ومواجهة انحرافات الحكام بذلك، وبيان خطورة الشرك، ووجوب محاربته، وأن ذلك أصل دعوة الأنبياء، وتفرَّدتْ بالتنبيه على أصول الانحراف الخطير في الدعوات المعاصرة، ألقاها الشيخ في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بحضور سماحة الشيخ عبد العزيز بن بار، والعلامة عبد المحسن العباد، وغيرهما من علماء الدعوة السلفية. وهي نموذج لما في منجم الندوي من كنوز، وسأستخرج لكم منها المزيد، فرفقًا أهلَ السنة بأهل السنة، ومن الله التوفيق والمنَّة.
كتبه لكم:
عبد الحق التركماني
بريطانيا: 10/9/1432هـ