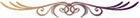
الكاتب والأديب الشهير سيِّد قطب هو كاسمه سيِّدٌ وقطبٌ بين أعلام الحركة الإسلامية في العالم كلِّه، فما تزال كتبه تمثِّلُ مرجعًا أساسيًّا للحركيين رغم ما بينهم من اختلافات كبيرة في المفاهيم والمواقف، يستوي في ذلك من كان منهم ليبراليًّا متحررًا، أو خارجيًّا متطرفًا، وسائر من كان في منزلة بين هاتين المنزلتين، لهذا عُني جماعة من أهل العلم وطلابِه بالردِّ عليه، وبيان ما في كتبه من أخطاء وانحرافات خطيرة، نصحًا للأمة، وإبراء للذمة، فكانت لجهودهم آثار طيبة في التنبيه على تلك المخالفات والتحذير منها، مثل: تكفيره للمجتمعات المسلمة، وانحرافه في مفهوم الألوهية والربوبية والحكم بما أنزل الله، وتقريره لوحدة الوجود في مواضع من تفسيره، وتأويله لبعض الصفات الإلهية، وإساءته الأدب مع بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام، وتفسيره لكلام الله بالموسيقى وإيقاعاتها، وطعنه في جماعة من الصحابة الكرام، خاصة الخليفة الراشد عثمان بن عفَّان رضي الله عنه، وإبطاله لخلافته وعدِّه إياها فجوة في تاريخ الخلافة الراشدة، وقوله بالاشتراكية وجواز التشريع لتوزيع الثروات والقضاء على الرأسماليَّة والإقطاع، إلى غير ذلك من الانحرافات التي أصبحت أكثرها ـ بتوفيق الله تعالى ثم بفضل تلك الجهود المشكورة ـ معروفة مشهورة عند عامة الناس.
إن من المؤسف أن الردَّ على سيد قطب، والتحذيرَ من فكره؛ وقف عند هذا الحدِّ، حيث لم يتجاوز الأخطاء والانحرافات الجزئية التفصيلية، وهي ـ بلا شكٍّ ـ مهمة وخطيرة، لكن الأهم والأخطر منها «الأصل الكليِّ» لانحرافه في الاعتقاد والفكر، وهو المنبع الرئيس لأخطائه الجزئية التفصيلية. إن الكشف عن ذلك «الأصل الكلي» لفكر سيد قطب هو «المعيار» لفهمه، و«المفتاح» لإدراك أبعاده ومراميه، خاصةً أننا نجد أكثر الذين يحملون فكره، ويتبعون نهجه؛ لا يقولون بتلك الأخطاء، ولا يقرُّون تلك الانحرافات، فبعضهم يكابر بإنكار نسبتها إلى سيد قطب ـ رغم ثبوتها في كتبه التي طبعها بعد وفاته أخوه محمد قطب عشرات الطبعات ـ، وبعضهم يقرُّ بها، لكنه يعتذر له بأنه كان مفكرًا إسلاميًّا، ولم يكن عالمًا شرعيًّا متخصصًا، ورغم هذا: فالجميع متَّفق على أهمية كتبه، وليس فيهم من عنده استعداد للتقليل من شأنها، أو التسامح مع من يتجرَّأ على نقدها والكشف عمَّا فيها من مخالفات للكتاب والسنة وعقيدة سلف الأمة، بل الويل له؛ ستلاحقه تُهَمُ التصنيف السيئة والتخوين والعمالة للحكام والموالاة للكفار في حياته وبعد مماته! من هنا يبرزُ السؤال الأهم: إذا كان أكثر الحركيين اليوم لا يقبلون بما في كتب سيد قطب من أخطاء تفصيلية؛ فلماذا ـ إذن ـ يصرُّون على تعظيمها والترويج لها؟! إنَّ سرَّ هذا لا يتضح إلا بمعرفة ذلك «الأصل الكلي» الذي قام عليه فكر سيد قطب، فجميع كتاباته بمثابة دعاية ذكية، وترسيخ متدرِّج لذلك «الأصل»، لهذا نجد أن أكثر القرَّاء لكتبه، والمعجبين بفكره؛ قد انحرف اعتقادهم وفكرهم ـ قليلًا أو كثيرًا ـ في ذلك «الأصل»، فتغيرت نظرتهم عن حقائق النبوة والدِّين والعبادة والشريعة تغيُّرًا جذريًّا، ثم مضوا في طريق العلم والدعوة والجهاد على غير هدًى، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا!
إن ذلك «الأصل الكلي» الذي عليه مدار فكر سيد قطب ودعوته هو »التفسير السياسي للإسلام» الذي يزعمُ أن الغاية من الخَلْق والدِّين هي عمارة الأرض وإقامة عدل الدنيا، لهذا فإنَّ »العبادة» ليست مقصودة لذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق تلك الغاية المادية الدنيوية العاجلة. هذا الاعتقاد في مفهوم الدِّين والعبادة تحريفٌ جذريٌّ لحقيقة الدِّين الإسلامي، والرسالة المحمدية، ولم يقل به من المنتسبين للإسلام إلا غلاة الفلاسفة وغلاة الصوفية والباطنية، وقام بتجديده وإعادة صياغته في العصر الحديث بعض المفكرين والدعاة، فتبلور عنه ما يُعرف اليوم بالفكر الإسلامي والحركة الإسلامية.
إنَّ تراث سيد قطب من أهم نماذج هذا التفسير التحريفي لأصل الدِّين، ومع ذلك فإن أولئك الأفاضل من العلماء وطلبة العلم ـ حسب علمي واطلاعي ـ لم ينتبهوا إليه، ولا نبَّهوا عليه، حتَّى إن العلامة الشيخ عبد الله بن محمد الدويش (ت: 1409) رحمه الله قد صرَّح في مقدمة كتابه »المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال» بأنه قرأ «في ظلال القرآن»: «من أوله إلى آخره، فوجدتُ فيه أخطاءً في مواضع، خصوصًا ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة وعلم السلوك»، ولم ينبِّه على هذا الخطإ الأهمِّ، فعُذره ـ وعذر غيره من الأفاضل ـ عدم معرفتهم بنظرية التفسير السياسيِّ والنَّفعيِّ للدِّين، وعدم خبرتهم بالفكر الغربيِّ والفلسفات الحديثة، لهذا فإننا نحتاج إلى معرفة تلك النظرية وفلسفتها؛ حتَّى ندرك أنَّ رؤية سيِّد قطب للدِّين، وتفسيره لأصوله وحقائقه الكبرى؛ إنما تستند إلى نظرية كليَّة تحصر غاية التكليف في عمارة الأرض وإقامة الحكومة العادلة والتكافل الاجتماعي، وبها تفسِّر الدِّين والعبادة، أما «العبادة الخالصة لله تعالى»، وأعلاها: أركان الإسلام؛ فتجعلها وسيلةً، أو في مرتبةٍ ثانوية.
إن التفسير السياسي للإسلام نظرية كليَّة عن النبوة والدِّين والعبادة والشريعة، لهذا يصعب إثبات التهمة به من خلال اقتباس جملة أو عبارة محددة، فهي رؤية فلسفية تصبغ التصوُّر والتأصيل والتحليل بصبغة خاصة، ويندر أن تجد لأصحابها عبارات صريحة واضحة في تقريرها، إلا أن سيد قطب لم يُرِدْ أن يُحمِّلنا العنَتَ؛ فكتب عبارةً جليَّة في تقرير اعتقاده بهذا التفسير، فقال:
«إنما أطلقتْ لفظةُ «العبادة» على «الشعائر التعبدية» باعتبارها صورةً من صور الدينونة لله في شأن من الشؤون، صورةً لا تستغرق مدلول «العبادة» بل إنَّها تجيء بالتبعية لا بالأصالة»!.
ثم أكَّد سيد قطب بأن هذا التقرير الصريح هو مراده مما كتبه في تفسير الإسلام في كتبه المختلفة، فقال:
«هذه الحقيقة هي التي قررناها كثيرًا في هذه «الظلال» وفي غيرها، في كلِّ ما وفَّقنا الله لكتابته حول هذا الدِّين وطبيعته ومنهجه الحركيِّ».
وفي هامش هذا الموضع إحالة لكتبه:
«معالم في الطريق»، و«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته»، و«هذا الدين»، و«المستقبل لهذا الدين»، و«الإسلام ومشكلات الحضارة»، و«العدالة الاجتماعية»، و«الإسلام والسلام العالمي» (في ظلال القرآن: سورة هود: 50-68، 4/1902).
وبناءً على هذا: فكتب سيد قطب كلها مبنيَّة على التفسير السياسي للإسلام، وإذا وُجد له كلام يوافق في ظاهره المفهوم الصحيح للدِّين والعبادة عند أهل التوحيد والسنة وعامة المسلمين؛ فيجب أن يُحمل على هذا المفهوم الخاصِّ عنده، ويفسَّر في ضوئه، أعني قوله: «الشعائر التعبدية: لا تستغرق مدلول «العبادة» بل إنَّها تجيء بالتبعية لا بالأصالة»!، وقد كرَّر هذه العبارة ـ بحروفها ـ في موضعٍ آخر (في ظلال القرآن: 4/1938).
إنَّ سيد قطب يصرِّح بهذا أنَّ (الشعائر التعبدية) ـ ورأسها عند جميع المسلمين: الصلاة والزكاة والصيام والحج ـ تدخل في مدلول ومفهوم العبادة «بالتبعيَّة لا بالأصالة»، ولا شكَّ أن ما كان وجوده على وجه «التبعية» يحتل مرتبة ثانوية أدنى عمَّا وجوده ثابتٌ بالأصالة. فما الذي يحتلُّ مرتبة «الأصالة» الأولى والأعلى في مفهوم العبادة؟ إنه «عمارة الأرض»، كما يصرِّح به سيِّد قطب عند قوله تعالى: {وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] فيقول:
«وإن هذا النصَّ الصغير ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة، من أضخم الحقائق الكونية التي لا تستقيم حياة البشر في الأرض بدون إدراكها واستيقانها، سواء كانت حياة فرد أم جماعة، أم حياة الإنسانية كلها في جميع أدوارها وأعصارها، وإنه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من المعاني والمرامي، تندرج كلها تحت هذه الحقيقة الضخمة، التي تعد حجر الأساس الذي تقوم عليه الحياة. وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هنالك غاية معينة لوجود الجن والإنس، تتمثل في وظيفة من قام بها وأداها فقد حقق غاية وجوده، ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد أبطل غاية وجوده، وأصبح بلا وظيفة، وباتت حياته فارغة من القصد، خاوية من معناها الأصيل، الذي تستمد منه قيمتها الأولى، وقد انفلت من الناموس الذي خرج به إلى الوجود، وانتهى إلى الضياع المطلق الذي يصيب كل كائن ينفلت من ناموس الوجود، الذي يربطه ويحفظه ويكفل له البقاء. هذه الوظيفة المعينة التي تربط الجن والإنس بناموس الوجود هي العبادة لله، أو هي العبودية لله. أن يكون هناك عبد وربٌّ: عبد يَعبد، وربٌّ يُعبد. وأن تستقيم حياة العبد كلها على أساس هذا الاعتبار. ومن ثم يبرز الجانب الآخر لتلك الحقيقة الضخمة، ويتبين أن مدلول العبادة لا بدَّ أن يكون أوسع وأشمل من مجرد إقامة الشعائر، فالجن والإنس لا يقضون حياتهم في إقامة الشعائر والله لا يكلِّفهم هذا، وهو يكلفهم ألوانًا أخرى من النشاط تستغرق معظم حياتهم، وقد لا نعرف نحن ألوان النشاط التي يكلفها الجنُّ، ولكننا نعرف حدود النشاط المطلوب من الإنسان، نعرفها من القرآن من قول الله تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة: 30]؛ فهي الخلافة في الأرض ـ إذن ـ عمل هذا الكائن الإنساني. وهي تقتضي ألوانًا من النشاط الحيوي في عمارة الأرض، والتعرف إلى قواها وطاقاتها، وذخائرها ومكنوناتها، وتحقق إرادة الله في استخدامها وتنميتها وترقية الحياة فيها. كما تقتضي الخلافة: القيام على شريعة الله في الأرض لتحقيق المنهج الإلهي الذي يتناسق مع الناموس الكوني العام. ومن ثم يتجلَّى أن معنى العبادة ـ التي هي غاية الوجود الإنساني أو التي هي وظيفة الإنسان الأولى ـ أوسع وأشمل من مجرد الشعائر، وأن وظيفة الخلافة داخلة في مدلول العبادة قطعًا،… فمن مقتضيات استقرار معنى العبادة أن يقوم بالخلافة في الأرض، وينهض بتكاليفها، ويحقق أقصى ثمراتها». (في ظلال القرآن: 6/3387).
إذا كانت الغاية من الخَلْق والدين: الخلافةَ والعمارةَ، والعباداتُ الأصلية ـ التي هي أركان الإسلام ـ داخلة في تلك الغاية «بالتبعيَّة لا بالأصالةً»؛ فمن البديهيِّ ـ إذن ـ أن تفقد «العبادات» قيمتها الذاتية المستقلة، وتنحطَّ عن منزلتها الرفيعة العالية، فتصبح الدعوة إلى إقامتها عملًا جزئيًّا غير ذي بالٍ، فالتبع لا قيمة له مع غياب المتبوع، والفرع لا قيام له مع سقوط الأصل. لقد التزم سيد قطب هذا اللازم العقلي الضروري فقال:
«والواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحقَّتْ كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات، وما استحقت كل هذه الجهود المضنية التي بذلها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وما استحقت كل هذه العذابات والآلام التي تعرَّض لها الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان! إنما الذي استحقَّ كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد، وردهم إلى الدينونة لله وحده في كل أمرٍ، وفي كل شأنٍ، وفي منهج حياتهم كلِّه للدنيا والآخرة سواء. إن توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد القوامة، وتوحيد الحاكمية، وتوحيد مصدر الشريعة، وتوحيد منهج الحياة، وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة. إن هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل، وأن تبذل في سبيله كل هذه الجهود وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان. لا لأنَّ الله سبحانه في حاجة إليه، فالله سبحانه غني عن العالمين، ولكن لأن حياة البشر لا تصلح، ولا تستقيم، ولا ترتفع، ولا تصبح حياة لائقة بالإنسان إلا بهذا التوحيد الذي لا حدَّ لتأثيره في الحياة البشرية في كل جانب من جوانبها» (في ظلال القرآن: 4/1903، وقد كرَّره فرحًا به في موضع آخر: 4/1938).
هذه الرؤية الفلسفية لهدف الدين هي التي قرَّبت سيد قطب من الماركسية، وحملته على تبني المنهج الاشتراكي، وألَّف في ذلك كتابيه: »معركة الإسلام والرأسمالية»، و»العدالة الاجتماعية في الإسلام»، وسأذكر هنا مثالًا واحدًا من كلامه يؤكد ما سبق من صريح كلامه في جعل غاية الخلق إعمار الأرض، وجعل العبادة مقصدًا تبعيًّا وهامشيًّا: يقول سيد قطب في معالجة مشكلة (فساد العمل وضعف الإنتاج):
»إن الإسلام يعالجها بإزالة مسبباتها المادية الأولى، ثم يعالجها بامتلاء النفس بالعقيدة الدافعة، العقيدة التي تملأ فراغ النفس وخواءها، وترفعها إلى الله، وتجعل للفرد هدفًا أكبر من ذاته، هو ذلك المجتمع الذي يعيش فيه، وتلك الإنسانية التي هو منها…» (معركة الإسلام والرأسمالية، دار الشروق، بيروت: ط 13، 1414، ص: 49-51).
هكذا تتحدَّد غاية العقيدة عند سيد قطب في الفعل الدنيوي من أجل المجتمع والإنسانية. إن جعل هذا الفعل الدنيوي المادي هو الهدف الأسمى للإنسان وعقيدته؛ يؤدي حتمًا إلى إلغاء المكانة المركزيَّة للعبادة، وسيد قطب يلتزم هذا اللازم، فيصرح به بعد أسطر (ص: 52):
»والإسلام عدوُّ التبطُّل باسم العبادة والتديُّن؛ فالعبادة ليست وظيفة حياة، وليس لهذا إلا وقتها المعلوم: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10]، وتمضية الوقت في التراتيل والدعوات بلا عمل منتج ينمِّي الحياة؛ أمرٌ لا يعرفُه الإسلام، ولا يقرُّ عليه تلك الألوفَ المؤلَّفة في مصر التي لا عمل لها إلا إقامة الصلوات في المساجد أو تلاوة الأدعية والأذكار في الموالد! ولو كان الأمر للإسلام لجنَّد الجميع للعمل».
إن سيد قطب ينحو في هذا التفسير منحى الفلاسفة في غاية النبوة والرسالة والعبادة ومنفعتها، فهي عندهم متعلقة بمصلحة العباد لا بكونها حقًّا خالصًا لله تعالى. ولا شكَّ أنَّ كلامَه هذا إساءةُ الأَدبِ مع ربِّ العالمين، فهو الإله الحقُّ المستحقُّ لغاية الحبِّ، بغاية الذُّلِّ، بغاية التَّعظيم: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الزمر: 67].
هذا هو «المعيار» الذي ينبغي أن يُفسَّر به فكر سيد قطب، ويفهم مقاصده وأهدافه. ذلك الفكر الذي تربَّت عليه قوافل الثورة والعنف والتطرف والإرهاب والتكفير والتفجير والعمليات الانتحارية، فكانت «القاعدة» و«داعش» و«دعاة الخراب العربي»، وكان ما كان، والله المستعان، وعليه التكلان.
كتبه: عبد الحق التركماني
15 صفر 1437