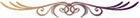
أيُّهما أكملُ: العبادةُ مع رجاءِ
الثوابِ وخوفِ العقابِ، أم العبادةُ دونَهما؟
تعريف وتوثيق:
هذا بحث نفيس كتبه علامة الجزائر الإمام عبد
الحميد بن باديس (1305 – 1359 / 1887 – 1940) رحمه الله تعالى، وأراد به إثبات ركني العبادة: الخوف والرجاء،
مع الركن الثالث: المحبة، وأراد بهذا تقرير الحقَّ كما ورد في كتاب الله تعالى
صريحًا، ثم الردَّ على من خالفه وشغَّب عليه. فقد ذكر ابن باديس أنَّه بيَّن
الصواب في هذه المسألة، وأنه بعد أن مضى على ذلك ثلاثة أشهرٍ كاملة؛ نشر الشيخ
المولود الحافظي [ت: 1367/1948] مقالًا في الردِّ عليه، فتصدَّى ابن باديس للرد
عليه، والجواب على ما أورده من الشبهات الضعيفة.
وهذا المقال نموذج من جهاد العلماء الإصلاحيين
في تصحيح عقائد الناس وعباداتهم، بعد أن اجتالتهم الشياطين، وأضلهم شيوخ التصوف
والخرافة، ونموذج لما كان يحصل في ذلك الوقت في بلد الجزائر من ردود ومناقشات، فقد
كان ابن باديس السلفي داعية إصلاح وتجديد، أما الشيخ المولود الحافظي فمن شيوخ
التصوف والخرافة والجهالة.
والشيخ المولود هو ابن الصديق الحافظي الأزهري
(1297 - 1367/1880 - 1948)، كان من أنصار «جمعية العلماء المسلمين» حين تأسيسها،
لكن لم يرتض توجهها السلفي، فخرج منها مبكرًا، ومعه جماعة من شيوخ الزوايا والطرق
الصوفية، وأسسوا «جمعية علماء السنة» بتاريخ: 15 سبتمبر 1932، وتولَّى الحافظي
رئاستها، فكانت جمعية للقبوريين والخرافيين ودعاة التقليد والجمود. وجرت ردود
ومناقشات بين الحافظي وابن باديس وغيره من العلماء السلفيين في عدة مسائل، حفظتها
صفحات الجرائد والمجلات التي كانت تصدر في ذلك الوقت. وراجع في هذا: «الصراع بين
جمعية العلماء المسلمين الجزائيين وجمعية علماء السنة: 1932 – 1954: قراءة في المواقف»، وهو بحث
مفيد للأستاذ عامر أقحيز، منشور في «مجلة مؤشر للدراسات الاستطلاعية»، العدد (1)،
المجلد: (1)، سبتمبر: (2020)، 59 – 70.
وأرَّخ العلامة ابن باديس مقاله ـ هذا ـ في (غرة
رمضان: 1351)، وهذا التاريخ يوافق: 29 كانون الأول / ديسمبر 1932، وذكر في حاشية
مقاله: «فيه
ردٌّ على مقال الشيخ الحافظي المدرج في جريدة البلاغ منذ بضعة أسابيع». فيكون ردُّ الشيخ الحافظي في أواخر أعداد
«جريدة البلاغ» التي صدرت في سنة (1932)، وقد تيسَّر لنا الوقوف على مصورة أعداد
تلك السنة، ولم نجد فيها ردَّ الحافظي، والله أعلم.
وجريدة «البلاغ الجزائري» أسستها الطريقة
العلاوية، وصدر عددها الأول في 26 ديسمبر 1926، وكانت أسبوعية، تصدر كل يوم جمعة.
والعلاوية طريقة صوفية عصرية، أسسها الشيخ أحمد بن مصطفى بن عليوة سنة (1914) في
مدينة مستغانم بالجزائر. وكانت «البلاغ» منبرًا لنشر بدع والقبورية والصوفية
والدفاع عنها، وجبهة الهجوم على الدعوة الإصلاحية السلفية التي كان يقودها الإمام
ابن باديس، وتدل الحقائق التاريخية أن توظيف الطريقة والجريدة جاء بتوجيه الاحتلال
الفرنسي ورعايته ودعمه، كما تجده موثقًّا في بحث «صحافة الطرق الصوفية: جريدة
البلاغ الجزائري نموذجًا» للدكتور المصطفى الريس، مجلة ليكسوس في التاريخ والعلوم
الإنسانية، العدد (1)، سنة: (2016)، 65-43.
ومقال الشيخ عبد الحميد بن باديس في أصله مقالان،
الأول في صفات عباد الرحمن المذكورة في سورة الفرقان، نشرت الصفتان الثالثة
والرابعة في «الشهاب» جزء (9)، مجلد: (8)، جمادى الأولى (1351)، سبتمبر (1932). والثاني
بعنوان: «أيهما أكمل:...» نُشر في «الشهاب» جزء (1)، مجلد: (9)، غزة رمضان (1351)،
جانفي [كانون الثاني، يناير] (1933). ثم نشر المقالان على هذا الترتيب في «مجالس التذكير
من كلام الحكيم الخبير»، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، الطبعة الأولى:
(1402/1982)، 277-293، وفي «آثار ابن باديس»، تحقيق: عمار طالبي، دار ومكتبة
الشركة الجزائرية، الطبعة الأولى: (1388/1968)، 1/443 – 463. وبالله تعالى التوفيق.
نصُّ مقال العلامة عبد الحميد بن باديس
الصنهاجي (ت: 1358/1940):
القرآن يصف عباد الرحمن
الصفة الرابعة:
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ
يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ
غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66)﴾ [الفرقان]
زعم قومٌ أنَّ أكمَلَ أحوالِ العابد أن يعبدَ
الله تعالى لا طمعًا في جنَّته، ولا خوفًا من ناره. وهذه الآية وغيرها ردٌّ قاطعٌ
عليهم. ومثلها قول إبراهيم عليه وعلى آله الصلاة والسلام: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ
(82)﴾ [الشعراء]، في نصوصٍ لا تُحصى كثرة.
وزعمُوا أنَّ كمال التعظيم لله ينافيه أن تكونَ
العبادةُ معها خوفٌ من عقابه، أو طمَعٌ في ثوابه. وأخطأوا فيما زعموا: فإنَّ
العبادة مبناها الخضوعُ والذلُّ والافتقارُ، والشعور بالحاجة والاضطرار. وإظهارُ
العبد هذه العبودية بأتمِّها، ومِن أتمِّ مظهرٍ لها أن يَخافَ ويَطمعَ، كما يذل،
ويَخضعَ؛ ففي إظهار كمال نقص العبودية القيامُ بحقَّ الإجلال والتعظيم للربوبية. ولهذا
كان الأنبياءُ عليهم الصلاة والسلام هم أشدُّ الخلق تعظيمًا لله، وأكثرهم خوفًا من
الله، وتعوُّذًا من عذاب الله، وسؤالًا لما عند الله، وكفى بهم حجة وقدوة.
وإن هذه المقالة([1]) تكاد تفضي إلى طرح الرجاء والخوف، وعليهما
مبنى الأعمال، لما فيهما من ظهور العبوديَّة بالذُّل والاحتياج. ومن دعاء القُنوت
الثابت المحفوظ: «وإليك نسعى ونحفد([2])، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجِدَّ»([3]).
وهذا ضروريٌّ في الدين، ولكن مثل هذه المقالة
إنما يجرُّ إليها الغلوُّ وقلَّة الفقه في الدين، وفي الكتاب والسنة، وما كان عليه
هدي السابقين الأولين.
أيهما أكمل: العبادة مع رجاء الثواب وخوف
العقاب؟ أم العبادة دونهما؟([4])
زيادة بيان على قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا
عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ
مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66)﴾ [الفرقان]
تمهيد:
قد قال قومٌ: إنَّ العبادة دونَ رجاءِ ثوابٍ
ولا خوفِ عقابٍ هي أكملُ العبادات!
وأنكرنا مقالَتهم فيما كتبناه على قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا
عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65)﴾ [الفرقان] فيما
سبق.
وقلنا في الإنكار عليهم: «وزعموا» أنَّ كمال التعظيم لله ينافيه
أن تكون العبادة معها خوفٌ من عِقابه، أو طمَعٌ في ثوابه، «وأخطأوا فيما زعموا».
وذكرنا إِثرَ ذلك بعض الأدلة التي اعتمدنا عليها. وبعد أن مضى على ذلك
ثلاثة أشهرٍ كاملة؛ نشر الشيخ المولود الحافظي [ت: 1367/1948] مقالًا ردًّا علينا،
دون أن يذكر جميع أدلَّتنا، ودون أن يتعرَّض لنقضها في سندها أو متنها، أو عدم
انطباقها، أو إفادتها لما سبقتُ لإفادته، ودون أن يُعارضها بمثلها في الرتبة
والدلالة. وأطالَ بما بعضه خارجٌ عن محلِّ النزاع، وبعضه هو نفس الدعوى
المحتاجة إلى الاستدلال. فرأينا ـ إثْرَ اطِّلاعنا على مقاله ـ أن نعودَ
لذكر أدلتنا التي اعتمدنا عليها فيما اخترناه: من أن وضع العبادة الشرعية، على
رجاء الثواب وخوف العقاب، وبيان دلالتها على المدَّعَى. ثم نتكلَّمَ على بعض
ما في مقاله، فنقول:
حقيقة العبادة:
إنَّ العبادة هي غاية الذل والخضوع، مع الشعور
بغاية الضَّعف والافتقار. ومن مقتضى الضَّعف أن يَخاف ويَوجل، ومن مقتضى الافتقار أن يَرجو ويَطمع:
1-
فخوف العبد من عقاب ربه، هو من مقتضى اعترافه بضَعفه وقوَّة ربه، وشهوده لعزته
وقهره، وعموم تصرفه في خلقه، وأنه لا معقِّب لحكمه، وأنه لا يُؤمَن من مكروهه.
2- وطمعه في ثوابه، هو من مقتضى اعترافه بحاجته
وفَقره وغنى ربِّه، وفضله، وتصديقه بوعده؛ فهو يعبده ويخاف ألا يَقبَل عبادته،
ويخشى نقمته. ويعبده ويرجو رحمته، وينتظر مثوبته. وفي عبادته هذه إظهارٌ لغاية
العبودية بنقصها وحاجتها، وقيام بحقِّ التعظيم والإجلال للربوبية، والاعتراف لذلك
المقام بالقدرة والعزَّة، والغِنى والرحمة والكمال.
فوُضعتْ العبادة في الدين على خوف العقاب،
ورجاءِ الثواب، لما في ذلك من إظهار غاية عبودية العبد بضَعفه وافتقاره، أمامَ ربِّه
الغنيِّ الرحيم القويِّ المتين.
الأدلة:
والدليل على هذا ستسمعه من الكتاب، والسنة،
وأقوال السلف:
أولًا: أما الكتاب: فقوله تعالى:
1-
﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا
ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ ۩ (15) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ
الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
(16) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)﴾ [السجدة].
ووجه الدليل من الآية: أنَّ هؤلاء المذكورين فيها هم الكُمَّل
من عباد الله الصالحين، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرويِّ في «الصَّحيح»
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يقول
الله تعالى: أعددتُ لعبادي الصَّالحين ما لا عينٌ رأَتْ، ولا أذنٌ سمعتْ، ولا خَطَرَ
على قلب بَشَرٍ، ذُخْرًا، بَلْهَ ما أُطْلِعْتُمْ عليه». ثم قرأ قوله
تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ
قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)﴾ [السجدة]([5]). ومع كمالهم لم تتجرد عبادتهم من الخوف
والطمع.
ووجه آخر: وهو أنَّ الله تعالى ذكر لنا عبادتهم؛ لنعرف
العبادة الشرعية كيف تكون؛ فذكرها مع الخوف والطمع، فعرَفْنا أنَّ العبادة وضعت في
الشرع على ذلك.
ووجه ثالث: وهو أنَّه تعالى ذَكر لنا صفاتهم وعبادتهم؛
لنقتديَ بهم فيها، فعُلم أن العبادة التي يدعونا ربنا إليها هي العبادة خوفًا وطمعًا.
2- ومثل هذه الآية: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191)
رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا
لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا
يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ
لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ
(193) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194) ﴾ [آل عمران].
ووجه الدليل منها كالتي قبلها، وتزيد عليها
ببيانٍ صريحٍ دُعائَهم وطَلَبهم الوقاية من النار، وغفران وتكفير السيئات.
3- ومثلها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ
جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65)﴾ [الفرقان].
ووجه الدليل منها كالتي قبلها.
4- ومثلها قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ
شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا
وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ
مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا
عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10)﴾ [الإنسان].
ووجه الدليل منها مثلَ ما تقدَّم وتزيد ببيان
أنَّ خوف اليوم العبوس لا ينافي الإطعام لوجه الله.
5- ومثلها قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ
كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19) الَّذِينَ
يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20) وَالَّذِينَ
يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (21) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى
الدَّارِ (22)﴾ [الرعد].
ووجه الدليل كما تقدم، وفيها أيضًا بيان أنَّ
خوف سوء الحساب لا ينافي الصبر ابتغاء وجه الله تعالى.
6- ومثلها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57)
وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ
بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ
وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61)﴾ [المؤمنون].\
ووجه الدليل كما تقدم. ومعنى الآية: أنَّهم
يُعطون ما أُعطوا من أعمال البر والطاعات، وقلوبهم خائفة من أنهم راجعون إلى ربهم،
فيخافون ألا تقبل منهم. ففيها بيان أنهم كانوا يعملون راجين قَبول الأعمال، خائفين
من عدم قَبولها.
فهؤلاء هم الكمَّل من عباد الله، وهذه هي
عبادتهم في صريح هذه الآيات الكريمة التي ذكرت فيها صفاتهم، وكلها بكثرتها
وصراحتها دالَّة دلالةً قطعيَّةً لما قلناه: من أنَّ العبادة الشرعية موضوعةٌ
على رجاء الثواب والخوف من العقاب؛ إذ ذلك هو أظهرُ مظاهرِ العبودية بذلها
وخضوعها، وضَعفها وحاجتها وفَقرها، وحالتها المباينة غاية المباينة لمقام
الربوبية، مقام ذي الجلال والإكرام. ولا تجد في القرآن العظيم، آيةً واحدةً
دالَّةً دلالة صريحة على ذكر عبادة ـ هكذا ـ دون خوفٍ أو طمعٍ.
7- ونزيد على الآيات المتقدمة، آية دالَّة على
حال عبادة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي
يَوْمَ الدِّينِ (82)﴾ [الشعراء].
ووجه الدليل في الآية: أن إبراهيم عليه السلام أخبر عن نفسه
بصيغة المضارع، المفيد للتجدُّد، أنَّه يطمعُ من الله أن يغفر له خطيئته؛ فدلَّ
ذلك على أنه كان في عبادته طامعًا. ومعلومٌ أنه معصوم، وأنه مُؤمَّنٌ من العذاب،
وأنَّ ما سماه خطيئةً هو بالنسبة إلى مقامه الرفيع من باب: «حسنات الأبرار سيئات
المقربين»([6]). ومع ذلك كلِّه فالمقصودُ من الدليل حاصلٌ،
وهو أنه خاف المؤاخذة ـ المؤاخذة اللائقة بمقامه ـ وطمِع في الغفران، وكانت عبادته
على الطمع والخوف. ولا يقال: إنه كان معلِّما للناس؛ لأنَّه إخبار عن نفسه، وخبره
صدق ثابت، فلا بدَّ أن يكون كما أخبر.
ثانيًا: وأمَّا من السنة فمنها:
1- دعاء القنوت المشهور: «نرجو
رحمتك، ونخشى عذابك، إنَّ عذابك الجِدَّ»([7]).
ووجه الدليل منه: أنَّ الصلاة أشرفُ أحوال العبد وأجلُّ
مقاماته، وأعظمُ عباداته، وقد عُلِّمَ أن يدعو فيها هذا الدعاء الصريح، في رجاء
الرحمة وخوف العذاب، وما كان ذلك إلا لأنَّ العبادة الشرعية موضوعة عليهما.
2-
ومنها حديث: «وأما السُّجودُ فادعوا فيه فقَمِنٌ([8]) أنْ يستجاب لكم». وهو حديث صحيح([9]). وفي «الصَّحيح» أيضًا: «أقربَ ما يكونُ العبد من ربه وهو ساجدٌ»([10]).
ووجه الدليل: أنَّ أقربَ أحوال العبد من ربِّه السجود، وهو
محلٌّ للدعاء، والداعي يرجو القَبول، ويخاف المنع، فالعبادة في أقرب أحوال العبد
موضوعة على الرجاء والخوف.
3- ومنها الحديث الصحيح: «إذا أتيتَ مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجعْ على شِقِّكَ
الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمتُ وجهي إليك، وفوَّضتُ أمري إليك، وألجأتُ ظهري إليك،
رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنتُ بكتابك الذي أنزلت،
وبنبيك الذي أرسلت. فإن مِتَّ من ليلتك، فأنت
على الفطرة، واجعلْهنَّ آخر ما تتكلم به»([11]).
ووجه الدليل منه: أنه تعليمٌ لما يقوله المسلم فيما قد يكون
آخر حالٍ يلقى عليه ربَّه، ولا ينبغي أن يلقاه إلا على أكمل حال؛ فعلَّمنا هذا
الدعاء الصريح في الرغبة والرهبة ليقوله المؤمن، ولو كان من أكمل الكُمَّل. فدل
على أن الرغبة والرهبة عليهما وضعت العبادة في جميع الأحوال.
4- ومنها الحديث الصحيح: قالت عائشة رضي الله
عنها: «كنتُ نائمةً إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففقدته فلمستُه
بيدي فوضعتُ يديَ على قدميه وهو ساجدٌ يقول: «أعوذ
برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت
على نفسك»([12]).
ووجه الدليل: أنه في الحال التي هو فيها أقرب ما يكون من
ربه، وهي حالة سجوده، استعاذ برضى الله من سخطه، وبعافيته من عقوبته.
ثم لمَّا لم يستطع الاحاطة بأفعاله، ردَّ الأمر
لذاته، فاستعاذ به منه. وهو في الجميع مستعيذٌ، والمستعيذُ طالبٌ، والطالبُ راجٍ
وطامعٌ في نيل المطلوب. فلم يفارق عبادتَه الرجاءُ والطَّمعُ حتى في هذه الحالة
التي بينه وبين ربه، لأنه كان ساجدًا في جَنَحِ الليل، دون حضورِ أحدٍ من الناس،
إلا عائشة التي كانت نائمةً واستيقظت، فاطَّلعتْ عليه في تلك الحال.
5- ومنها الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله
عنه الذي كان يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياه كما يعلِّمهم السورة
من القرآن رواه مالك وفيه: «اللهم أعوذ بك من عذاب
جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة
المحيا والممات»([13]).
ووجه الدليل منه: أنَّه علَّمهم هذه الاستعاذة الصريحة في
الخوف والرجاء كسائر ما علَّمهم من الدعوات المبنيَّة عليهما. وهكذا تجد جميع
دعواته المأثورة على الرغبة والرهبة، والرجاء والخوف. ولا تجد دعاءً واحدًا علَّمهم
فيه أن يتوجهوا إلى الله تعالى، دون رغبةٍ ولا رهبةٍ، ولا رجاء ولا خوف. ولو كانت
العبادة الخالية من الطمعِ والخوف هي أكمل العبادة، لكان بيَّنها لهم بيانًا شافيًا
صريحًا، كعادته في بيان الكمالات، وهو الحريص على دلالتهم على كلِّ خيرٍ. فكيف لا يدلُّهم
على هذا المقام بصريح المقال، لو كان من الكمال، بحيث يدَّعي لها بعض الناس؟؟!
النتيجة:
فقد بان بما ذكرنا توارد آيات الكتاب، وأحاديث
السنَّة في صراحة وجِلاء على مشروعية العبادة، مقرونةً بالرغبة والرهبة، والرجاء
والخوف. ولم نظفر بآيةٍ واحدةٍ، أو حديث واحدٍ، فيه التصريح بمشروعيَّتِها مجرَّدَة
منهما، فضلًا عن أنها أكمل منها معهما. وما كنَّا لنترك أدلة الكتاب والسنة
الصريحة لرأي أحدٍ كائنًا من كان.
6- وإننا نورد فيما يلي حديثًا من «صحيح
البخاري»، يبيِّن لنا كيف كان الصحابة ـ سادةُ هذه الأمة ـ يعبدون الله تعالى،
يرجون قَبول أعمالهم لديه: «قال أبو بردة ابن أبي موسى الأشعريُّ: قال لي عبد الله
بن عمر: هل تدري ما قال أبي لأبيكَ؛ قال قلت: لا. قال: فإنَّ أَبي قال لأبيك: يا
أبا موسى، هل يسرُّك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهجرتنا معه،
وجهادنا وعمَلنا كلَّه معه بَرَدَ لنا، وأن كلَّ عمل عملناه بعده نجونا منه كَفافًا:
رأسًا برأس؟ قال أبي ـ يعني أبا موسى ـ: لا والله؛ قد جاهدنا بعد رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم وصلَّينا، وصُمْنا، وعمِلنا خيرًا كثيرًا، وأسلَم على أيدينا
بشرٌ كثير، وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي ـ يعني عمر ـ: لكنِّي أنا ـ والذي نفسُ عمرَ
بيده ـ لوَدِدتُ أنَّ ذلك بَرَدَ لنا، وأنَّ كلَّ شيء عملناه بعد أن نجونا منه كَفافًا
رأسًا برأس. فقلت ـ أبو بردة ـ: إنَّ أباك والله خيرٌ من أبي»([14]).
ووجه الدليل: عَمَلهم على الرجاء، وخوفهم من عدم القَبول،
والعقاب على المخالفة، وإن اختلفا فيما اختلفا فيه.
ولا نجدُ في كلام واحدٍ منهم، أنه كان يجرِّد
عبادته عن الطمع والخوف، وما كان المقام الأكمل ليفوتهم وهم أفقه الناس في الدين،
وأحرصهم على الخير. هذه هي أدلتنا فيما ذهبنا إليه، ورددنا على مخالفيه.
وهي أكثر من هذا عدًّا في كتاب الله وسنة
رسوله، وفيما ذكرناه كفاية ـ إن شاء الله ـ لمن نصح وأنصف، وأخلص الإيمان بقوله
تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59].
والآن نعطف بالكلام على مقال الشيخ ونحصره في
مواضع:
1- أنكرنا على من زعموا أنَّ مرتبة العبادة
العليا أن يُعبد اللهُ تعالى لذاته، دون الطمع في ثوابه، ولا الخوف من عقابه،
ونسبنا إليهم الخطأ. ولمَّا وجدنا آيات الكتاب وأحاديث السنَّة طافحةً، بأنَّ
عبادة الله مقرونة بالخوف والطمع كما قدَّمنا، نَسبْنَا خطأهم إلى قلَّة التفقه في
الدين، أي في أدلَّة الدين، وهي الآيات والأحاديث المذكورة. وما عسى أن يُقال فيمن
لم تكْفِه تلك الآيات والأحاديث كلها، على صراحتها واتفاقها، إلا أنه لم يتفقَّه
فيها؟ ولمَّا لم نجد آيةً واحدةً ولا حديثًا واحدًا يصرح بمدَّعاهم، حملناهم على
الغلوِّ. هذا كلُّه دون أن نصرِّح بشخصٍ ولا بطائفةٍ؛ لأنَّ الكلام مع القولِ والدَّليل.
فأبى حضرته إلَّا أن يَحمِل كلامنا على طائفةٍ مخصوصةٍ يُحبُّ هو اليوم التَّظاهرَ
بالدفاع عنها، ثم تطرَّق من ذلك إلى رمينا بما يناسبُ غرضَه من الجراءَةِ وقلَّة
النصيحة، والتطاول على الأئمة... إلى ما يريد أن يصفنا به؛ ليقول القارئ: إنَّ حضرته
موصوفٌ بضدِّه. وربك أعلمُ بتلك الأوصاف وأهلِها!!
2- كان استدلالنا بآية: ﴿وعِبادُ الرَّحمنِ﴾،
على الوجه الذين بيَّناه فيما تقدم، دون أن نذكر الحصرَ، ولا أن نشير إليه، ولا من
مقتضى موضوعنا أن نقصُر عباد الرحمن على تلك الصفات. لكن حضرتُه أخذ يقرِّرُ في
قواعد الحصرِ الضرورية عند المبتدئين، وخرَج من ذلك إلى أنَّ الآية لا حصرَ فيها،
وأنَّنا تسرعنا، وما تدبَّرنا، ولم نُحسنْ تطبيق قواعد العلوم على موضوع النزاع!! وفي
الحق: أنَّ حضرَته هو الذي لم يحسن تنزيل ما طوَّل به في الحصر على كلامٍ لم
ندَّعِ فيه الحصرَ، ولم نستدلَّ به، وإنما استدللنا بالآية مثل ما استدللنا بغيرها
على الوجه الذي تقدَّم، وعلى ما معه من الوجوه.
3- ما في كلام الإمام الرازيِّ من أنَّ الله
مستحقٌّ للعبادة لذاته، وأنه لو أمرَ بالعبادة بلا ثوابٍ ولا عقاب لوجبتْ([15]).. فهو حقٌّ مسلَّمٌ، وليس هو موضوع النزاع، إذ
موضوع النزاع: هل العبادة مع الخوف والرجاء أكمل؛ أم العبادة دونهما؟
وما فيه([16]) من أنَّ: «من عبدَ الله للثواب والعقاب؛
فالمعبودُ في الحقيقة هو الثواب والعقاب، والله واسطة»؛ إذا كان يعني به: «أنَّه
عبَدَ الله للثواب من حيثُ ذاته، والعقاب من حيثُ ذاته، دون امتثالٍ للأمر، وتوجُّهٍ
للرب»؛ فهذا ليس كلامنا فيه. وإن كان يعني: «أنه يعبد للثواب والعقاب من
حيث أنَّ العبادة الشرعية موضوعة على رجاء الثواب وخوف العقاب، فهو يعبد الله
امتثالًا لأمره»؛ فكلامه ممنوعٌ؛ لأنَّ العبادة هي التوجه بالطاعة لله امتثالًا
لأمره، وقيامًا بحقه، مع الشعور بالضَّعف والذُّلِّ أمامَ قوَّة وعزِّ الربوبيَّة،
وذلك يبعثُ على الخوف المأمور به، ومع الشعور بالفقر والحاجة أمام غنى وفضل
الربوبية، وذلك على الرجاء المأمور به. فالمعبود في الحقيقة والواقع هو المتوَجَّه
إليه بالطاعة، وهو الله تعالى؛ لا الثواب الذي تعلق به الرجاء، ولا العقاب الذي
تعلق به الخوف. وكيف يكون الثوابُ هو المعبود، والعقاب هو المعبود، والله هو الذي
شرعهما؟! فهل يشرع عبادة غيره؟! وما هذا إلَّا من عدم التأمل في مثل قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى
رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57)﴾
[الإسراء]. أي شأنه أن يُحذَر، ومن حقِّه أن يُحذر. وهل هذا إلَّا من عدم التفقَّه
في قوله تعالى في أمِّ القرآن والسَّبع المثاني التي يناجي بها المصلي ربه، وهو في
أعظم عبادة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ (5)﴾ [الفاتحة]. فإنَّ المستعين طالبٌ للإعانة، والطالبُ راجٍ
قَبول طلبه خائف من عدم قبوله.
وقوله تعالى فيها: ﴿اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)﴾ [الفاتحة]. طلبًا كذلك، فليتفقَّه
المتفقِّهون في كلام رب العالمين.
4- ونقل كلام الإمام الرازي في باب المحبة قوله: «وأما
العارفون، فقد قالوا: يُحبُّ الله تعالى لذاته، وأمَّا حُبُّ خدمته وحبُّ ثوابه
فدرجة نازلة»([17]).
ونحن نقول: إنَّ الذاتَ الأقدس الموصوف بالكمالات،
المفيض للإنعامات تتعلق به قلوب المحبِّين، موصوفًا بكمالاته وإنعاماته التي منها
ثوابه وجزاؤه، وتلك المحبة تبعثُ على خدمته بطاعته، والتقرب إليه بأنواع العبادات.
وأمَّا عبادة الذات مجردًا عن الإنعامات، فهو نوعٌ من التعطيل في الاعتقاد،
والتقصير في الشهود. وإذا كانت المحبة عملًا من أعمال العبد القلبية التي يتقرب
بها إلى الله فهي عبادة. وقد بيَّنَّا بالأدلة المتقدمة أن العبادة في الإسلام
موضوعةٌ على مصاحبة الرجاء والخوف، والمُحِبُّ للربِّ ذي الجلال والإكرام، والبطش
والإنعام لا يغيب عن إجلاله بالخوف والتذلل له بالطمع، كحاله في سائر العبادات.
5- ونقل من كلام النيسابوريِّ قوله: «المحقِّقون
نظرهم على المعبود لا على العبادة، وعلى المنعم لا على النعمة»([18]).
ونردُّ عليه:
- فإن كان مرادُه: «أنَّ نظرهم على المعبود أي
اعتمادهم في القَبول على المعبود لا على العبادة» فهذا حقٌّ، وليس كلامنا فيه.
- وإن كان مراده: «أنَّ نظرهم على المعبود أي
توجههم إلى المعبود دون العبادة»؛ فهذا أيضًا حقٌّ؛ لأن العبادة متوجه بها إليه،
وليس كلامنا في هذا.
- وإن كان مراده: «دون تقرُّبٍ بالعبادة»؛ فهذا
باطلٌ، لأن الله تعالى قال: ﴿وابْتَغُوا إليِهِ الوسِيلَة﴾ أي ما يُقرِّبكم إليه
من طاعته.
- وإن كان مراده: «دون شعورٍ بالعبادة»؛ فهذا أيضًا
باطلٌ؛ لأنَّ العابد ينوي العبادة ويقصِد بها القربة، ويتوجه بها مخلصًا فيقول: ﴿إيَّاكَ
نَعْبُدُ﴾، فكيف يكون لا شعور له بها؟
وأما قوله: «وعلى المنعم لا على النعمة»:
- فإن أراد: «أن المتقرب إليه هو الله المنعم
دون النعمة»؛ فهذا حقٌ، وليس كلامنا فيه.
- وإن أراد: «أن رجاء نعمة الثواب حين التوجُّه
لله، والتقرب إليه بالطاعة ينافي التقرب إلى المنعم، ويعدُّ تقربًا للنعمة»؛ فهذا
هو الذي أبطلناه بالأدلة السابقة، ونقضناه في الموضع الثالث.
- وإن أراد: «أن ذكر العبد لنعم الله عليه مخِلٌّ
بكمال عبادته»؛ فهذا باطلٌ أيضا؛ لأن عبادة الله شكرًا على ما آتى من النعَمِ، وطلَبًا
للمزيدٍ من أرفع المقامات. وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ
إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ (120) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ﴾ [النحل: 120-121]. ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ﴾
[النمل: 19]، ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان:
14]، ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾
[إبراهيم: 7].
6- استدلَّ النيسابوري: «بأنَّه قيل لبني إسرائيل:
﴿اذكروا نعمتي﴾. ولأمة محمد ﴿اذكروني﴾». وهذا منقوض بقوله تعالى: ﴿نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾ [آل عمران: 103]. وقوله: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ﴾ [الأحزاب: 9].
7- نقل من كلام النيسابوري ما يفيد: «أنَّ عبادة
الله لكونه إلهًا، وكون المخلوق عبدًا، لا يكون معها رغبة في الثواب، ولا رهبة من
العقاب، وأنها هي أعلى الرتب». ونحن نقول: من مقتضى شعورك بعبوديتك: شعورك
بضَعفك وفَقرك، وأن من مقتضى علمكَ بالله، شهودك لقوَّته وفضله. وذاك الشعور، وهذا
الشهود، يبعثان فيك الرجاء والخوف؛ فتكون وأنتَ تعبده لأنه إلهٌ، ولأنَّك عبدٌ راجٍ
خائف. ودعوى تجرُّد العبادة عنهما، قد أبطلناها بالأدلة السابقة.
8- نقل قول الإمام ابن العربي: «أمرَ اللهُ
عباده بعبادته، وهي أداء الطاعة بصفة القُربة، وذلك بإخلاص النيَّة؛ بتجريد العمل
عن كلِّ شيء إلا لوجهه، وذلك هو الإخلاص الذي تقدم بيانه»([19]).
ثم زعم هو من عنده: «أنَّ من مقتضى تجريد العمل عن كل شيء:
تجريده من رجاء الثوابِ، وخوف العقابِ. وأنَّ الإخلاص هو ما كان لوجه الله لكونه
إلهًا لا غير». وهذا صريحٌ منه في أن رجاء الثواب وخوف العقاب ينافيان
الإخلاص، وهو باطل لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ
لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9)﴾
[الإنسان]. فخافوا وعملهم لوجه الله بنص القرآن.
وروى الأئمة في «الصحيح»: أنَّ أبا طلحةَ قال:
يا رسول الله، إني أسمع الله تعالى يقول: ﴿لَنْ
تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران:
92]. وإن أحبَّ أموالي إليَّ بَيْرَحاءُ، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند
الله، فضعها حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بخٍ([20])، ذلك مالٌ رابحٌ! ذلك مالٌ رابحٌ»([21]). فأقرَّه على قوله: «أرجو برَّها وذخرها». ولم
يقل له: «إن هذا منافٍ للإخلاص»، كما يقول الشيخ وهو «يسمبط ويشنبط»([22]) في كلام الإمام ابن العربي.
ثم ما لك ـ يا أخي ـ ولابن العربي؟! حسبُك ابن
سينا وأمثاله، الذين يحاولون تطبيق العبادة الإسلامية على الفلسفة اليونانية،
والآراء الأفلاطونية. أما ابن العربي فهو حكيمٌ إسلاميٌّ، وفقيه قرآني، وعالم سنيٌّ
ـ حقيقيٌّ ـ لا يبني أنظاره إلا على أصول الإسلام، ودلائل الكتاب والسنة. وهاك
كلامَه في إرادة المأذون فيه ـ مع العبادة ـ من أمور الدنيا، بله الرجاء والخوف. واسمع
كلامه الصريح من الدليل الصحيح، في الردِّ على مثل زعمك: قال على قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا
مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: 198]: «المسألة الثانية، قال علماؤنا: في هذا
دليلٌ على جواز التجارة في الحجِّ مع أداء العبادة، وأنَّ القصد إلى ذلك لا يكون
شركًا، ولا يخرج به المكلَّف عن رسم الإخلاص المفترض عليه، خلافًا للفقراء في أنَّ
الحج دون تجارةٍ أفضل أجرًا»([23]).
وقال على قوله تعالى: ﴿وَإِنْ
كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ [الأحزاب:
29]: «وهذا يدلُّ على أنَّ العبدَ يعملَ محبة في الله ورسوله لذاتيهما، وفي الدار
الآخرة لما فيها من منفعة الثواب»([24]).
9- ونقل كلامًا للإمام الغزالي في المحبة، وقدَّمنا
في الموضع الثامن الكلام على مثله، وبينَّا أن المحبَّة عبادة، وأنها موضوعة كسائر
العبادات الشرعية على الرجاء والخوف بالأدلة المتقدمة.
10- وقال: وكان من دعائه صلى الله عليه وآله
وسلم: «اللهم اجعل حبَّكَ أحبَّ الأشياء إليَّ، واجعل
خشيتك أخوفَ الأشياء عندي، واقطع عنِّي حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك»([25]). وقد تقرَّر: أنَّ خوفَه خوفُ إجلال وتعظيم، لا
خوف النار والعقاب» اهـ. ونقول: إن خوف الإجلال لا يخرج به العبد عن ضَعفِ
وذُلِّ العبودية، ومشاهدةِ قوَّة وفضل الربوبية، فلا يتجرَّد خوفه الإجلاليُّ عن
خوف المؤاخذة ـ المؤاخذة التي ليست نارًا ولا عذابًا ـ، ولكنها مؤاخذة مناسبة لذلك
المقام العالي، بدليل أن إبراهيم عليه
الصلاة والسلام، وهو مثل نبينا عليه الصلاة السلام في العصمة، وعدم التعذيب بالنار
والعقاب، وقد خاف المؤاخذة فقال: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ
أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82)﴾ [الشعراء]، ولا
خطيئةَ له، ولجميع الأنبياء والمرسلين، لا من الكبائر ولا من الصغائر على كلِّ
حال. وبدليل أنه هو عليه الصلاة والسلام قال: «والله
إنِّي لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». رواه البخاري([26]). وليس هذا لذنبٍ لا صغيرٍ ولا كبير، وإنَّما
لعلمه بالله، وعظيم حقِّه، وشدة تعظيمه لربه؛ فيخاف المؤاخذة، فيطلب المغفرة. فبان
بهذا أنَّ خوف الإجلال لا يتجرَّد عن خوف المؤاخذة.
وبعد هذا البيان، نقول لحضرته: لا تستدلَّ بالحديث دون بيان رتبته،
ولا ذكرٍ لمخرجِه، وما هكذا يكون استدلال الأُمناء من العلماء، وأنه برمي الأحاديث
هكذا مُهمَلَةً اختلط الحق بالباطل، وتجرأ على السنة النبوية الغبي والجاهل، حتى
بلغ الأمر إلى نسبة الأحاديث إلى كتب الإسلام المتَّفق عليها ولا وجود لها فيها! أما
نحن: فلا نعرف هذا الدعاء في الصحاح المتداولة عندنا، فليتكَ تبيِّن من أين
جئتَ به؛ حتى نعرف مقدار ما تعتمد في احتجاجك عليه.
11- وقال: «للأنبياء عليهم الصلاة والسلام
حالتان: حالة مع الله تعالى لا يرون فيها غير جلاله وعظمته. وحالة مع الخلق؛
يستغفرون ويستعيذون من النار وسوء المنقلب، وفتنة القبر والدجال، ويطلبون الرحمة
والثواب والجنان». اهـ.
قد بيَّنَّا أن رؤية جلال الله مما يبعث على
الخوف من المؤاخذة، كما مضى عن ابراهيمَ ومحمَّدٍ عليهما الصلاة والسلام، فلا يتجرَّدون
عن الخوف ـ خوف الإجلال وخوف المؤاخذة ـ في حالتهم مع الله. وقد دلَّ حديث عائشة
الذي قدمناه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سجوده في جوف الليل ـ والناس
نيامٌ فيما بينه وبين ربه ـ استعاذ برضا الله من سخطه، وبمعافاته من عقابه. فكانوا
يستعيذون ويرجون ويخافون في حالتهم مع الله. وأما حالتهم مع الناس فإنهم كانوا يعلِّمون،
وكانوا يخبرون عن أنفسهم بخوفهم وطمعهم. كما أخبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بطَمَعِه،
وأخبر محمدٌّ عليه الصلاة والسلام أصحابَه بأنَّه أتقاهم لله، وأخوفهم له، وأخبر
عن استغفاره لربه، وإخبارهم حق صدق لا شك فيه.
ولا يجوز أن يقال: «إنهم قالوه لمجرد التعليم»،
وهو في الواقع لا حقيقة له؛ إذ الإخبار عن النفس بشيء أنه كان وهو لم يكن هو الكذب
الذي عصَمَهم الله منه، ونزَّهَهَم عنه، ولو تفطن حضرته لهذا لما قال ما قال!!
12- وذكر حديث الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»([27]).
وهذا الحديث يقتضي دوام المراقبة لله عند كل
حركة وسكون، حتى لا تكونَ من العبد مخالفةٌ فيهما، وحتى يأتي بعبادته على غاية
الإتقان في صورتها وأتمِّ الإخلاص بها. وقد علمتَ أن مقتضى العبادة الشرعية الشعور
بضَعفِ وذلِّ وفقرِ العبودية أمامَ عزِّ وقوةِّ وفضلِ الربوبية؛ فينبعثُ الرجاء
والخوف في العابد، وهما مما يحملانه على تمام الإحسان في العبادة: بإتقانها
والإخلاص فيها. ثم من مقتضى مراقبة الله تعالى، مشاهدته: أي مشاهدة جلاله وجماله؛
جلاله بصفات القهر والبطش والمُلك والسلطان، وجماله بصفات الفضل والرحمة والإحسان؛
وبصدق المشاهدة لصفات الجلال يخاف العبد ويخشى؛ وبصدق المشاهدة لصفات الجمال يرجو
ويطمع. فصدق الشهود لا بد معه من الرجاء والخوف. وإذا غاب العبد عن الشعور
بالموجودات، فإنه لا يغيب عن مشاهدة جلال وجمال الذات، الباعثين للخوف والرجاء.
وإذا لم يشهدْهما وزعم أنه يشهد الذات مجردًا.. فإنه لم يكن في الحقيقة مشاهدًا،
بل كان غافلًا معطلًّا جامدًّا. وأما غيبوبة العابد عن نفسه ـ إن كانت ـ فإنها
حالة عارضة غير ثابتة، وليست مشروعة لا بنصٍّ من آية ولا من حديث، فضلًا عن أن
تكون فاضلة كاملة. فالحديث دلَّ على المراقبة والمشاهدة الشرعيتين، اللتين يكون
العبد عابدًا العبادة الشرعية، الموضوعة على الرجاء والخوف حسب الأدلة المتقدمة.
13-
ونقل كلام ابن سينا في كتاب الإشارات وكلام شراحه([28])، وهو مثل ما تقدم لنا إبطاله بأدلة الكتاب
والسنة، والشرح بهما لمعنى العبادة المشروعة.
وإذا كنا نبحث عن العبادة التي شرعها الله
لعباده على لسان رسوله؛ فإننا لا نعرفها إلا من الكتاب والسنة، وقد قدمنا من
أدلتها ما جلَّى المسألة للعيان، وأغنى فيها عن كل كلام.
الخلاصة:
1-
إن العبادة المشروعة هي القصد إلى الطاعة، مع الشعور بضعف العبد وذله، وحاجته
وفقره، ومشاهدته لجلال ربه وقدرته وعزته، وجماله وفضله ورحمته؛ فيكون بتلك
المشاهدة خائفًا من عقابه أو مؤاخذته راجيًا لثوابه وانعامه.
2-
وإن هذه العبادة هي عبادة الكُمَّل من عباد الله الذين وصفهم بأفضل صفاتهم في
كتابه، وهي عبادة أنبيائه ورسله، الذين ذكر عبادتهم القرآن، وهي عبادة محمد صلى
الله عليه وآله وسلم التي دلَّت عليها صحاح الأثار، وعبادة أصحابه الثابتة في النقول.
3-
وخلصنا من هذا إلى أنَّ العبادة المجردة من الخوف والرجاء منافيةٌ لصدق مشاهدة
الجلال والجمال، مخالفةٌ لعبادة الأنبياء والمرسلين، وعباد الله الصالحين. وأنَّه
لم يرد فيها نصٌّ صريح من كتاب أو سنة، مثل واحد من الأدلة المتقدمة المتكاثرة. وأنها
ما دامت كذلك ليس لنا أن نعدّها مشروعة، فضلًا عن أن نعدها كاملة، فضلًا عن أن
ندعي أنها أكمل؛ لأن مشروعية الشيء لا تثبت إلا بدليل صحيح صريح. وأنَّى لنا ذلك
في العبادة المجردة عن الرجاء والخوف؟! والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والحمد
لله رب العالمين. غرة رمضان 1351هـ.
([1]) أي مقالة القائلين بأن كمال التعظيم لله ينافيه أن تكون العبادة
معها خوف من عقابه أو طمع في ثوابه.
([16]) أي في كلام الرازي السابق. [وهو في تفسير سورة البيِّنة، الآية
(5): قال الرازي: «المسألة الرابعة: اللام في قوله: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا
لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ تدل على مذهب أهل السنة حيث قالوا: العبادة ما وجبت
لكونها مفضية إلى ثواب الجنة، أو إلى البعد عن عقاب النار، بل لأجل أنك عبد وهو ربٌّ،
فلو لم يحصل في الدين ثواب ولا عقاب أَلبتَّة، ثم أمرك بالعبادة وجبتْ لمحض
العبودية، وفيها ـ أيضًا ـ إشارة إلى أنه من عبد الله للثواب والعقاب فالمعبود في
الحقيقة هو الثواب والعقاب، والحق واسطة. ونعم ما قيل: من آثر العرفان للعرفان
فقد قال بالثاني، ومن آثر العرفان لا للعرفان بل للمعروف، فقد خاض لجة الوصول».
نقول:
ولا يخفى أن الرازيَّ أشعريٌّ جلدٌ، ينكر الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، ويقول
بنظرية الكسب الأشعري التي حقيقتها الجَبْر. فمثله لا يؤخذ بقوله، خاصة وأنه مخالف
للنصوص مخالفة صريحة. (المركز)]
([22]) يسمبط ويشنبط: عبارة عامة تجري على الألسنة في المغرب كلِّه،
ومعناها القول الذي لا ضابط له ولا أصل، وإنما يلقيه صاحبه جزافًا وخبط عشواء
وينقل بلا وعي ولا دراية.
([25]) أخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء» 8/282. وهو حديث ضعيف، وأرده
الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (2903). (المركز)
([28]) قال ابن سينا: «العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره، ولا يؤثر
شيئًا على عرفانه، وتعبده له فقط ولأنه مستحق للعباد ولأنها نسبة شريفة إليه لا
لرغبة أو رهبة. وإن كانتا فيكون المرغوب فيه أو المرهوب عنه هو الداعي وفيه
المطلوب، ويكون الحق ليس الغاية، بل الواسطة إلى شيء غيره هو الغاية وهو المطلوب
دونه». «الإشارات والتنبيهات» مع شرح نصير الدين الطوسي، تحقيق: سليمان دنيا، دار
المعارف بمصر، الطبعة الثانية، 4/ 68 – 73.